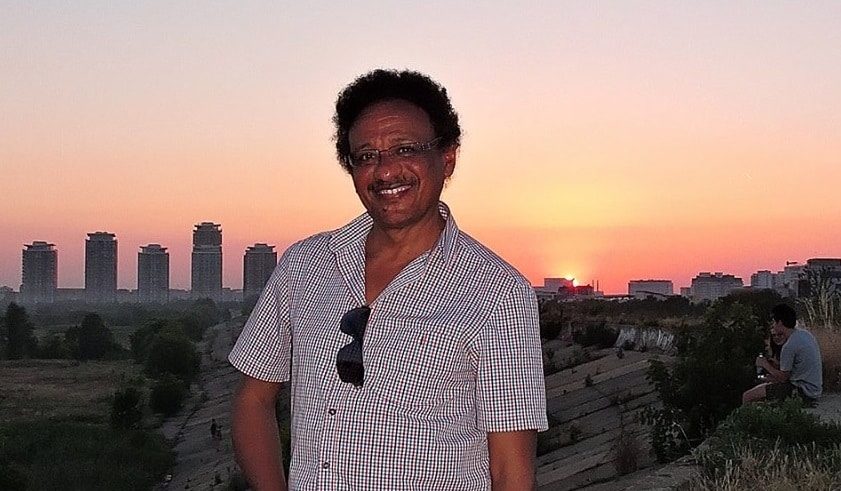
الحقيقة في كفتي ميزان معرفة الوحي وعلم التجريب
في البداية أوحي الإله، الخالق – الوهاب، النصوص العبرية مباشرة إلى نبييه يحيی ومن بعده موسى. أما نبيه عيسی بن مريم، الإبن للرب في عقيدة ‘ثالوث الروح المقدسة’، فقد إستقي معرفة كتاب المسيح من كتاب التوراة اليهودي الذي سبقه في التنزيل. وبما أن يسوع يعتبر إبناً لله فهو بذاته جزءًا أصيلاً من طبيعة الخلق و جوهر الحقيقة نفسها. أما في الإسلام فقد أوحي المَلَك جبريل لرسول الله، محمد، النبي المختار، خاتما الرسل والإنبياء، كتاب القرآن؛ كلمة بكلمة وحرفًا تلو الآخر، ليجيءُ وحي العلم في القرآن جلياُ؛ لا تشوبه شائبة؛ رسالة للبشرية أخيرة وخاتِمَةً لغاية الحقيقة والمعرفة.
هكذا تَجلَّت معرفة العقيدة والدين في توحيد معرفي لصيق بجوهر وصفات إله الكون والناس؛ المستوي على عرش ملكوت السموات والأرض. بهذا تكون المعرفة المستمدة من الدين ثابته في تقريرها للحقيقة وتتطلب الإيمان والتسليم بوجودها المُسْبق قبل أن تستقر في كامن الوجدان وتصبح يقيناً قائماً – مستديماً. لكنها، أيضاً، توجد في إطار زمان متناهي يأتي من عالم في الغيب درك سحيق؛ يكتنفه الإبهام والغموض وفيه تتفاوت معرفة الإنسان بتفاوت قيمة معرفته ووَرَعِهِ وإيمانه. فالحريُّ أن الكتاب أزلي مقدس يحتوي كل حقائق الوجود بين دفتيه ولكنها متسترة من خلف حُجُب معاني ودلالات نصوصه السامية – المتناهية، لذلك يوحي بها الإله لرُسُلِه وأنبياءه وينيبهم عنه في الإفشاء بسرها لمخلوقاته أجمعين وما على عباده غير التصديق والتسليم بالإيمان.
أما معرفة العلم، فهي كذلك موجودة، لكن بين تلافيف الزمن العابر والواقع الآني الذي فيه تتخفى خلف عِلَّة الأحداث وظواهر الأشياء فيستوجب علينا، نحن، أصحاب العقول التي تميز، أن نفكر ونجتهد لإكتشاف مكان أصلها وطبيعة سننها وأثر فعلها. غير أن معرفة العلم، في كل الظروف والأحوال، تبدأ بتساؤل فرضية يلفها ضباب الشك الكثيف وتحوم حولها حائرات تساؤل عدم اليقين، لأنها لا تقف عند حدود معرفة المعتقدات والأديان، بل قد تتخطاها من غير إشارة أو جواز سفر وتخطو من فوق عتب المحرم والمحظور. لذلك، فهي في جوهرها معرفة غير نسبية، قابلة للتعديل والتحوير، لكن في إطار قيم وأخلاق وحاجات مجتمعها المحدود الذي تولد فيه وتكبر وتشيخ. بيد أنه بمجرد التحقق من معرفة العلم بتجربة الحواس وقياسها بمعيار معرفة المفاهيم تصْبحُ شكَّاً مَعرَفياً- قًلِقاً ينادي العقل بالمزيد من التساؤل والشك ويحثه على إعادة البحث والتجريب؛ فلا راحة إذاً، ولاسكون، لعقل صاحي لا ينوم. بهكذا فهم، يمكن تَصَوُّر، ليس فقط وجود الحقيقة الموضوعية ونقيضها في آن واحد، ولكن أيضا مفارقتها الصريحة لمعرفة حقيقة العقيدة ذات اليقين الثابت والمُتَناهي.
علي النقيض من معرفة العلم بمفهوم البحث التجريب والتي تقوم علي بنية الموضوع الملاحظ، المستقل عن العقل، والذي يمكن التحقق من وجوده بإكتشاف طبيعة علاقة عناصره الداخلية، تكون المعرفة المستمدة من الأديان ذات مفهوم بنيوي – غيبي، غير ذات موضوع ملموس؛ يتفاوت على حسب لغة وثقافة التعبير عنه ودرجات إيمان حامله. لذلك، فهي توجد، فقط، في عقل الشخص المُتَصَّور لها وبالتالي يكون من الصعب ملاحظة وقياس العلاقات البينية لعناصرها الأولية في واقع الحال، إن لم يكن من ثابت المحال. بمعنى أن التَصوُّرَ في العقل الذي لايستند على مؤثرات حسية لايخلق واقعاً فعلي، كما في معرفة الغيب والماورائيات؛ فهو في الأصل مجرد وسيلة لإكتشافه وفهم النظم والقوانين التي تقوم بإنتاج المعرفة فيه ومن ثم تحويرها وتطوعيها لمصلحة الإنسان وسعادته. في هذا السياق المتعلق معرفة “العالم” الذي يكابد العيش فيه الإنسان، تَتبَدَّى أهمية فهم الترابط المتبادل بين الواقع وعملية الوعي التي تعتمد، في المقام الأول، على بديهيات معرفة الحواس – الأُسْ المشترك لكل أنواع المعرفة من مفاهيم و منطق وعلم مجرب.
في بدايات الطريق للتنظير والتأسيس لمعرفة العلم والتجريب، جادل توماس كوهين، الفيزيائي الأمريكي، بأن العناصر الذاتية- الإنطباعية في بنيية المجتمع تنعكس على مجموعات القائمين بأمر البحوث العلمية، المتوافقة الأراء، حيث يتم قبول الجديد في في صيغة تتناسب مع السائد من للثقافة المعينة وليس من خلال منهج علمي صارم قائم على الأدلة والملاحظات الموضوعية. لذلك، رأى كوهين، ضرورة أحتواء عملية التغيير الاجتماعي، التي تخرج على المألوف، على طبيعة ثورية تأخذ حيزها خارج أطر التفكير الجمعي السائد وتوقعات النظم ومناهج البحث المتفق عليها. (Kuhn، 1962).
هكذا كانت الحال فيما يخص المعرفة عن طريق البحث العلمي ولاتزال في بعض أوجهه، خصوصاً في مجال العلوم الإجتماعية ذات المواضيع المتشعبة والمتشابكة والتي يصعب فيها أخذ عينات تمثل الواقع ولاتخل بمبدأ التعميم والإستقراء. بسبب هذه العيوب في طرق الوصول للحقيقة العلمية، تمت إعادة تصميم طرق الدراسة والبحث لتفادي عملية التحيز والتنميط عند أخذ عينات الظاهرة الملاحظة وفي قراءة الإستنتاج النهائي. على سبيل المثال، لا الحصر، فرضية العدم والتجارب السريرية في العلوم الطبية جعلت معرفة العلم أكثر موضوعية وقدرة في الوصول لمكان أقرب من حقيقة الظاهرة الملاحظة
قبل فترة وجيزة من مماته، في عام 1543، قفز نيكولاس كوبرنيكس، أحد علماء الرياضيات والفلك في عصر النهضة، خارج عربة السيرك التي ما فتئت تسير بوقود لاهوت الكنيسة التقليدية ليلتقط قرص الشمس ويضعه في مركز الكون البديع غير عابيء بمن بَقِي، من الأخرين، المسافرين، السادرين، في رِكابِ سائد المعرفة وراتبها. فعلى الرغم من أن مساهمة كوبرنيكس، حين ذاك، كانت محدودة في تصورها للكون العريض، إلا أنها، وبدون شك، كان لها الأثر الأكبر في كسر طوق رهبة معرفة الغيب والتسليم بقوالب المعرفة الجاهزة؛ الشيء شجع الكثيرين من معاصريه بالجهر بآرإهم وحدى ب – غاليليو غاليلي ليفارق، هو أيضاً، المألوف ويقف وحده، في عزلة معرفته، أمام محاكم التفتيش الرومانية مدافعا عن تبنيه رأي كوبرنيكس؛ غير مكترياً بإتهام الهرطقة وحكم الإعدام الصادر بحقه.
بيد أن الحلول التي تقول بإعادة تفسير النص الديني في إطار زمنه المعاصر تواجه مغالطة معرفية لأن شروط المعرفة الجديدة لايعاد بعثها دهاليز ظلال الماضي، لكنها تتخلق في رحم الواقع الجديد وبشروط الزمن الذي فيه عندما يشرق الصباح يكون كل شيء قد تبدلَّ وتغير من دون قهقرة. نقول هذا وفي ذاكرة عقل أيدلوجا الدين يعلق غبار تجربة المعتزلة الذين حاولو تبرير سيادة العقل وتحرير تفسير النص من قيود شروط أهلية معرفة الوحي لإببتكار الحيلة المنطقية التي تقول بفصل صفة الكلام من ذات الإله الخالدة ولكن، وبعد جهد مقدر في التفكير والتحليل، بقي كلام القرآن مقدسا، أزليا -محفوظاً في اللوح القدم لايمسه أيَّة تحوير أو تعديل.
هناك أيضا التحدي الذي يفرضه نوع المعرفة الجديدة التي تتخلق في إكسير ثقافة التنوع والإختلاف التي لا تحط في طبقة من طبقات الأثير، النسيم العليل، حتى تهمُّ برحيل داني ووشيك. فمعرفة “العالم” الإفتراضي لاتعترف بشعوبية العقائد والأديان ولاتصدها حدود العرق والثقافات؛ فلاطائل إذاً من التمييز بين يمين الكتاب وقَصِي يساره لأنه في أصل طبعه رقماٌ بسيطاٌ – رقيق مجرد من عامل المكان والزمان. في كل هذا، بين هذا وذاك، تكون المعرفة في طبعها ديمقراطية، طليقة حرة، كما الطيور المسافرة بلا جواز سفر وكما الإنسان الذي يولد حرا وكذلك ضميره الصاحي وعقله الواعي. هذه هي عين المعرفة التي في صيرورة وجدوها الحر تُعرِّفَ هَويَّتة الإنسان و تُشذِّب أحكام فعله وأخلاقه. أما العقل، فسيظل بين إختيار أن يكون حرا طليقاً، في كل حالات إفادته للحقيقة، أو أسيراً – ذليلاً لأدوات الحفظ والتكرار الرتيب. فطريق المعرفة مُجرَّب وواضح وبالعقل وحده يحيا الإنسان وبه أيضا يعيش حراً، عزيز النفس – كريمها.
لن نملها إذاً، وأن كانت وقفة من التفكير طويلة، ومن الصبرأيضا، علي مشارف أفق عالم تذوب فيه حدود الجغرافيا وتتواري فيه أحادية الفكر خلف ظلال تشابك وتعدد الأشياء وتنوعها؛ من قبل أن نهتف عالياً ونقول: أننا أردنا لطلابنا منهج معرفة يساهم في تطوير عقل نقدي جرئ، متحرر، قادر على فحص وتقييم ما يتلقاه من معرفة بعقل مفتوح ونقد تحيزات عين أحكام معرفته، من قبل أن يطلق الأحكام علي صحة معرفة وإعتقاد الأخرين. نريدها معرفة تساهم في خلق هوية متميزة، تفكر خارج إطار السائد والمألوف وتتسامي علي فوارق المعرفة والثقافة برؤى واضحة، متفهمة ومتسامحة. أن تكون معرفة تحاول إيجاد أجوبة تستوعب حاضرنا الذي من بين ضلوعه خرجت هوية الثقافة، حبيسة المكان والزمان، من قُمقُمها العتيق لتمتطي صفحة الأثير وتقضي أصيل يومها في مكان أخر،غير ذات المكان، وبصحبة زمان آخر، إفتراضي، ساحر وأخَّاذ – يوجد خارج تقاليد الراتب والمألوف.
“على مر القرون كان هناك أناس إتخذوا الخطوات الأولى في طريق المجهول. لايملكون من زاده غير رؤاهم الخاصة. اختلفت دوافع تَنكُبِهم المشاق، لكنهم إتفقوا في جهلهم بطريق لم يسلكه أحدا من قبل. الرؤيا جديدة وجريئة، لم تخطر علي بال أحد من قبل، ولكن من لا يعتب الخطوة الأولي لن يصل لمعرفة نهاية الطريق. المبدعون، المفكرون ، الفنانون، العلماء، المخترعون- كلهم وقفوا في بدايات الطريق وحدهم وفي مقابل كل أناس عصرهم. فكل فكرة جديدة ومختلفة كانت مرفوضة ومنبوذة. المصباح الكهربائي، التفاعل الكيمائي، المحرك، القاطرة، الطائرة، كلها اعتبرت افكار حمقاء ومستحيلة التحقيق. المغزل الألي أُعْتبِر حلقة مفرغة من التفكير والتدبير. أما التخدير في علم الجراحة فقد كان خطيئة في الدين لنكرانه ضرورة الألم. ولكن، علي الرغم من كل ذلك، تقدم الصفوف الأشخاص المسلحون بالمعرفة والأفكار؛ حاربوا؛ صالوا وجالو؛ عانوا ودفعوا باهظ الثمن، لكنهم إنتصرو، في نهاية الطريق، لصواب حدسهم وجديد فكرهم.” آين راند في مقدمة روايتها “المَنَارةُ، (Rand، 1943)”.
د. عثمان عابدين عثمان



