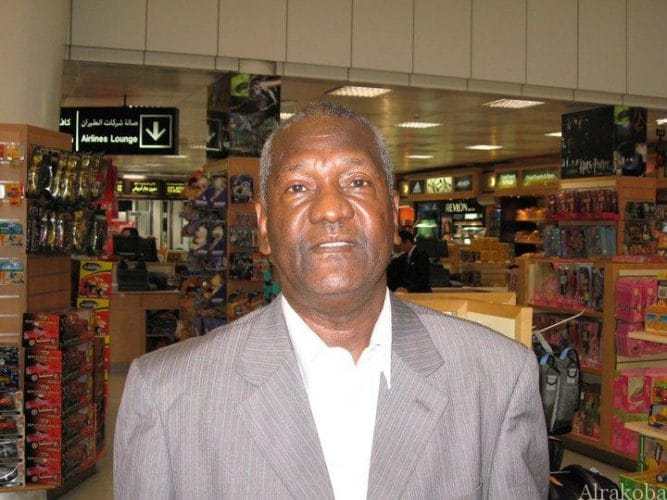أولاً، ليكن معلوماً قبل البدء، أن “الثورة” الحقيقية التي تليق بها هذه الصفة، أو ينطبق عليها معنى هذه الصفة، تكاد تكون غائبة أو مغيبة في الوعي الثقافي والسياسي، ليس عندنا في السودان فقط، ولكن في عموم دول وشعوب ومجتمعات دول العالم النامي، أو الثالث – سمها ما شئت –. إذ أنها لا تتجاوز في هذا الوعي كونها فعلاً اجتماعياً جماهيريَّاً سياسياً، يهدف إلى تنفيذ عملية تغيير للسلطة السياسية الحاكمة في البلد المعين، حتى ولو شارك في فعل التغيير جناح من أجنحة السلطة القائمة، كالمعارضة السياسية الرسمية والمعترف بها من النظام، بل حتى ولو قام بها جيش النظام نفسه منفرداً، ومتمرداً على دستور النظام الذي من المفترض أن يكون هو حارسه!.
في حين أن الثورة هي فعل/ انقلاب جذري على مجمل الأوضاع التي يتأسس عليها النظام الثقافي/ الاجتماعي/ السياسي, والأساطير التي عليها يتأسس.
ويقوم بالثورة الناس/ الجماهير المحكومة بهذا النظام اللاعقلاني.
فالأمر العقلاني الوحيد هو أن تحكم الأغلبية، وأن تسنّ هي القوانين التي تحول دون سيطرة الأقلية عليها.
والمبادئ/ القيم التي يستند عليها الحكم، والقوانين الضابطة له، هي: حرية الفرد، والعدالة الاجتماعية.
وبالتالي فإن أي حركة يقوم بها الجيش والقوى الأمنية الأخرى، لا يمكن أن تطلق عليها صفة الثورة بأي حال من الأحوال، وإنما هي تمرد جناح من أجنحة السلطة القائمة، وفي إطار الصراع على السلطة والنفوذ بين أجنحة النظام نفسه.
فطبيعة المؤسسات العسكرية والأمنية كأداة قمع مسلحة وحارسة للنظام القائم، ولدستوره وقوانينه ومؤسساته تحول بينها وبين “الثورة” عليه. وإلا فقدت شرعية وجودها من الأصل.
وبالتالي إذا ما حاولت هذه المؤسسة أن تكون جزءاً من الثورة، أو شريكة فيها، فإنها ستكون بمثابة “حصان طروادة النظام” المراد اقتلاعه.
وهي، في مرحلة ما بعد الثورة، إذا ما شاركت في النظام الجديد، فإنها ستكون بمثابة الفيروس الذي يتسلل، مخادعاً جهاز المناعة في جسد الثورة، ليضرب من الداخل، حتى لو خلصت النوايا الوطنية وصدق العزم.
فالجيوش والأجهزة الأمنية مولودة من رحم النظام القائم، وهي تستمد شرعية احتكارها للسلاح والقتل بدستور وقانون النظام القائم.(1). وتتحدد وظيفتها ومهمتها في حراسة النظام وقوانينه.
فإذا كان النظام ذا طابع ديمقراطي صارت حارسة للنظام ومؤسساته الدستورية، وإذا كان النظام فاشياً – مثل النظام الاسلاموي المدحور – صارت هي حارسته.
وفي حال ارتفع منسوب الانتماء والانحياز للشعب والوطن لدى أفراد من قياداتها وأفرادها، على انتمائها وولاءها للنظام القائم، فإنهم وبحكم التربية العسكرية القاسية، والقائمة على الانضباط والضبط والربط، وقوانينها الصارمة القائمة على إطاعة الأوامر والامتثال للتنفيذ دون مناقشة (2)، تتناقض بشكل مطلق مع أهداف الثورة، والحياة المدنية القائمة على تأكيد حرية الانسان/ الفرد.
ليس حرية الفرد في خياراته الفكرية والعقائدية فحسب، بل وحتى حقه في التعبير عن رأيه في الشأن العام.
بل أكثر من ذلك: ففي المجتمع المعافى يُعتبر تعبير الفرد فيه عن رأيه في الشأن العام “واجب” أخلاقي ووطني، وليس مجرد “حق”.
وبالتالي فإن التوافق والتطابق والانسجام في جسم السلطة الثورية الجديدة بين المكون العسكري/ الأمني، والمكون المدني/ الثوري هو من الاستحالة بمكان. لاختلاف العقليتين وتناقضهما.
فانحياز الأول/ الأمني، للواقع ..
بينما انحياز الثاني/ الثائر، للمكن وللحلم.
الأول هاجسه الاستقرار .. والثاني دافعه التغيير.
ومفردات مثل الحلم وحرية الفرد والتغيير الجذري، في العقل العسكري/ الأمني تعني مباشرة الانفلات والفوضى (وهو جِنه وجِن الفوضى).(3).
يقف العقل العسكري/ الأمني متحجراً أمام حائط “الواجب” ولا يستطيع تجاوزه.
وبالتالي فإن أقصى ما يمكن أن يصل إليه هذا العقل من مفهوم “الثورة”، هو “واجبه” في توفير الحد الأدنى من متطلبات مفهوم “العدالة الاجتماعية”.
والحد الأدنى من هذا المفهوم الواسع والكبير، ينحصر عنده في تأمين المساكن والمستشفيات والمدارس والطرق، أي العمران بشكل عام.
وهذا الحد الأدنى من مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يقتصر على التعمير نجح فيه بامتياز الحكم العسكري الأول بقيادة الفريق إبراهيم عبود (1958 – 1964). حيث استطاع، وخلال ستة سنوات، أن ينفذ من المشاريع التنموية في شتى المجالات ما عجزت عن تحقيقه حكومات انقلابين عسكريين تسلطا على حكم السودان لفترة امتدت لـ 46 عاماً (1969 – 1985) و (1989 – 2019). ورغم هذا لم تشفع هذه الحركة العمرانية غير المسبوقة – والتي كانت بحق نقلة نوعية في التعمير – في أن يثور الشعب ضد حكم الفريق عبود ويطيح به في أكتوبر 1964.
لقد قام بـ”واجبه” كـ”عسكري” في “الموقع السياسي” على أكمل وجه.
لم يكن الفريق عبود فاسداً أو مفسداً، لا مالياً ولا إدارياً، بل لم يستفد من منصبه مغنماً خاصاً ، لا هو ولا أحد من عائلته أو أقاربه. بل كان الرجل زاهداً، طاهر اليد، نزيهاً، خرج من الحكم – مثلما دخل – وهو لا يملك حتى منزلاً خاصاً في المدن والاحياء التي شيدها.
ورغم ذلك ثار الشعب عليه وأسقط نظامه لأنه أسقط مبدأ الحرية في معادلة الحكم.
والحرية هي الكفة الأخرى، المقابلة لمبدأ العدل الاجتماعي في ميزان الاستقرار السياسي المستدام. (4)
والعسكري/ الأمني لكي يقوم بـ”الواجب” على الوجه الصحيح والأمثل، يجب عليه أن يغلق باب “الاختلاف”.
ففي العسكرية لا مجال لهرطقات مثل “حرية الارادة” أو “الرأي الآخر”.
هناك “أوامر” وتنفيذ” للأوامر .. و (بس).(5).
وهكذا.
كي ينفذ عبود برنامجه العمراني لصالح الشعب، قام بمصادرة الحريات، منع الأحزاب والنقابات وكل مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وصادر حق التعبير عن كل صوت يغرد خارج سطور نوتته الموسيقية، حتى ينجز مهمته الوطنية على الوجه الكامل دون إزعاج أو “شوشرة”.
ولأنه يؤمن بأن “الوحدة الوطنية” لمجتمع متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات مثل السودان هي المهمة الأكبر، باعتبارها البوابة الوحيدة ليصطف الوطن كله من أجل تحقيق التنمية والدولة القوية والنهضة المأمولة. سعى لتحقيق هذه الوحدة بمحاولة صب كل المكونات السودانية الاثنية والثقافية المختلفة والمتنوعة في “قالب” عروبي وإسلامي واحد. ولهذا كانت مهمته المقدسة الكبرى هي أسلمة وتعريب الجنوب، أكبر المختلفين عن المكونات السودانية الأخرى.
ورغم أن مشروع، أو على الأقل فكرة، أسلمة وتعريب الجنوب كانت تراود الحكم الوطني الأول بعد الاستقلال إبان حكومتي إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل، إلا أن عبود هو أول رئيس سوداني يقر وينفذ سياسة تعريب وأسلمة الجنوب بوسائل شتى شملت القوة العسكرية والاقناع واستخدام كل المصادر المالية والبشرية المتوفرة. وكما يقول سكوباس. س. بوقوو Scopas S. Poggo ” كان واضحا أن عبود قد أقر سياسة التعريب والأسلمة كرجل عسكري عربي ومسلم، وكان واضحا أنه يرغب في تطبيق تلك السياسة بصورة سلمية، ولكنه كان على استعداد أيضا لتطبيقها بالقوة العسكرية إن دعا الأمر” (6).
وقد أورد بوقوو “ما جاء في منشورة جنوبية هي (صوت جنوب السودان) الصادرة في عام 1964م، من أن مدراء المديريات الجنوبية أصدروا بيانا جاء فيه: “يجب أسلمة وتعريب الجنوب من أجل تحقيق وحدة سياسية في السودان، والوصول إلى الهدف النهائي: قطر واحد (هو السودان) ولغة واحدة (هي العربية) ودين واحد (هو الإسلام)”.
وكان ذلك الهدف يقتضي بالضرورة منع حرية الأديان، وسلب الحقوق اللغوية، وتقييد الحريات السياسية.
ولتنفيذ سياسة عبود لتعريب وأسلمة الجنوب تم فرض استخدام اللغة العربية، ليس فقط في المدارس، بل في مكاتب الحكومة أيضا. ومَثَّل ذلك عقبة أخرى أمام تطلعات الجنوبيين (الذين لا يجيدون العربية) في المساواة في التوظيف بالحكومة (خاصة في وزارات سيادية مثل الخارجية والدفاع)، وعدوا تلك السياسة محض “عبودية سياسية”.
وذكر بوقوو أن الحكومة قامت أولا بتخيير كل رجال الإدارة الأهلية بالجنوب بين اعتناق الإسلام أو فقدان كل سلطاتهم التقليدية. ووافق كثير منهم على اعتناق الإسلام حفاظا على سلطاتهم ونفوذهم في أوساط مواطنيهم. وأرسلت إليهم الحكومة طائرات خاصة حملتهم إلى الخرطوم حيث وجدوا ترحيبا كبيرا واحتفالات ضخمة، وقامت الإذاعة السودانية بالإعلان عن أسماء كل رجال الإدارة الأهلية في الجنوب الذين اعتنقوا الإسلام. ولعل القصد من ذلك الإعلان الإذاعي هو بعث رسالة للمجتمع الدولي بجدية الحكومة في عمليتي التعريب والأسلمة، وبعث رسالة أخرى للجنوبيين بأن قادتهم الشعبيين قد دخلوا في دين الإسلام وأن عليهم أن يحذوا حذوهم. وطلبت الإدارة في الجنوب من التجار الشماليين العاملين في مختلف المناطق حمل المصاحف معهم حيثما ذهبوا ليروه لزبائنهم من الجنوبيين. وكان ذلك من أجل “العرض” فحسب، وليس من أجل عاطفة دينية حقيقية. وقد كان أحد المفتشين قد خاطب جمعا من الجنوبيين وقال لهم: “لسنا مهتمين بصلاتكم أو صيامكم. كل ما يهمنا هو أن تدخلوا الإسلام وأن تدعوا الآخرين من أهلكم لدخوله، وأن يقوموا بتغيير ديانة أبنائهم المسيحيين للإسلام. فالمسيحية دين غريب عليكم كان ينبغي أن يذهب مع رحيل المستعمر الأوربي” (7).
الغاية – الوحدة الوطنية – نبيلة كما ترى. ولكن فهمها، ووسيلة تحقيقها، وآليات تنفيذها تخرج من تحت قبضة عسكرية ولا ترى في “الاختلاف” ثراءً وتنوعاً، وإنما تراه شذوذاً وخروجاً عن “الصف”، إذا أطلق له العنان فإنه سينشر الفوضى ويثير البلبلة والفتنة، لذا يجب قمعه وكبته، والتعامل معه بصرامة وحزم.
وهذا ما فعله عبود ونظامه ، فأسقطته شرارة ندوة كانت عن مشكلة الجنوب والحريات العامة في جامعة الخرطوم !.
لذا قلنا بأن مجرد التفكير في أن تكون المؤسسة العسكرية والأمنية بعقيدتها التقليدية هذه ضمن صفوف الحراك الثوري، أو أن تكون شريكاً في نظام يتأسس على مبادئ الثورة، هو ضرب من الخيال الشاطح. وأن ذلك متى ما تحقق فإنه شهادة الوفاة غير المعلنة للثورة، بإفراغها من مضامينها، والسير بها في الاتجاه المعاكس.
حسناً.
بناء على ما تقدم: ما موقف المكون العسكري في السلطة الانتقالية؟.
كيف ينبغي أن يُنظر إليه؟.
هل هو فصيل أصيل من قوى الثورة، وعامل ذا أثر ايجابي وفعال في عملية الانتقال إلى مدنية الدولة؟.
أم هو مكون لثورة مضادة في جسم الثورة، ويشكل خطراً عليها؟.
(هامش)
(1) أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي، القاهرة/ مصر، الطبعة الثالثة 1407هـ – 1987م، ص 210،211. يقول أمل دنقل في أبيات من قصيدة “تعليق على ما حدث في مخيم الوحدات” في وصف هذه الجيوش:
(2)
قلت لكم في السنة البعيدة
عن خطر الجندي
عن قلبه الأعمى، وعن همته القعيدة
يحرس من يمنحه راتبه الشهريّ
وزيّه الرسميّ
ليرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء
والقعقعة الشديدة
لكنه .. إن يحن الموت ..
فداء الوطن المقهور والعقيدة:
فرَّ من الميدان
وحاصر السلطان
واغتصب الكرسيَّ
وأعلن “الثورة” في المذياع والجريدة !.
(2) في واحدة من تعريفاته الفاضحة للقوانين العسكرية يقول نابليون إن القوانين العسكرية غبية: من يطيعها غبي، ومن يخالفها غبي.
(3) في الحواضن العسكرية حيث تعاد صياغة عقل المجند تتقابل متناقضة مفاهيم “العسكرية” و”المدنية”. فبينما تدل الأولى على الانضباط والمسؤولية والرجولة، تدل الثانية على الفوضى والانحلال والميوعة. وحينما يرتكب الجندي فعلاً يناقض “القيم” العسكرية يوصف سلوكه – تحقيراً – بـ”المدني”.
(4) وتقف تجربة حكم الرئيس جمال عبد الناصر في مصر أيضاً شاهداً على ذلك. فقد استطاع أن يحدث تغييراً اجتماعياً في مصر، استطاع عبره بمجانية التعليم والاصلاح الزراعي بتوزيع الأراضي الزراعية للفلاحين بانتزاعها من الإقطاعيين، وإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة وتضييق الفجوة بين الفقراء والأغنياء ..الخ، أن يخلق طبقة متوسطة في مصر صارت هي رافعة المجتمع المدني، ولكنه صادر بالمقابل الحرية السياسية والرأي الآخر وفتح السجون على مصراعيها أمام الطبقة الوسطى التي ساهم في نشأتها بمجانية التعليم!.
(5) ثمة واقعة كنت شاهداً عليها في الأيام الأولى لانقلاب البشير الإسلاموي تجسد بشكل كاراكتيري تجسد معنى الأوامر وتنفيذها عند العسكر. لم يجد شباب الحي الصغار مكاناً يتجمعون فيه سوى أمام منزل أحدهم، فجاءت سيارة عسكرية ، نزل جنودها وهم يحملون أسلحتهم الموجهة على الشباب، وسألهم أحد جنود الصف: مش عارفين في حظر تجول؟ أجابوه بنعم. فسالهم ولماذا متجمعون ، قالوا له نحن لا نتجول ولكننا جالسون أمام المنزل نتونس. إنتهرهم قائلاً: ممنوع التجمع انهضوا وأدخلوا منازلكم. وكان يعني بذلك أن يدخلوا المنزل الذي يجلسون أمام بابهم ، فقال له أحدهم طيب. فسأله الجندي ماذا قلت؟ فرد الشاب وقد بدأ الخوف يداخله: قلت لك: حاضر سندخل. فقال الجندي بغضب وضيق صدر: أنا لم أقل لك لو سمحت أدخل ، قلت لك أدخل تقوم وتدخل بدون رد، لو قلت لك: عن أذنك، أو لو سمحت أدخل، يمكنك أن ترد بحاضر، قم وأدخل بدون كلام!.
(6) سكوباس س. بوقوو، إدارة الفريق عبود العسكرية للسودان (1958 – 1964م) وتطبيق برنامج أسلمة وتعريب جنوب السودان، عرض: بدر الدين حامد الهاشمي، موقع صحيفة سودانايل، 06-16-2015.
(7) سكوباس. س. بوقوو، مصدر سابق.
عزالدين صغيرون