الراكوبة تنشر كتاب بيت العنكبوت للكاتب الصحفي فتحي الضو (4) الفصل الثاني
أسرار الجهاز السري للحركة الإسلاموية السودانية
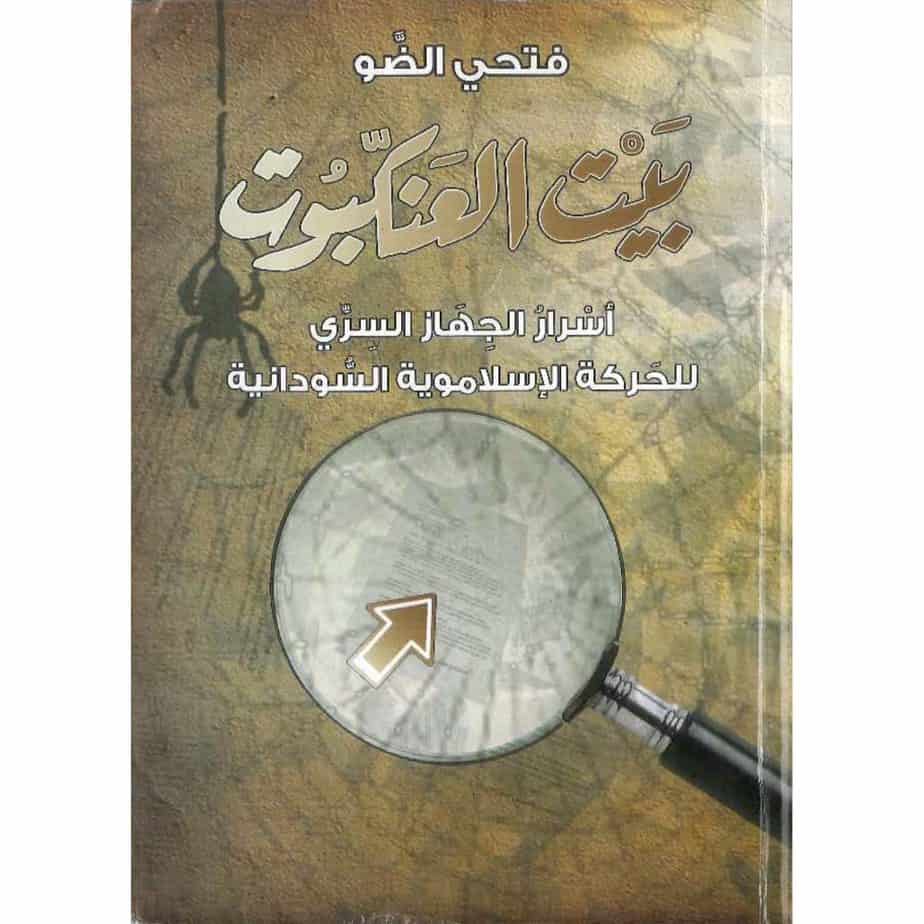
تواصل الراكوبة نشر كتاب بيت العنكبوت، أسرار الجهاز السري للحركة الإسلاموية السودانية للكاتب والصحفي فتحي الضو نقلاً عن صحيفة السياسي..
ويعتبر بيت العنكبوت من أهم الكتب التي نشرت إبان العهد البائد، ويكشف أسرار الجهاز السري لنظام الإنقاذ، الذي تولى كثيرا من العمليات القذرة من إعدامات واعتقالات وتعذيب. وعمدت أجهزة النظام السابق على منع تداول الكتاب ونشره في السودان مما حرم كثير من السودانيين من الوقوف على الجرائم التي ارتكبها الجهاز السري للحركة الإسلامية، بل كانت حيازته تمثل جريمة يستحق مرتكبها الاعتقال والتنكيل به لما فيه من فضح وكشف للعقلية الإجرامية للقائمين على أمر هذا الجهاز وبشاعة ما ارتكب من جرائم. “بيت العنكبوت” للكاتب والصحفي فتحي الضو، يحيط بخيوطه التي لا فكاك منها بجانب كثير من المعلومات التي وثقها لتبقى على مدار التاريخ تذكرة بحقبة سوداء صبغت ثلاثة عقود من عمر السودان بكل ألوان الفساد والاستبداد، بل وتجاوزت روائحها خارج الحدود.
وللاطلاع على الجزء الأولى فضلاً اضغط هنا
والجزء الثاني بالضغط هنا
الجزء الثالث
الفَصْلُ الثانِي
بَيْت العَنْكَبُوت
مِن مَأمَنِهِ يُؤتِى الحَذَر..
أكثم بن صيفي التميمي
تدافعت الأحزاب الثلاثة (الأمَّة، الاتحادي الديمقراطي والإخوان المُسلمين) التي أبرم معها نظام الرئيس المخلوع جعفر محمَّد نميري صفقة “المُصالحة الوطنيَّة” للانخراط في مُؤسَّسات النظام، وبالذات التنظيم الأوحد المُسمَّى بـ“الاتحاد الاشتراكي”، وكذا مجلس الشعب، بغضِّ النظر عن كونها كيانات كارتونيَّة صُمِّمت لخدمة ديكتاتوريَّة الفرد. وكان تنظيم الإخوان المُسلمين بقيادة دكتور حسن عبدالله التُرابي الأكثر اندفاعاً للاندغام في النظام المايوي ومُؤسَّساته. فاستغلَّ التنظيم تلك الفرصة، وبدأ التغلغُل وسط القطاعات المُختلفة.. الطلاَّب، العمال، المُهندسين، الأطباء، المُزارعين، الإعلاميين، وكذلك في القوات النظاميَّة بفروعها الثلاثة، القوَّات المُسلحة والشرطيَّة والأمنيَّة «إلَّا أن تجربة الجبهة الوطنيَّة وعودة عناصرها المدربة إلى السودان بعد المصالحة الوطنية، قد انتقلت بأشواق الجهاد التليدة إلى صيغة العمل العسكري الأمني المنضبط بالخطة الإستراتيجية»[1]. وتبعاً لهذه الإستراتيجية «تداعى لتأسيس مكاتب المعلومات المركزية وفروعها المحدودة في الجامعات وبعض المدن العناصر التي تلقت تدريباً عسكرياً اجتهدوا في تطويره ومده بثقافة تتعمق في علوم الاستخبارات وإدارتها»[2]. وعليه، يبدو أن تلك مشاركة كأنما غَفِلَ فيها النظام المايوي، أو غضَّ البصر، وكلاهما إلى حين!
كانت تلك القوى السياسيَّة الثلاث، قد غلَّبت خيار إسقاط نظام المُشير جعفر نميري بوسيلة العمل المُسلَّح، وهي تجربة لم تخضع للتقييم، ولم تُوضع تحت المجهر للنظر إليها بموضوعيَّة من قِبل صانعيها حتى الآن، شأنها في ذلك شأن كثير من التجارب المُؤثرة التي عبرت من فوقها قوافل الصَّمت والسُكون. ولعلَّ الأكثر إيلاماً، أن بعض تلك التجارب دُفِعت فيها أرواح بشر، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن أرخص الكائنات قيمة في الواقع السُّوداني هُو الإنسان، ذلك رغم الميثولوجيا الغارقة في الشحنات العاطفيَّة. لسنا هُنا بصدد تقييم تلك التجربة، ولكن السرد وتسلسُله فرضا الاقتراب منها – ولو بحذرٍ شديد– حتى لا يُصبح تاريخنا مليء بالفجوات وقابل للتزوير!
كانت معسكرات الجبهة الوطنيَّة قد تأسَّست في ليبيا بمُبادرة وجهود أفرادٍ من الأحزاب الثلاثة، استغلوا تدهوُر العلاقات بين نظام نميري وما سُمِّي بـ“حلف عدن” الثلاثي: أثيوبيا، اليمن الجنوبي وليبيا، وكان نظام العقيد معمَّر القذافي أكثرهُم فُجُوراً في الخُصُومة، فبادر بتقديم دعم لوجستي كامل للمُعارضة، بتدريب كوادر قتاليَّة على مدى سنوات. خلالها، كان التدريب داخل تلك المُعسكرات قد استند على ساقين: تدريبٌ عسكري وتدريبٌ أمني، وبعد أن استيقن القائمون عليه من اكتماله، تحرَّكوا بقُوَّاتهم من جنوب ليبيا بقيادة “العميد محمَّد نور سعد”، وقطعوا آلاف الأميال عبر الصحراء الكُبرى، إلى أن وصلوا قلب العاصمة المُثلثة، حيث دارت في بعض مواقعها معارك طاحنة، راح ضحيَّتها العديد من الأرواح من كلا الطرفين، وكذا بعض المُواطنين الذين ساقتهم الأقدار إلى موقع الأحداث. وبعد فشل العمليَّة، قام النظام بتكملة عُرس الدم، حيث أعدم أعداداً كبيرة من القوَّات المُعارضة. وكما ذكرت، لسنا بصدد تقييم هذه العمليَّة، ولكن باختصار شديد، يمكن القول إنها نجحت عسكرياً وفشلت أمنياً!
لقد نجحت عسكرياً بدليل اجتيازها المسافات الطِوال، والوُصول إلى العاصمة، والاشتباك مع قوَّات النظام التي ضاعت هيبتها العسكريَّة. وفشلت أمنياً، نظراً لقُصُورٍ صَاحَبَ العمليَّة في التكتيك والاتصالات والدعم اللوجستي المُصاحِب، وعدم الإلمام بجُغرافيا العاصمة المُثلثة ومعالمها، وهكذا لم يحدُث أي استيعابٍ لدُرُوس التاريخ، على الرغم من أن التدريب الأمني شمِلَ كوادر مشتركة من القوى الثلاثة. لهذا، كان من البديهي أن تنهار كل سنوات التدريب أمام كلمة واحدة، وصف بها إعلام النظام القوَّات الوطنيَّة ونعتها بـ“غزو المرتزقة”، فتداعى الوجدان السُّوداني، وإلى يومنا هذا يعدَّها البعض كذلك. وبعدئذٍ، فرض توازُن الضَّعف دخول الأطراف الثلاثة في ما سُمِّي بـ“المصالحة الوطنية”[3] في العام التالي 1977، بالرغم من أنها لم تكن اسماً على مُسمَّى كما تُوحى لسامعها!
ما يهُمُّنا من هذا التسلسُل السَّردي، التذكير بأن مفهوم الأمن لم يتبلور بمعناه المنهجي والمعرفي في أجندة القُوى السياسيَّة السودانيَّة بصورة إيجابيَّة. فهي تسعى دائماً إلى تسخيره في الوجهة السَّالبة، وما تزال عُضويَّتها تمارسه وكأنها قابعة في دهاليز القرون الوُسطى. وفي واقع الأمر، فإن الحزب الشيوعي السُّوداني يُعَّدَّ ثاني اثنين أوْليا المسألة الأمنيَّة اهتماماً كبيراً داخل أوعية الحزب. بفارق أن الحزب الشيوعي يزعم أن اهتمامه مَبعثه تحصين الحزب من الاختراقات، في حين أن الحركة الإسلاميَّة – وهي الضلع الثاني الذي نعنيه – استخدمته أداةً لاختراق الآخرين. وعليه، فإن الاهتمام بالمسألة الأمنيَّة في بنود القُوى السياسيَّة العقائديَّة لا يبدو نشازاً، بمثل ما أن تطاول أيديهما لتكوين خلايا داخل القوَّات المسلحة كان وبالاً على الاستقرار السياسي للبلاد. يجدُرُ بنا القول، إن الحزب الشيوعي لم يكُن آنذاك ضمن زُمرة المُشاركين في حلف الجبهة الوطنيَّة، فقد تبنَّى خيار البقاء داخل الوطن ومُمارسة المعارضة السلميَّة بغضِّ النظر عن موسميَّتها. وبعد أن أعدم جعفر نميري قياداته التاريخيَّة في العام 1971، برع الحزب في إخفاء سكرتيره العام، الرَّاحل “محمَّد إبراهيم نُقُد” من عيون جهاز الأمن على مدى أربعة عشر عاماً، أي طوال عُمر النظام إلا قليلاً!
عمليَّة الانخراط في النظام من قِبل القُوى المُتصالِحة، وما صاحبها من توجُّساتٍ حدت باستنهاض الأجهزة الأمنيَّة الخاصَّة، تُذكِّرُنا هذه الأخيرة أن الحركة الإسلامويَّة كانت قد كوَّنت جهازاً داخل المُعسكرات، ذا نشاطٍ منفصل من جهاز أمن التحالف الثلاثي والتي تشارك فيه أيضاً. وهي المُهمَّة التي تولاها بالعناية “الصافي نورالدين”، ثمَّ “عوض أحمد الجاز”، وفي مرحلة لاحقة بعد سنواتٍ، شاركه المُهمَّة “علي عثمان محمَّد طه”.
تواصَلَ نشاط “جهاز جمع المعلومات” بعد اكتمال مسألة “المصالحة الوطنيَّة”، والتي بموجبها صارت الحركة الإسلاميَّة داخل عباءة النظام المايوي. لهذا، فقد عمل القائمون على الجهاز على تقويته وتغذيته بعناصر جديدة، علاوة على الكوادر القديمة المُجنَّدة أصلاً، والتي نالت تدريباً خاصاً في المُعسكرات، وصارت الفكرة الرئيسيَّة التي تمحور حولها نشاط الجهاز، هو: كيفيَّة الوُصول إلى سُدَّة السُّلطة بكُلِّ الوسائل، المشروع منها وغير المشروع!
هذه الغاية جعلت الحركة الإسلاميَّة تبرِّر الوسائل، حتى غير الأخلاقيَّة منها، وذلك باستخدام “فقه الضرورة”. فمن المعروف في فضاءات السياسة، لكي تسيطر على جهاز الدولة المدني والنظامي بوسائل غير ديمقراطيَّة، فالمرء يحتاج لكيان قوي ليُخضِعَ المُجتمع تحت إرادته، ويُوجِّهه كما الدابَّة لأي وجهة يبتغيها. وهُنا تجلت الأيديولوجيا في أظهر تطبيقاتها. فالتسليم المُطلق بالفكرة يُجبرُك أن تقول لوالديك “أُفٌ” إذا ما كان عصيانهما في مصلحة التنظيم. والتسليم للفكرة يُلزمُك أن تُبلغ السُّلطات عن شقيقك، الذي اختبأ خشية بطشها، إذا ما كان ذلك في صالح إعلاء شأن التنظيم.. فالتعذيب يُصبحُ ضرورة من أجل انتزاع الأقوال، والقتل يضحى خياراً لو أن القاتل وُعِد بالفردوس نُزلاً، وهكذا دواليك في أجندة التربية العقديَّة التي تتغلب على الوطنيَّة.
تلك هي الخلفيَّة العقديَّة التي تأسَّست عليها الأجهزة الأمنيَّة للحركة الإسلاميَّة، وسارت في ركاب سُنَّتها الراكزة، واتخذتها منهجاً في إدارة الدولة بعد أن دالت لها السُّلطة، وجلست القرفصاء على عرشها. كان جهاز جمع المعلومات جهازاً فولاذياً، أحاط نفسه وفق “المنهج الماسوني” بسريَّة مُطلقة، استطاع أن يحافظ عليها ويمارس كل أنشطته الخاصة بالحزب. وفي نفس الوقت، أخفى هذه الأنشطة عن عيون جهاز أمن نميري. كان الخُضُوع للفكرة والتسليم العقدي، في أقصى اكتماله التجريدي، لأنه لم تخالطه آنذاك سُلطة ولا جاه، مثلما حدث بعد سنواتٍ، وصارت الأفواه تردِّد تلك الأهزوجة “لا لدنيا قد عملنا”، وتنطق بها الألسن طرباً من سُكر السُّلطة، وما تزال، رغم تبيان خطلها على أرض الواقع!
بعد سقوط نظام نميري، وفي أثناء الحقبة الديمقراطيَّة الثالثة، تضخَّم الجهاز الأمني للحركة الإسلامويَّة، تطبيقاً لمقولة سائدة في أوساط عُضويَّتها، تُؤكِّد أن “كُلَّ كادر جبهوي هُو بالضرورة عُضوٌ في الجهاز الأمني، وليس كُلَّ كادر أمني عُضُوٌ في الحركة الإسلاميَّة”. تلك مقولة استوجبها واقعٌ ومرحلة جديدة في نشاط الجهاز، حيث تمَّت الاستعانة بأفرادٍ كثيرين من كوادر جهاز الأمن القومي، الذي كان تابعاً للرئيس المخلوع جعفر نميري. جاءت هذه الكوادر بخبراتٍ أمنيَّة كبيرة، تمتلك أطناناً من الأسرار، سواء على النطاق المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ساعد في تقويته أيضاً، مناخ الحريَّات العامَّة الذي تكفُله الديمقراطيَّة وسماحتها، بما يرقى أحياناً إلى درجة التفريط!
وبينما استمرَّ الحال على هذا المنوال – قبل الانقلاب الذي نُفذ في العام 1989– كان “جهاز المعلومات الخاص” بالحركة الإسلاميَّة قد انبسط وتمدَّد، ليُصبح أكبر جسم باطني في تاريخ الأحزاب السياسيَّة السُّودانيَّة مجتمعة، فقد ضمَّ الآلاف من الناشطين الذين تنوَّعت وتعدَّدت مصادرهم، ومنهم: مصادر عقائديَّة ملتزمة، مصادر مأجورة، ومصادر متعاطفة.. وكانت ثلاثيَّة المصادر هذه مُثبتة في كل حيٍ من أحياء السُّودان، لا تغيب عنها شاردة أو واردة. ثمَّ هنالك ”جهاز طوارئ“ انضوى تحت لوائه آلافٌ من المُدرَّبين على السِّلاح تدريباً جيداً، وهناك المئات في قطاع المِهَن والعُمَّال، وكذلك هناك آخرون مُدرَّبون على العمل الاستخباري، يضطلعون بحماية الشخصيَّات الهامَّة، وحفظ وتأمين الأماكن والوثائق، وكذا الاختطاف والاختراق والتهريب، إلى جانب كل أعمال الهَوَس العقائدي. إضافة إلى ذلك، هناك فئة هامَّة جداً، يُطلقُ عليها مصطلح ”السوَّاقين“، وهُم فئة المدنيِّين الموصولين بالعسكريِّين ليكونوا وسيطاً بينهم وبين قيادة الحركة التنظيميَّة.. ومن أهم هؤلاء، على سبيل المثال: أحمد علي الفشاشُوية، الزُبير محمد الحسن، علي كرتي، محمَّد الحسن المقلي (شقيق عبدالله حسن أحمد، الذي انتقل للدار الآخرة)، ثم علي الرَّوَى (أيضاً توفي قبل أعوام بعد إصابته بمرض السرطان)[4].
ولنضرب مثلاً واقعياً عمَّاً ذكرنا أعلاه، وذلك بحدثٍ كان له تأثير كبير في استراتيجيَّات المنطقة. فمن ضمن الكوادر القياديَّة الأمنيَّة المايويَّة التي استعان بها الجهاز الأمني للحركة الإسلامويَّة، كان الثلاثي: اللواء عثمان السيِّد، اللواء الفاتح عروة واللواء جعفر حسن صالح، وآخرون أيضاً، مثل: هاشم أبا سعيد، وعاصم كبَّاشي والجيلي المصباح وهلمَّ جرَّا. كانت منطقة القرن الأفريقي تمورُ تحت رمالٍ متحرِّكة، وتفور تحت تنور أحداثٍ جسام. فالنظام الماركسي في أثيوبيا بزعامة مانغستو هيلا ماريام كان يترنَّح تحت ضربات المعارضة الأثيوبيَّة والإريتريَّة، اللتين عملتا بتنسيقٍ مشترك، ونجحتا في تحرير مساحاتٍ واسعة من بلديهما، ثمَّ بدأتا تُصوِّبان عينيهما نحو العاصمة أديس أبابا. وكذلك كان نظام الرئيس سياد بري في مقديشو يشكو الأمرَّين.. المجاعة التي حاصرت البلاد، وزحف المعارضة الصوماليَّة من الشمال نحو العاصمة مقديشو في الجنوب!
كانت الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة الوحيدة من بين القُوى السياسيَّة التي نظرت إلى تلك الوقائع بعيني ثعلب، فكانت الاستثناء من بين القُوى السياسيَّة التي مدَّت ذراعيها نحو منطقة القرن الأفريقي لتحتضن معارضتي ذينك البلدين، وتبدأ شراكة خفيَّة مع قُوى المعارضة الأثيوبيَّة والإريترية تحديداً. وكان ذلك أوَّل سُفُور لـ“فقه الضرورة” على مستوى العلاقات الخارجيَّة. فالقُوى المعارضة المذكورة كانت تنهل من نفس الخلفيَّة الماركسيَّة التي يتكئ عليها نظام مانغستو هيلا ماريام، اللذين يُناصبونه العداء، ولكن الجبهة الإسلامويَّة غضَّت الطرف عن تلك المرجعيَّة، بالرغم من أنها تتضاد مع توجُّهاتها العقديَّة. بمثل ما غضَّت الطرف بعد سنواتٍ مع الصين، منبع الماركسيَّة الأخرى. من جهة ثانية، لم تشغل الجبهة الإسلامويَّة نفسها بالواقع السياسي المُتهالك في الخرطوم آنذاك، بل حينما تفعل ذلك، كانت تبذل الجهد تلو الجهد من أجل تكديره بمزيد من المُنغِّصات. ثمَّ توجَّهت بكُلِّ ثِقلِها الماكر نحو منطقة القرن الأفريقي، في حين كان “آل بوربون” يتعاركون على كراسي الائتلاف وينهمكون في إحصاء نقاط الاختلاف!
وجَّهت الجبهة الإسلامويَّة في وقتٍ مُبكِّر الثُلاثي المذكور من قادة جهاز أمن نميري، وآخرين كانت لديهم علاقاتٍ وروابط مع الحركات الأثيوبيَّة والإريتريَّة المُعارضة، اكتسبوها بعملهم في المنطقة إبان فترة الرئيس المخلوع. وللتذكير، فإن اثنين من الثلاثة، وهُما: عثمان السيِّد والفاتح عروة كانا عرَّابين لعمليَّة نقل اليهود “الفلاشا” الشهيرة، وثالثهُما كان أيضاً من الرَّوافع. اختصاراً، للتفاصيل قام المذكورون بإيصال الإمدادات العسكريَّة وتقديم الدعم اللوجستي، الذي جادت به الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة للحركتين المُعارضتين حتى وصلتا أبواب أديس أبابا أولاً، ثمَّ أسمرا ثانياً، وهي المُهمَّة التي تسارعت أصلاً عام 1989، بعد أن وصلت الجبهة الإسلاميَّة إلى الحُكم عُنوةً، وبالانقلاب العسكري اقتداراً، فضاعفت من الدَّعم وهي تعد الأيام وتتحرَّى الانتصار، الذي لم يطل، وتمَّ في فترة وجيزة. وبعده كُوفِئ الثُلاثي بما قدَّمت أيديهم، حيث عُيِّن عثمان السيِّد سفيراً في أديس أبابا، ولسنين عدداً، ظلَّ خلالها نصف حاكم في أثيوبيا، كما عُيِّن جعفر حسن صالح سفيراً في أسمرا حتى لحظة المُفاصلة بين النظامين العام 1994.. أما الفاتح عروة، فقد نال الحُسنين إلى جوار الرئيس “الضرورة”، مرَّة كمستشار أمني، وأخرى عَبَرَ فيها الأطلنطي ليُصبح مُمثلاً للبلد الصَّابر أهله في المنظمة الأمميَّة بنيويورك، وعاد بعدها وما تزال العطايا تترى عليه!
خلال الشهور الأخيرة التي كانت تترنح فيها الحقبة الديمقراطيَّة الثالثة، كانت بعض كوادر جهاز الأمن التابع للجبهة الإسلامويَّة تظهر للسَّطح تحت ستار أنشطة مختلفة، وذلك تدبيراً ومن ثمَّ تنفيذاً لخُطة الانقلاب. وبالفعل، تمَّ اختيار نحو ثلاثمائة كادر لهذا الغرض، وبالرغم من أنهم تخفَّوا، إلَّا أنهم في يوم التنفيذ كانوا أوضح من الشمس في رابعة النهار. بعضُهُم ارتدى زياً نظامياً أثناء التنفيذ، وآخرون ظلوا بلباسهم المدني المعهود. المُدهش أنهم استغلوا التسيُّب الأمني والسياسي الذي طغى على الحقبة الديمقراطيَّة، وحصل التنظيم على الزي العسكري كاملاً، بما في ذلك العلامات التي ترصِّع كُتُوف الضُبَّاط، وكذلك تحصلوا على أجهزة اتصال حديثة Walkie Talkie، وأسلحة خفيفة جاءتهم من الخارج عبر الموانئ السودانية براً وبحراً.. بل لعلَّ الأكثر مدعاة للدهشة والاستغراب، أنَّ هذه الكوادر قامت بإجراء أكثر من “بروفة” لسيناريو الانقلاب في العاصمة المثلثة قبل اليوم الموعود!
بعد نجاح الانقلاب، قامت اللجنة السُداسيَّة المُناط بها تدبيره وتنفيذه بتكوين ما سُمِّي “لجنة الأمن والعمليَّات العُليا”، ورأسها اللواء الزبير محمَّد صالح، وضمَّت بعض العناصر المُختارة، نشط منهم بشكلٍ خاص عُنصران أساسيَّان، هُما: الرائد إبراهيم شمس الدين، والمهندس موسى سيد أحمد المُطيَّب، وإليهما تعود أفكار الحَسْم والعَدْمِ، تنظيراً وتفعيلاً، وقد شاءت إرادة المولى تبارَكَ وتعالى أن يقضيا أجلهُما، كلٌ منهُما في حادث تحطُّم طائرة. وفيما يتعلق بالاعتقالات التي طالت العديد من الناشطين السياسيِّين وغير الناشطين، وما صاحب ذلك من قصصٍ مثيرة تتحدَّث عن الظاهرة الشيطانيَّة المُسمَّاة “بيوت الأشباح”، والتعذيب والتنكيل والقتل، الذي كان يجري بداخلها.
يجدُرُ بنا تأمُّل دور “لجنة الأمن والعمليَّات العُليا” هذه بصورة عامَّة، ثمَّ دورها الخطير في رصد حركة رمضان/أبريل 1990، وإعدام الضُبَّاط الـ28، الذين قيل إنهم كانوا يُخططون للقيام بانقلابٍ عسكري مُماثل لانقلاب الإنقاذيين، وإلى جانبهم عشراتٌ من ضُبَّاط الصَّف والجنود، دون مُحاكمات. ويُنظرُ أيضاً بتأمُّل إلى دورها في إعدام الشباب الثلاثة: “مجدي محجوب”، مساعد الطيَّار “جرجس يُسطس” والمواطن الجنوبي“أركانجلو داقاو”، وإعداماتٍ أخر فطرت القلوب وفتت الصخر العصيَّا![5]
بعدئذٍ تضخَّم الجهاز الأمني للدرجة التي تناسلت منه أجهزة أخرى تحت مُسمَّيات عِدَّة، ما أدَّى إلى حدوث تضارُبٍ وتصادُم بينها، ومع ذلك استمرَّ الحال على ذاك المنوال الباطني، لكن ظاهرياً كان لا بُدَّ للنظام الجديد من واجهة أمنيَّة. فتمَّ تعيين عضو “الثورة” العميد إبراهيم نايل إيدام مديراً لجهاز الأمن لفترة قصيرة، ثمَّ أقيل ليتم تعيين “الفريق محمد السنوسي”، والذي أيضاً أقيل بعد فترة قصيرة ليتم تعيين الدكتور نافع علي نافع مكانه، والذي أسفرت السُّلطة الأيديولوجيَّة عن وجهها الحقيقي في عهد إدارته “الميمون”.
عضَّد جهاز الأمن من قبضته على مقاليد الأمور مُستعيناً بحالة الطوارئ التي استمرَّت لفترة طويلة بعد الانقلاب، ظلت خلالها الدبَّابات مُرابطة في المنافذ، وشاهرة مدافعها لتخويف كُلِّ من تُسوِّل له نفسه ويجرُؤ على محاولة تغيير الحُكم، أو مجرَّد التفكير في ذلك. وأيضاً عزَّزت هذه الأجهزة من حمايتها للسُّلطة الانقلابيَّة بتواصُل الحراسة آناء الليل وأطراف النهار، وفتحت الحراسات السرية (بيوت الأشباح) على مصراعيها فضجَّت بالمُعتقلين، وشهدت أسوأ أنواع التعذيب، الذي أفضى لموت كثير من الناشطين، إمعاناً في التخويف والترهيب والترعيب!
آنذاك تمَّ تكوين جهاز للأمن الداخلي برئاسة بكري حسن صالح، وظلَّ الأمن الخارجي بإشراف نافع علي نافع، ولكن ليس وحده المُناط به إنجاز تلك الأهداف “النبيلة” للدولة السُنيَّة، فقد استعان بمساعدين آخرين من ذوي البأس في أروقة العُصبة، فقام المذكور بضمِّ متعاونين مُنتخبين من خريجي جامعتي الخرطوم والقاهرة فرع الخرطوم (النيلين لاحقاً)، وهُم في الأصل من الكوادر التي نالت تدريباً خاصاً في الجهاز. وحتى يستقيم تسلسُلنا نستميح القارئ عُذراً في اقتباساتٍ مُطوَّلة من سفرنا السابق “الخندق” لما لها من أهميَّة، نريد بها الوصول إلى غاية سيُدركها القُرَّاء بعد حين.
تواصُلاً مع ما ورد أعلاه، فإن الكوادر التي نالت تدريباً خاصاً شملت: «صلاح عبدالله قوش (هندسة جامعة الخرطوم)، محمد عطا المولى (هندسة جامعة الخرطوم)، حسب الله عُمَر (هندسة جامعة الخرطوم)، عِمَاد الدين حسين (معمار جامعة الخرطوم)، جمال زَمقان (هندسة جامعة الخرطوم)، طارِق محجوب (هندسة جامعة الخرطوم)، الرشيد فقيري (هندسة جامعة الخرطوم)، كمال عبداللطيف (اقتصاد جامعة الخرطوم)، نصرالدين محمد أحمد (اقتصاد جامعة الخرطوم)، عُمَر نِمِر (تجارة جامعة القاهرة)، محمد حسب الرسول (تجارة جامعة القاهرة)، عُمَر الأمين (حقوق جامعة القاهرة)، محمَّد الحسن أبوبكر (تجارة جامعة القاهرة)، كمال موسى (حقوق جامعة القاهرة).. وبالطبع، تلك كوكبة ”تسد عين الشمس“»[6]!
الجدير بالذكر أن بعض هذه الأسماء ستتابعنا، مثل: عماد الدين حسين، الذي يسبق اسمه أحياناً بـ“المهندس” وأحياناً أخر بـ“الشيخ”، وسنرى كيف أنه يمثل شخصيَّة محوريَّة في هذا الكتاب. وكان كمال عبداللطيف قد تقلد مسئوليَّة جهاز الأمن الشعبي لفترة، أمَّا الرشيد عُثمان فقيري الذي التحق بجهاز الأمن في العام 1990، فقد تقلد عدَّة مناصب، منها مدير شركة قصر اللؤلؤ الهندسيَّة، وهي إحدى شركات جهاز الأمن والمُخابرات، وفي عام 2009 رُقي إلى رتبة “فريق” وأُسند إليه منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني والمُخابرات، وفي نوفمبر2011 عُيِّن وزيراً للتخطيط العُمراني في ولاية الخرطوم، ولا ندري في أي مخبأ طاب له المقام بعدئذٍ. وضربنا بهؤلاء مثلاً للتأكيد أن هذه الكوادر الأمنية عندما تنتقل لعملٍ آخر يبدو مدنياً في واجهته، فهي تحتفظ بمهامِّها ورُتبتها الأمنيَّة، وكامل مُخصَّصاتها أينما حلَّت!
«بعد تأسيس الجهاز الرسمي لدولة الإنقاذ بقيادة نافع علي نافع مستعيناً بالكوادر أعلاه، عنَّ للدكتور حسن الترابي عرَّاَب الانقلاب بعد خُرُوجه للعلن، تدشين ما عُرف بـ“معهد التدريب والدراسات الفكرية والحركية”، وأطلق عليه اختصاراً “قمم” وفرَّغ لهذه المُهمَّة الجديدة وجهاً من وجوه الكواليس اسمه بكداش أحمد المصطفى (ومن المُفارقات التي لحقت ببعض أهل السُّودان أن والده كان شيوعياً هواه، فإيماناً منه بالمبادئ التي اعتنقها، أراد منح هويَّته لابنٍ وُلِدَ له، فسمَّاه بـ“خالد بَكداش”، تيمُّناً بالزعيم التاريخي للحزب الشيوعي السوري.. لكن فيما يبدو أن الابن خذل والده، واتجه نحو المعسكر النقيض، وبعدها لم يسمع أحد من الناس باسم “خالد بَكداش” وأصبح صاحب الاسم يُعرفُ باسم “شيخ خالد” طبقاً لحالة ”الجذب الصوفي“ الذي دخل في أجوائها. ولاحقاً قام بتأسيس قناة تلفزيونيَّة أطلق عليها اسم “ساهور” وألحقها بإذاعة سُمِّيت “الكوثر”، وصار الرجل مؤلفاً للعديد من قصائد “المديح النبوي”! وهو رغم ذكائه والكاريزما التي يتمتع بها، إلا أنه كان غريبُ الأطوار، يجمعُ دائماً حوله عدداً من الشباب من الجنسين ، ويؤثر فيهم تأثيراً بالغاً، الأمر الذي يؤكده تحوُّلهم معه إلى “متصوِّفين منجذبين” عندما أسَّس الإذاعة والمحطة التلفزيونيَّة المذكورتين»[7]!
ليس هذا فحسب، «فواقع الأمر أنه قبل الوصول لهذه المحطة، فإن سيرة “خالد بَكداش” سابقاً و“الشيخ خالد” لاحقاً جديرة بالوقوف قليلاً.. ففي سياق المنافسة المحمومة بين الأجهزة التي تفرَّخت، كان للرجُل تاريخٌ حافل بالخُصُومة، بل واحتقار كادر “مكتب المعلومات” – أي صلاح قوش وجماعته – وفي هذا الصدد تمكَّن في فترة وجيزة من مدِّ خطوطه إلى كل أجهزة الحركة داخل السُّودان، وإلى الحركات الإسلامويَّة في كلِّ أنحاء العالم، تحت لافتة تنظيمية جديدة سُمِّيت “المبرة” وكانت بإشراف اللواء “الفاتح عروة”، الذي كان يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن، فأعمل كل خبراته في كيان قال أنه “كان يحلم به”، فأثارت الأنشطة الحافلة غيرة وحفيظة سدنة ”الجهاز“ الرسمي»[8]!
بعد ذلك، «ووفقاً لصفاته التي ورد ذكرها، انفتحت شهيَّة “بَكداش” وصحبه، فخططوا للوصول إلى بلدٍ أريقت فيها دماء المُسلمين في بواكير عهد الرسالة المُحمَّدية وجرت أنهاراً.. ربما لهذه الأسباب اختاروا المملكة العربيَّة هدفاً استراتيجياً، كأقصر الطرق وصولاً لـ“الأمميَّة الإسلاميَّة” حيث خططوا لعمليَّة، وربما لعمليَّات لا يُعرفُ تفاصيلها، لكن اللواء “الفاتح عِروَة” مستشارُهُم الأمني، نصحهم بالعُزوف عن ذلك نسبة لأن الأمن السعودي عَلِمَ بالعمليَّة (وإنني على يقينٍ بأنَّ الخُبثاء سيقولون: ومن أخبر الأمن السعودي؟ وعليه، ستصبح الإجابة إن المعنى في جوف الشاعر، كما يقولون).. لكن “بَكداش” المتحمِّس لاحتلال الكعبة المُشرَّفة مثلما أراد المتطرِّف السعودي “جهيمان العتيبي” من قبل، أصرَّ على مواصلة المسيرة بعناده المعروف، فبَعَثَ بطاقمه الاستشهادي إلى المطار للذهاب إلى السعوديَّة، ليس لحَجٍ يشهدون فيه منافع لهُم، ولا لعُمرة يمحون بها ذنوبهم، ولكن ليمحوا النظام الملكي من الوجود»[9]!
الذي حدث، «أنهم عندما لم يسمعوا نُصحَ اللواء “الفاتح عِرْوَة” حَمَل عروة نفسه بنفسه وذَهَبَ إلى مطار الخرطوم في اليوم المُحدَّد لسفر “المجاهدين” وصادر جوازاتهم ومنعهم من السفر.. في التقدير أن الذين حرمتهم العُصبة من السفر طوال السنوات الماضية، سيتنفسون الصعداء، وسيقولون: “المساواة في الظلم عدل”.. الشاهد، أن تلك كانت المرَّة الأولى التي تُمنَعُ فيها بعض عضوية العُصبة الحاكمة من السَّفر، أسوة بعموم شعب السودان مِمَّن مارست فيهم ذلك بمتعة وتلذذ.. من جهة ثانية، تزامنت مع تلك الواقعة ضربة قاضية تلقتها “المِبَرَّة” في السعوديَّة المستهدفة نفسها.. إذ تمَّ اكتشاف خليَّة في جهاز كمبيوتر رئيسها في مدينة جدَّة، يحوي معلومات مفصَّلة عن مناطق عسكريَّة في المملكة، فقامت السُلطات بحملة اعتقالات واسعة طالت معظم الكوادر المتفرِّقة في المُدُن السعوديَّة، وتولى الدكتور مصطفى عثمان التفاوُض مع السُلطات السعوديَّة، متئرعاً كعصبته بسلاحي النفي والإنكار، لكنه لم يستطع التبرُّؤ منهم بعد ما واجهه الأمير نايف بن عبدالعزيز وقال له: “أفهم أنهم لم يشتركوا في قضيَّة تفجير الخُبر، ولكن كيف أفهم وجود خرائط لمنشآت عسكريَّة في جهاز كمبيوتر رجُلٍ مدني؟”، وذلك بحسب قول مصطفى عثمان نفسه لعُصبته بعد عودته، ولعله كان صريحاً لأجل ألا يُقال عنه أنه جاء بخُفي حنين! لهذا لم يكن ثمَّة مناص أن يذهب المُعتلقون إلى السجون السعوديَّة، حيث قضوا أكثر من ثلاث سنوات، دون أن يجرؤ أحد على المطالبة بإطلاق سراحهم، وبمثل ما تبعثرت “قِمَمْ” من قبل، تبعثرت “المَبَرَّة”، وقاد بَكداش أبناءه وبناته الأبرار نحو سُوح التصوُّف، ولا ندرى إن كان يبغي مجداً لم يطُله، أو أنه أراد مسح ذنوبٍ ارتكبها عمداً»[10]!
انتهت وانزوت منظمة “المبرَّة” وذهبت بريحها وريح “بكداش”: «عندئذ خطر للدكتور الترابي أن يقدح زناد عبقريته فأخرج للوجود كائناً آخر ليحل محل “قمم”، فالتنظيم لا يمكن أن يغمض عينيه دون عتيد ورقيب أمني. فسمى المولود الجديد “مداخل” اختار الترابي لها ضمن فلسفته في بناء الأجهزة الأمنيَّة أربعة أشخاص للتأسيس، هُم: دكتور سيف الدين محمد أحمد، شرف الدين علي مختار، السعيد عثمان محجوب والصافي نورالدين ولكن لصراعٍ الظلام قناع واحد ومائة وجه.. إذ ظلت الكواليس تشهد توتراً، مع فارق في تغيُّر الممثلين على خشبة المسرح.. اختصاراً لقصص لا تنتهي طفق “الشيخ الترابي” و“الرئيس المُشير” يشيدون بأنشطة “مَدَاخِل”، وفي المقابل ظلَّ “الأستاذ” علي عثمان محمد طه يحارب “مَدَاخِل” بوسائله المعروفة من وراء حجاب.. فهو أكثر ما يخشى العلاقات المباشرة مع “الرئيس”، خاصة إذا كانت من قِبَل شخص من “دفعته”، مثل “الفاتح عِرْوَة”.. من جهة أخرى، اصطدمت رُؤى الترابي بنزوع نافع علي نافع الميَّال للمركزيَّة المطلقة، بخاصة في الأجهزة الأمنيَّة، وطبقاً لذلك اندلعت حربٌ ضروس، تفنن في أساليبها دكتور مُطرَف صِدِّيق، الذي يهوى التآمُر بالفطرة»[11].
«نمضي في صراع الكواليس بين القدامى والقادمين الجُدُد، فبدأت “مداخل” في تركيز الهجوم على الفاتح عروة – في محاولة لاغتيال شخصيَّته – عُبئ لها كافة ضُبَّاط جهاز ”مَدَاخِل“، إذ زَعَمَ “عِروَة” مرَّة أنهم حاولوا اغتياله بإرسال عُملائهم المهندسين، وعبثوا بكوابح ”فرامل“ طائرة كان يُزمِعُ قيادتها! ثمَّ امتدَّ هجومٍه بالغ الضراوة أيضاً على السعيِد عثمان محجوب، ثمَّ تطوَّرت الحرب إلى الصِّراع على ”المَصَادِر“، وكانت حرباً مكشوفة، لا أخلاق تحرسها ولا قِيَم تراعيها، ذلك لأن ضبَّاط ”الجهاز“ وضبَّاط ”مَدَاخِل“ كانوا ”رُفقاء سلاح“، أي أبناء ”كارٍ“ واحد حتى مجيء انقلاب الإنقاذ، وكذلك بعدها حتى انفصال الجهازين، أو بالأحرى قيام الجهاز الجديد، وتشاكسهما حول ”المصادر“ الحزبية والمخابرات التي تغذيهم بالمعلومات.. ثم تطوَّر الصِّراع إلى داخل السفارات بين ”القناصل“، وعناصر الأمن الشعبي من الدبلوماسيين، وهكذا دواليك»[12]!
لا بأس عندئذٍ بذكر الخواتيم، حتى لا نرهق القراء بما يُسمِّيه السُّودانيون في أحاجيهم وأمثالهم الشعبية “حجوة أم ضبينية”، وهي حجوة لا نعلم كنهها، غير أنها تشي بعدم جدوى المواضيع التي لا قرار لها.. فالذي نحن بصدده من هذه الشاكلة التي أرهقت السُّودان والسُّودانيين، وكلفتهم فوق طاقتهم. ويقيني لو أن أحد الإسلامويين صحا ضميره، وأدرك عمق الجريمة التي ارتكبتها عُصبته، وأدخلت بها السُّودان في نفقٍ ضيِّق، ولو أنه أدرك أنه لن يكون بمأمن عن موتٍ قادم يجرفه من الآخرين، ولو أنه أيقن أن البلد التي جعلوها مسرحاً لأطروحاتٍ بائسة يمكن أن تسعهم وتسع غيرهُم.. لو أن ذلك حدث، لما عاش الوطن السُّودان في خِضَمِّ محنة مُعقدة، ولما كانت في الأصل هذه المآلات البئيسة!
نصل للنقطة الأخيرة في سياق هذه التداعيات، وهي أن “مداخل” التي تمَّ تأسيسها في العام 1995، قام دكتور التُرابي بحلها بعد فشل محاولة اغتيال الرئيس المصري حُسني مبارك، بعدئذٍ تجمَّعت كل الأجهزة وبقاياها فيما سُمِّي بـ“جهاز الأمن الشعبي”، وهو محور بحثنا في هذا السَّرد التاريخي. فـ“جهاز الأمن الشعبي” – وفق ما ذكرنا في المقدِّمة – يُعد الجهاز الرسمي للحركة الإسلامويَّة، وهو صُنُو الجهاز الآخر والمُسمَّى “جهاز الأمن والمُخابرات الوطني”، لكنه يعلو عليه في تراتُبيَّة الدولة. ولكن على عكس ما توخى الدكتور التُرابي، فقد تقوَّى الجهاز الأخير هذا بواسطة مجموعة الجامعة التي سبق ذكرها، وأضعفت الجهاز الأوَّل، الذي كان يُسمَّى آنذاك “مداخل”، وتأجَّجت الحرب الخفيَّة بين الكيانين، تلك سمَّاها علي عُثمان محمَّد طه لخُلصائه المُقرَّبين: «أكبر فتنة في تاريخ الحركة الإسلاميَّة»!
نلتقط أنفاسنا هُنا لنقف مُتأمِّلين في سيرة اثنين يُعَدَّان من أهمِّ الكوادر الأمنيَّة، ثانيهما ستطول معه رحلتنا كما ذكرنا، بعد أن نكشف النقاب لأوَّل مرَّة عن ترؤسه حالياً “جهاز الأمن الشعبي”، محور هذا الكتاب، وهو “المهندس عماد الدين حسين”. أما الأوَّل فهو “الصافي نورالدين”، الذي كان أوَّل من تسنَّم مسئوليَّات أمنيَّة وهو في معسكرات الحركة الوطنيَّة في الصحراء الليبيَّة، وهو من الذين حذقوا العمل الأمني والعسكري في تلك المُعسكرات، وتواصلت رحلته الأمنيَّة مع التنظيم، حيث كانت له بصماته الواضحة في كل الفروع الأمنيَّة التي طفنا عليها آنفاً في التنظيم، الذي يهوي الأمن ورواياته. وفي خواتيم رحلته الأمنيَّة، أصبح الصافي نور الدين رئيساً لـ“جهاز الأمن الشعبي” قبل “المُفاصلة”، و“حامل أسرار التنظيم” منفياً، إذ اختفى فجأة، بل الأصح أنه فرَّ بجلده خارج البلد، وعاد مطلع هذا العام 2015!
كان الصافي نورالدين قد لعب دوراً كبيراً في يوم الانقلاب، حيث كان مسئولاً عن الأفراد المدنيين الثلاثمائة، الذين اختارهم للمشاركة في ليلة التنفيذ، وسبق أن أجرى لهم “بروفات” انقلابيَّة، مثلما ذكرنا من قبل. وهُو من المُؤسِّسين لمكتب المعلومات، ومن ثمَّ “مركز الدراسات الاستراتيجية”. ثمَّ حينما تولى مسئوليَّة الأمن الشعبي، قام بأدوار كثيفة تحت رئاسته، خاصة على المستوى الخارجي. ساهم في تأسيس “حركات تنظيمية إسلامويَّة” في كثير من الدول، وكان التنظيم داعماً لها. أثناء توليه مسئولية تلك المرحلة، كانت له شركة أمنيَّة خاصة اسمها “منواشي”، نسبة لمسقط رأسه بجنوب دارفور، وتعمل في المجال الهندسي. عند حدوث “المُفاصلة”، اتّخذ الصافي نورالدين جانب الدكتور التُرابي، الأمر الذي أوقعه في حربٍ مع الجناح الثاني، نسبة لامتلاكه معلوماتٍ ضخمة، فاضطرَّ لتصفية الشركة، واعتُقِلَ كثيراً وعلى فترات. وعندما اشتدَّ عليه الحصار، غادر إلى كينيا، ربَّما خشية على نفسه من فعلٍ يتجاوز الاعتقالات!
عاد الصافي نورالدين إلى الخُرطوم في 7 فبراير 2015، وقيل بسبب وفاة والده، وذلك بعد غيبة دامت أكثر من سِت سنوات، وصرَّح بعد شهور من وصوله لصحيفة محليَّة قائلاً إنه «لا يحمل حقداً علي أحد»، وأشار في احتفالٍ أُعِدَّ في منزله بالثورة إلى أن: «اختلاف الرَّأي لا يُفسِد للود قضيَّة». وقال إن: «الرئيس البشير كان يستمع إلى رسائلي، ويرد عليها رغم مشغولياته». وأن: «الحاج آدم وحسبو عبدالرحمن كانا يزورانني في نيروبي»، وأن: «وزير الخارجيَّة علي كرتي – رغم اختلاف الرأي والمواقف – كان قد أوفى الأخوَّة التي امتدَّت لأكثر من 35 عاماً، يرعى أبنائي ويقف معهم، ولم ينس العُشرة رغم اختلاف الرأي والمواقف»، ودعا خلال حديثه إلى: «لمِّ الشمل لمواجهة التحديات التي تواجه السودان»[13]! وهكذا هُم الإسلامويون، يَفجُرُون في الخُصُومة، ثمَّ يُقبل بعضُهُم على بعضٍ يتلاومون، ثمَّ في استخفافٍ بالعُقول يقولون: إن اختلاف الرأي لا يُفسِد للوُدِّ قضيَّة!
أما النموذج الثاني، فهو “المهندس عماد الدين حسين أحمد”، ولسوف نسلِّط عليه الأضواء أكثر باعتباره رئيس “جهاز الأمن الشعبي” حالياً، تلك الوظيفة التي أمطنا عنها اللثام للمرَّة الأولى، ذلك لأن الرأي العام السُّوداني كان يعرف عماد الدين حسين في موقع الرئيس التنفيذي لشركة “سوداتل” للاتصالات، وهي وظيفة لا تتماهى مع مهنته بالطبع.. ثمَّ إذا طالعت موقع الحركة الإسلامويَّة الالكتروني، ستجد أن له وظيفة أخرى من شقين: الأولى، تنسجم مع توجُّهات التنظيم العقدي.. والثانية، تتسق مع وظيفة “بيت العنكبوت”.. فهُو “أمين الدعوة والمعلومات” في الحركة الإسلامويَّة.. استقال المهندس عماد الدين حسين من شركة “سوداتل” للاتصالات في الأوَّل من أغسطس عام 2012، وذلك في أعقاب عاصفةٍ من الاتهامات بالفساد، هذه شذراتٍ منها..
قال السيِّد أمين سيد أحمد حسن، الخبير في تحليل القوائم الماليَّة والمصرفيَّة وأحد مساهمي شركة “سوداتل”، في مذكرة مفتوحة من عشر صفحات بتاريخ 19/5/2011، ذكر فيها التجاوُزات التي حدثت في الشركة، وبأرقام يشيب لها الولدان، لشركة تجلس آنذاك على أموالٍ طائلة بلغت نحو 2,35 مليار دولار. وكشف عن وجود أسماء في الإدارة التنفيذيَّة العُليا لأناسٍ استقالوا من الشركة، كمدير الإدارة الماليَّة بالمجموعة مثلاً.. كما كشف أيضاً عن تلاعُبٍ في المكافآت الخاصَّة بمجلس الإدارة والموظفين، وضرب مثلاً: «إن المكافآت والحوافز لمجلس إدارة الشركة والموظفين بلغت 24,4 مليون دولار، في حين عقد مجلس الإدارة (8) اجتماعات خلال عام 2010، وعقدت اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى (12) اجتماع. وكان بدل حضور الاجتماع لكُلِّ عضو ألفين دولار عن كل اجتماع»[14].
وقال: «لقد أصبح خرق القوانين واللوائح والاستخفاف بنا كمساهمين عادياً عند إدارة سوداتل، ولعل المساهمين يذكرون أن إجراءات بيع موبيتيل لم تتضمن دعوة أو أخذ موافقة الجمعية غير العادية للشركة 2006 مما يعد مخالفة صريحة لعقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات السوداني».. وأضاف منتقداً التقرير في ذاك العام: «كما لاحظت الزج ببند فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية (20 مليون دولار أمريكي) ضمن قائمة المصروفات الإدارية والعمومية في الإيضاح رقم (22) في صفحة (94) ويعتبر هذا مخالفة صريحة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها».
كل كلمة في ذاك التقرير كانت تنعي الأمانة وتكشف عن الكيفيَّة التي يتم بها سرقة أموال الشعب السُّوداني بالتحايُل بطُرُقٍ عديدة، ولهذا لم يكن مسموحاً لكاتب المذكرة من أن يُدلي بآرائه الجريئة في الاجتماعات السنويَّة، إذ حكا عن تجربته الشخصيَّة في تجاوُزه الدائم وعدم الاستماع لآرائه الناقدة في اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة، للدرجة التي لم يُمنح فيها سوى فُرصتين على مدى عشر سنوات، الأمر الذي دعاه للجوء إلى الصُّحُف لعلَّ ما يريد أن يقوله يصل للرأي العام أو الضمير الغائب في محن أهل السُّودان.
تلك إمبراطوريَّة كان يجلس على تلِّها المُهندس “عِمَاد الدين حسين”، ولمزيدٍ من الدهشة التي تعقد فيها الحاجبان، كانت قد رَشَحَت همساً فضائح شركاء الخفاء، وهُم: “عبدالعزيز عُثمان”، “عبدالباسط حمزة”، “عبدالله حسن أحمد البشير” (شقيق الرئيس الضَّرورة)، وهي المنظومة التي أُطلق عليها “فساد المافيا الثلاثيَّة”.. وما خَفِي كان أفضح!
34 “الحركة الإسلاميَّة السودانيَّة.. دائرة الضوء خيوط الظلام” – ص 32.
36 باستثناء الشريف حسين الهندي، الذي استمرَّ معارضاً تحت لافتة الحزب الاتحادي الديمُقراطي، ووافته المنيَّة العام 1982 بالعاصمة اليونانيَّة أثينا.
37 “الخندق” مصدر سابق – ص 114.
38 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 115.
39 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 116.
40 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 117.
41 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 118.
42 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 119.
43 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 119.
44 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 120.
45 “الخندق” – المصدر السابق نفسه – ص 120.
46 صحيفة ‘التيَّار’ بتاريخ 5/5/2015.
47 المذكرة الكاملة بحوزة المُؤلف، ونُشِرَت لمُقتطفاتٍ منها في صحيفة ‘الأحداث’ بتاريخ 25/5/2012.




