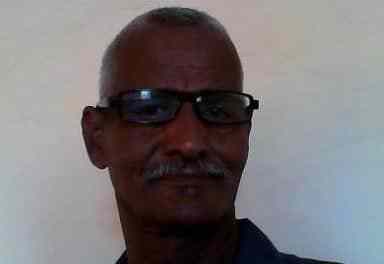الانتقال الديمقراطي وضرورة الاستثمار في رأس المال الاجتماعي عبر الحوار المستمر

د. بكري الجاك
بلادنا في حالة ثورة منذ زمن طويل، ثورة هنا بمعنى البحث عن مشروع وطني يمكّن كل السودانيين من إيجاد ذواتهم في الدولة التي تعبر عنهم وتعكس تنوعهم، وبرؤية تنموية تأخذ في الاعتبار مكوناتنا الثقافية كثروات، وتبني على خصوصياتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية برامج تجعلنا جزءاً فاعلاً في هذا العالم، بدلاً من أن نكون متفرجين عليه، أو محض أخبار عابرة حزينة في شاشاته على الدوام.
نحن في حالة حراك ثوري منذ عام 2018، ويمكن القول إننا في حالة تجريب مستمر للأدوات والوسائل التي تساعدنا على السير بشكل جماعي نحو الحرية والعدالة والمساواة. في تقديري، ما ظل يعيق قدرتنا على الدوام هو استثمارنا قصير المدى في العمل سوياً، وتعاطينا مع الانتقال الديمقراطي وكأنه حدث وليس عملية طويلة ومعقدة. وكما جادلت كثيراً من قبل، كتابة وحديثاً، أنه لن نتمكن من توطين الديمقراطية التي أصبحت ضرورة لوجود كيان الدولة وليس محض نظام حكم في بلادنا، ما لم نتمكن من بناء حلف استراتيجي للقوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لها مصالح مادية في توطين واستدامة الديمقراطي، هذه خلاصة معرفية لتجارب الانتقال الناجحة من منظور تحليل شامل، وقد فصّلت في أضلع هذا الحلف في مقالات نشرت في عدة وسائط.
يعتمد بناء هذا الحلف في الأساس على اتباع أسلوب الحوار الدائم والاستثمار في رأس المال الاجتماعي، عبر بناء الثقة بين أصحاب المصلحة في عملية الانتقال الديمقراطي، وخلق مناخ صحي لاستمرار الحوار من أجل تعريف وإعادة تعريف المصالح العامة والخاصة، الذي هو جوهر فكرة الممارسة السياسية، والذي يتطلب فهماً عميقاً ومنهجاً واستثماراً في حد ذاته. وسأحاول أن أطرح هنا منهجاً مغايراً في عجالة:
في عام 2017 نشر Adam Kahane آدم كاهاني كتاباً في غاية الأهمية لعصرنا هذا تحت اسم Collaborating with the Enemy: How to Work with People You Don’t Agree with or Like or Trust وهو ما يمكن ترجمته بـ “التعاون مع العدو: كيف تعمل مع أناس لا تتفق معهم ولا تحبهم ولا تثق بهم”. بشكل عام، حاول كاهاني في كتابه مساءلة فرضيتين شائعتين في مجالات علم التفاوض وإدارة المنظمات وصناعة القرارات العامة:
الفرضية الأولى: أن هنالك دوائر من النخب تقوم بتعريف الأشياء وصناعة المعاني وتشكيل الرأي العام حول ماهية العالم، وكيف يعمل هذا العالم.
الفرضية الثانية: هي أنه بإمكاننا أن ننتهج مبدأ حل المشكلات في استشرافنا للمستقبل بالتوافق على رؤية مشتركة وأهداف معرّفة ومحددة، ومن ثم السير في طريق واضح فيه محطات لقياس مدى تحقيق الأهداف، ومدى اقترابنا من الوصول إلى النتائج المرجوة.
ولمزيد من التوضيح، فإن كاهاني لم يقل إن ما يعرف بالأسلوب العقلاني لحل المشكلات واتخاذ القرارات Rational Decision Making Approach غير مفيد أو غير فعّال، بل جوهر حجة كاهاني أن تعقيدات العالم المعاصر (المتمثلة في عدم المساواة والتفاوتات الكبيرة في مستويات الدخول والتنافس الحاد على الموارد، في ظل تحديات بيئية وتغير مناخي، وأخيراً طامة صناعة الحقائق البديلة)، خلقت ما يمكن أن يطلق عليه عالم ما بعد الحقيقة. هذا الواقع يجعل المدخل العقلاني والموضوعي غير كاف لوحده للتعاطي مع أطراف متصارعة ومتنافسة، وفي غالب الظن غير موضوعية وغير عقلانية بفعل التحولات الكبرى التي يشهدها عصرنا.
مقترح كاهاني للتعاطي مع هذا القصور أتى في تصور متكامل أطلق عليه Stretch Collaboration أو ما يمكن أن يترجم اصطلاحاً بـ (التعاون الممتد أو المستمر)، لهذا الشكل من التعاون ثلاثة مبادئ وأعمدة فلسفية:
أولاً: يجب أن نؤكد على شرعية وقيمة أي موقف وأحقية المتبنين له والمدافعين عنه، فالإيمان حقاً بمثل هذا المبدأ يجعلنا نوقن أن هنالك أكثر من تصور وفهم للعالم، ويجب أن تؤخذ هذه التصورات في الاعتبار. هذا القول أقرب إلى مقولة شهيرة لـ Neils Bohr “ for every great idea, the opposite is also true” نيل بوهر: “إن لكل فكرة عظيمة مقابل مضاد عظيم أيضاً”.
ثانياً: الطريق نحو المستقبل بواسطة تعلم المختلفين سوياً عبر التجريب المستمر، وهنا يجب أن نتناسى فكرة التفاوض للوصول إلى حد أعلى أو أدنى، ونعترف أن لكل منا فكرة، وعبر التجريب المستمر فقط، يمكننا أن نخلص سوياً في تعلمنا إلى حقيقة مفادها “أي فكرة أو أفكار تقارب الواقع ويمكن أن تحدث فارقاً”.
ثالثاً: علينا أن نكون في حالة انتباه دائم لضمائرنا وضمائر الناس من حولنا، تماهي وانسجام الإنسان مع ضميره يعطيه فرصة للحضور في العالم بشكل مغاير، ويمكننا من ملاحظة ماذا يحث من حولنا بدلاً من الإصرار على التأثير فيه.
الآن القوى الثورية في السودان تكاد تعيش حالة أقرب إلى التشكيك الدائم في بعضها البعض، وأغلب الحوارات تدور حول تصورات هذه القوى من منطلقات أخلاقية وليس من حيث المحتوى. بل يتم إصدار حكم قيمي على تصورات كل طرف للآخر، وينتقل التقييم إلى النوايا والضمائر، وتصبح عملية الحوار شبه مستحيلة، وإن تمت فهي عبثية.
ما يحدث في الوسائط أقرب إلى الصراخ في وجه بعضنا البعض بدلاً من أن نسمع بعضنا البعض، فجميعنا نتكلم في نفس الوقت، أو سمه (شجاراً) بكل ما تيسر، يصر فيه كل طرف بشكل جازم على أن لوحه يحمل الفهم السديد والصوابية الأخلاقية، ولا يعطي حتى فرصة للتدبر والقبول و الاحترام.
عليه، يمكننا القول، إن بعض هذه القوى بدأت ترى الآخر الثوري كعدو أكثر من العدو المعلن الذي يقتل ويسجن كليهما. ويمكن القول أيضاً، إنهم لا يستسيغون بعضهم البعض بشكل عام، والمؤكد أنهم لا يثقون في بعضهم البعض، وهذا ما يجعل تصور كاهاني مفيداً في حالتنا الراهنة. حاولنا تطبيق هذا المنهج في عملية الحوار التي تمت في الدوحة، على أمل أن يجد المشاركون الفرصة في الاستكشاف سوياً، وتعريف المشكلة، وتلمس سبل الخروج.
خلاصة القول:
إن الثورة السودانية ظلت تفعل ذلك بشكل شبه لولبي وعبثي أحياناً، التجريب ثم التعلم ثم التطوير. ما نحن في حاجة إليه الآن هو وضع ركائز وبناء لهذه العملية وتأطيرها لحوار مستمر يبنى على الأسس الثلاثة الواردة عن كاهاني. وإن كانت هنالك كتابات في مدراس أخرى للتفاوض وفصل النزاعات تتبنى مناهج تشابه كثيراً هذه الأسس بمسميات مغايرة. ما نحتاجه حقاً هو الاستثمار في رأس المال الاجتماعي، وبناء الثقة لخلق هذا الحلف الاستراتيجي، وبناءه على المصالح المادية لتوطين الديمقراطية، وهذا لا يتم بالكتابة فقط، بل بالعمل الدؤوب، وها نحن قد بدأنا، والباب مفتوح للجميع للإسهام.
الديمقراطي