
إن النفس البشرية تواقة بطبعها لمعرفة ما يكتنف العالم الآخر من غموض ، ذلك العالم الذي إذا كسبه المرء كسب جل ما يتطلع إليه ، وإذا خسره خسر ما لا عوض له فيه ، نعم إن الناس باختلاف مشاربهم وسحناتهم تغلغلت هذه المسألة في أصولهم وشغلت بالهم وتفكيرهم ، ويجدون في سباتهم العميق ليلاً أو نهارا ملتمساً لما يصعب تداركه في اليقظة ، فكثيراً ما تسمع ممن شابت ناصيته في العلم ، أو الجاهل المطبق الجهالة أن حلماً داهمه عند الكرى ومضى به بعيداً عن عالمنا الذي ضنك عيشه ، وكثر طيشه وأضحى يحكمه ذئاب غاية في الظلم والاستبداد ، ويخبرك أن روحه فارقت ذلك الجسد الوثيق الذي تقبع خلفه ومضت تحلق في عوالم موشاه بالحسن ، ومرصعة بالدر ، ويعكر صفوك بذكر كل شاردة واردة تمثلها في حلمه ، فتراه يستفيض في ذكر الملائكة والجنان ، ويوجز عند الزبانية والنيران ، ويعتريني يقين جازم بأن كل من بسط لسانه بالمعروف أو طوى قلبه بالضغينة شكّل له أمر الموت ، والحساب والانتقال من هذا العالم الفاني إلي عالم سرمدي يوفى فيه أجره هاجساً يؤرق مضجعه ويجعل الذعر والوجل يسري في عروقه ، لمعرفة ما هو المصير الذي ينتظره في ذلك العالم ، أيزحزح عن النار ويدخل الجنة ، أم هي الأخرى التي تصطك من هولها الركب ، ويزلزل روعها الأقدام ، والنزوع إلي الآخرة ليس قاصراً على شعب دون شعب ، أو على عرق دون عرق ، فرحلة الروح من أهم السمات المشتركة لكل الأمم والشعوب لأنهم يستمدونها من تراثهم الديني ويجترونها من أدبهم الاجتماعي ، “فالمصريون القدماء قد عرفوا هذه الرحلة ، ونسج لهم الخيال كثيراً من الرؤى والصور التي تدور حول الجحيم والفردوس، فتصور اوزيريس يزن الأعمال، فيدفع بقلوب الخطاة إلي الوحش الذي يفترسها ، ويعطي المحسنين حقول القمح يزرعونها بلا عناء ، ولدى الفرس نجد الإنسان ميدان معركة بين اهورا مزدا اله الخير واهريمن ملك الظلمات والعالم السفلى ، ونجد القديس الزرادشتى ارتاك فيراز يقص على قومه ما رآه في رحلته إلي العالم الآخر من ألوان العقاب وصنوف النعيم. وفي الأدب اليوناني يذكر هوميروس في الإلياذة عالم الموتى والشياطين ونار الجحيم وأبواب السماء ونعيم الفردوس ، أما فرجيل شاعر اللاتين فيذكر في الاينيادة هبوط اينياس إلى العالم السفلى ويصف ما شهده في مدينة الجحيم ((ديس)) من وحوش خرافية وشياطين وأنهار وعواصف ، ويسرد أنواع الآثمين كمرتكبي خطايا الجسد والبخلاء والذين حاربوا أولياء نعمتهم ، ثم ينتقل إلي أرض خضراء سعيدة ، وهي موئل من جرحوا في سبيل أوطانهم ومكان الرهبان من الصادقين”. فضلاً عن الأديان السماوية الثلاث التي جددت دارس العهد من القيم ونشرت البالي من الشيم التي تمنع اختلال التوازن ، واضطراب الحياة ، فمن تنغمس يداه في منكر نالته شهب النار ، ومن لا يقبض يده عن بذل المعروف ، أو يصد نفسه عن قعقعة السيوف أسكنه الله أقبية الديباج المخوص بالذهب والنضار ، وأجرى تحت رجليه شلالات الأنهار.
والحقيقة التي يجب أن نبسطها هنا أن هذه المنظومة قد حذت حذو العديد من الأعمال الأدبية التي سبقتها في الأدب الفارسي ونجد أن الباحثون الأوربيون في الدراسات الإيرانية “قد اتفقوا على أن رائد هذا الموضوع في ايران هو (ارتاك فيراز نامك) المكتوب بالفارسية الوسطى ، أي كتاب القديس فيراز-ارتاك تعني القديس أو المتمسك بأهداب الدين الصحيح- ويرون أنه يمثل الهيكل الأساسي لعدد من الآثار الأدبية التي تنوعت في طريقة تناولها للموضوع ، كما في سير العباد لسنائي ، ومنطق الطير للعطار ، ومصباح الأرواح للكرماني وأخيراً سبعة الأودية لبهاء الله”.
وحتماً هذا الكتاب في مضمونه ومحتواه يذكرنا برائعة دانتي الكوميديا الإلهية ، ذلك الكتاب الذي دلق فيه الكثير من المداد ، وأنشئت حوله الرسائل والدراسات ، ونضحت باسمه الشروح والدراسات، التي أجلت عنه الغموض ، وقربته إلى الأذهان ، ولكن ما لا يند عن ذهن أو يغيب عن خاطر أن هذا العمل الأدبي رغم ما ناله من شهرة وصيت إلا أن الشعور الذي يخامر قارئه لذلك النص هو الضجر والرتابة بعد ازدراد أسطره وطي قراطيسه. ودانتي الإيطالي الذي ألهمت قريحته الفياضة وعبقريته الفذة رصفائه من الأدباء ، وأيقظ مدّ أفكاره الهادر روافد العبقرية التي كانت كالنبت الذابل الذي غاية أمانيه العجاف وابل من قطر يجدد ما ذوي من أوراقه. ولكن الحقيقة التي لا يغالي فيها أحد ونتيجة لدراسات وأبحاث متعددة أن دانتي لم يكن هذا العمل من بنات أفكاره أو بتعبير آخر أن دانتي لم يكن له قصب السبق في الإيتاء بهذا اللون من الأدب ، نعم لم يكن دانتي “ في عمله العظيم مبتكراً تماماً ، وإنما اقتبس خطة كتابه من غيره ، وأفاد في جزئيات كثيرة منه من جهود سابقة بعضها شرقي اسلامي ، فلقد كتب ارنولد نيلكسون المستشرق الإنجليزي سنة 1943م مقالاً بمجلة الجمعية الملكية بعنوان (رائد فارسي لدانته) يقول فيه : ”أن سننائي الغزنوي يحكي في منظومته المسماة (سير العباد إلي الميعاد) مثل دانتي تماماً كيف وجد في الظلمة التي ضل طريقه فيها مرشداً صحبه عبر طرقات الخوف والفزع التي كان عليه أن يقطعها قبل أن يصل إلي غايته. ويضيف : ان من الصعب أن يقرأ الإنسان هذه المنظومة الفارسية دون أن يتذكر بشدة المنظومة الإيطالية، فالتشابه بينهما لا يمكن أن يكون عرضياً ، حيث توجد تفصيلات تبعث على الدهشة وحب الاستطلاع ، وتدل على أن هناك مصدراً مشتركاً للشاعرين ، أو تؤكد الفكرة السائدة من أن دانتي استعان في كتابته لمنظومته بمادة موجودة في الروايات الإسلامية، أيا كانت القنوات التي تم عن طريقها وصول هذه المادة إليه”.
لقد صدق نيكسون في مزاعمه فان العملين يخرجان من مشكاة واحدة ، تحتويها الأفئدة ، وتضمها الأرواح ، مشكاة يتزاحم عشاقها على موردها العذب ، ويتسابقون إلي ضيها الملهم ، لقد بذر نيلكسون بذور الشك في أحقية تفرد دانتي بهذا العمل ، واستقرت تلك البذور في دخائل كل نفس ، ومدارج كل حس يطالع رائعة دانتي ، رغم أن هذا الشك ليس له ما يبرره ، وتقاطرت جهود الأدباء كوكف المطر لإماطة اللثام عن هذه القضية التي اشتد حولها الصيال الأدبي الذي لم يدفع إلا بعد نضال عنيف وجهد وتقصي استمر عبر حقب طوال إلي أن بزغ نجم المستشرقان سنديو الإسباني وشيرولي الإيطالي ، الذين بددا الغموض الذي يكتنف هذه القضية ، وأزالا مواطن اللبس فيها ، فلقد تكفلا بالإجابة “على السؤال الحائر الذي كان يطرحه الباحثون وهو : ((من أين لدانتي بالمصادر الإسلامية يطلع عليها ويتأثر بها إذا كان لم يعرف عنه أنه كان يعرف العربية؟ حيث اكتشفا مصدر دانتي في مخطوطة أصلها عربي وموضوعها معراج الرسول صلي الله عليه وسلم ترجمت إلي الإسبانية واللاتينية والفرنسية في أواخر القرن الثالث عشر ، أي في حياة دانتي”.
ومن الكتب أو الرسائل التي جاءت على هيئة أو منظومة سير العباد رسالة حي بن يقظان لابن سينا التي جرى فيها على هدي دانتي في الكوميديا الألهية حيث أدخل موضوع الرحلة نحو الهدف الأعلى الذي تبغتيه كل نفس عبر طريق مرشد ، الأمر الذي أثرى الملحمة الصوفية الشعرية في الأدب الفارسي، فنجد أن سناء الغزنوي استن بمذهب ابن سينا ولزم غرسه في منظومته ، ونحن إذا اردنا أن نفصح عن كنه تلك الرسالة التي تأثر بها سناء الغزنوي في ايجاز لذكرنا أنها رسالة رمزية في مضمونها نظمها ابن سينا على طريقة الصوفية وعنونها وأسماها بعنوان”حي بن يقظان” وموضوعها يدور حول شيخ من أهل البيت المقدس اسمه حي بن يقظان أي حي العقال الذي يوصل إلي الله فلقد أخذ حي بوصية والده يقظان وأضحى يتجول في المدن بعد أن أعطاه والده مفاتيح العلوم كلها ، وابن سينا رمى من نسجه لتلك القصة وتنضيده لتلك الرسالة أن يزكي من العقل الذي يلهم صاحبه ويعلي من شأن المنطق والفلسفة.
وبعده بقرن من الزمان يخرج الشاعر الفارسي سننائي الغزنوي (525 -1131م) منظومته (سير العباد إلي الميعاد) متخذا نفس الأسلوب الرمزي ذا الطابع الصوفي “يصور فيها الفكرة الفلسفية التي تقول أن الكائنات في حركة دائبة نحو اتجاهين: فهي تجئ من الله ، من فيضه على العقل الكلي ، ومن العقل الكلي على النفس الكلية ، ومن النفس الكلية على الهيولي ، وهي الصورة التي ترى الأنفس الجزئية في عالم الأجسام على ظواهر الأشخاص والإجرام ، ثم تعود من جديد إليه متحررة من الكثرة صاعدة نحو الوحدة لتلحق بموطنها الأصلي ومصدرها الأول، وهذا الرجوع يتم عن طريق المعرفة ، وهذا الهدف الحقيقي من الحكمة والفلسفة إذا عرفنا أن لكل موجود كمالاً وكمال النفوس في اتصالها بالعقل”.
والبناء الأساسي لتلك المنظومة يقوم على فكرة الهبوط والنزول من الجنان التي خلع الله عليها وضاءة الحسن ورونق الحسن إلي الأرض التي أدخر فيها الخلق عزوجل كل ما يحتاجه ذلك الإنسان الذي أقصاه عن جنته بمقتضى الأمر الإلهي (كن) فنزلت تلك النفس خاشعة الطرف ، كاسفة البال ، من علياء السماوات الي أرض غائرة ممعنة في الضحالة بناء على قوله تعالى: (اهبطوا منها) بعد ذلك تلقفتها امرأة عجوز قديمة قدم الفلك تعهدت تلك النفس بالعناية وأحاطتها بالرعاية ، هذه المرأة في واقع الأمر والدة مشبلة لمواليد ثلاث ولا وعي لها بالشمس ولا بالظل ، وقد تفانت في تربية جسد آدم كما تعهدت برعاية كل كائن ، ويمضى سناء الغزنوي في منظومته فيقول أن النفس” استقبلت بواسطة هذه المربية -التي يعني بها الأرض- والتي ربتها بحنان وصنعت لها أكسية مختلفة الألوان ، اشارة إلي تطور الخلق ابتداء من النفس النباتية ، التي يرمز إليها باللون الأخضر ، إلي النفس الحيوانية المتصلة بالجسد ، وتلك يرمز لها باللونين الأحمر والأبيض ، بناء على التحول من دم إلي نطفة إلي علقة إلي عظام كسيت لحما”.
ثم تتوالى أحداث المنظومة التي أدخل فيها سننائي الغزنوي القدر الهائل من التراث الصوفي، وأضحى النواة التي انطلقت منها العديد من قرائح شعراء الفرس الذين أمسوا كِلاً وعيالاً عليه ، ولكن من المآخذ على سنائي في منظومته البلبلة في الأفكار ، وكثرة التكرار التي توقع القارئ في الحيرة والاضطراب ، وتجعله يكاد يجزم أن المنظومة مبعثرة من غير رابط ، ومشتتة من غير جامع ، الأمر الذي يقلل من قيمة وشأن العمل الأدبي وإلقائه في غياهب النسيان ، وهذا هو الواقع الذي آلت إليه تلك المنظومة ، فرغم تهافت الباحثون عليها وتسبيحهم بحمدها في مقالاتهم التي سارت في كل صقع وواد إلا أنهم لا يصبرون على مضّ شدائدها فالمبهمات والرموز التي تعج بها تلك المنظومة تجعل الباحث يستشعر وطأة الجمود وفداحة الثقل فيلقيه عن كاهله في تبرم ويمم شطره تجاه بحث آخر خالي من التعقيد والمعاضلة والالتواء ، وهذا ما عناه مؤلفها حينما خلع على قارئها صفة الشاعرية ، ونعت من يفكك طلاسمها ، ويحيط بأسرارها بالساحر.
أهم الأفكار الأساسية للمنظومة:
1- سنائى الغزنوى في منظومته “سير العباد إلي الميعاد” طرح فكرة التطور “بكل ما تعنيه صعوبة التكمل والسعي إلي الكمال اللانهائي ، فيرى أن الإنسان يمثل قمة الخلق في هذا الكون ، فقبل أن يصل إلي الحالة الإنسانية ، كان جماداً ، ثم صار نباتاً وبعد ذلك أصبح حيواناً ، ليكون في النهاية انساناً مزوداً بالعقل. ويمكنه أيضاً أن يتجاوز المرتبة الإنسانية ، ليصير ملكاً ، كما يمكنه فوق ذلك أن يعبر المرحلة الملكية..
2- هذا التطور يرسم الغاية لكل الكائنات والمخلوقات ، ويحدد النفس الإنسانية هدفها في هذه الحياة ، وهو التعرف على الله ، ومسيرتها بالرجوع إلي أصلها ومنزلها الأبدي. وفي هذا التوقع يعتبر الكون كله مجرد مرقاة في سلم يصعد به الإنسان نحو ربه ، وبعبارة أخرى يعتبر مجالاً لرحلة روحية يقوم بها من عالم التراب إلي أعلى عليين ، بحيث يكون ابتداء الرحلة من عالم جسمه نفسه ، الذي قد نسميه العالم الصغير ، فيتأمله ويمعن النظر في أمشاجه ، فيما يشبه التجول ، فيرى في هذه الطباع التي ركب منها ، من البرودة واليبوسة ، اللتين ترجعان إلى التراب ، والبرودة واللطافة اللتين تعودان إلي الماء ، والحرارة واللطافة ينتميان إلي الهواء ، ثم الحرارة واليبوسة ، وهما من النار. ويتأمل نتائج هذه العناصر في ذاته ، التي تظهر على شكل رذائل ، هي الشره والكبر ، والبخل والبغض والحسد ، والشهوة والغضب. وهكذا تكون العناصر ونتائجها عالماً مستقلاً ، ويمثل كل عنصر منها مرحلة أو منزلاً على طريق الرحلة الطويل”.
3- والنفس الإنسانية “بطبيعتها صالحة للقيام بهذه الرحلة ، فهذه النفس التي هي كمال الجسم لها قوتان ، يسميها بعض الفلاسفة وجهين ، أو نظرين، نظر إلي عالم الصورة ، أي العالم السفلي ، ونظر إلي عالم الملكوت ، أي العالم العلوي ، وهذه التي تنظر إلي العالم العلوي تسمى القوة العالمة ، وتلك التي تنظر إلي العالم العلوي تسمى العاملة ، ويستفيد الجسم من القوة العاملة التي تدبره ، كما أن القوة العاملة تستفيد من القوة العالمة التي تدبرها وتحركها ، وهذه الأخيرة تستفيد من العقل الفعال الذي يوجد فيما وراء العناصر الأربعة ، يدبرها ويحركها ، ويمضي التسلسل على هذا النحو إلي الأفلاك : كل يتأثر بما فوقه ويؤثر فيما تحته ، ابتداء من عقل فلك القمر ، إلي عقل فلك الأفلاك ، الذي يستفيد من العقل الكلي ويتأثر به ، وهذا العقل الكلي الذي يوجد في حوزته جميع المخلوقات، يستفيد من فيض واجب الوجود.
4- والعقل الكلي كوسيط بين الوحدة المطلقة والكثرة يمثل نقطة البداية والنهاية في آن واحد ، فمن هذا الموجود الأول الذي خلقه الله بلا واسطة ، خلقت النفس الكلية ، ثم تسلسلت عقول الكواكب ونفوسها ، كل فلك له عقل ونفس عن طريقهما تسري سلسلة الخلق إلي الفلك التالي ، حتى تأتي إلي فلك القمر ، ومن عقل هذا الأخير ونفسه خلقت العناصر الأربعة ، وتلك بدورها أدت إلي خلق المواليد الثلاثة كل منها في ثلاث درجات ، كامل وواسط وأسفل ، فآخر كمال للجماد هو أدنى مرتبة للنبات ، وآخر كمال للنبات هو أدنى مرتبة للحيوان ، وكمال الحيوانية هو أسفل درجات الإنسانية ، كما أن أعلى كمال للإنسانية هو أولى درجات الروحانية ، وأعلى درجات الروحانية يشارف حدود القدرة الإلهية وهذه لا نهاية لها ، وليس في وسع العقل أن يحيط بها”.
5- والتصوف كنظام يعمل على “تطهير النفس ، ووصل الإنسان بالألوهية له مظهره الأخلاقي ، ففي الحياة الروحية ليس الجانب الأخلاقي مفصولاً تماماً عن الجانب الصوفي ، كما قد يحاول بعض الناس أن يتصوروا كلا منهما على حدة، ومهما تك درجة التمييز بينهما فالذي لا شك فيه هو أن الجانب الأخلاقي هو المرحلة التمهيدية التي تؤدي إلي مرحلة التأمل والاستغراق التي تعتبر غالباً جوهر التجربة الصوفية …. وفي منظومة سير العباد، تمشي الأخلاق مع التصوف جنباً إلي جنب مع ، حتى تكاد تمثل مزيجاً متناسقاً من العناصر الأخلاقية والصوفية ، فالشاعر فيها قادراً دائماً على أن يبدأ أخلاقياً لينتهي صوفياً ، ثم يعود من جديد كما بدأ”.
6- والرحلة عند سنائي في جوهرها رحلة من الصورة إلي المعنى ، رحلة يتحقق بها الموت عن هذا العالم المادي ، بكل ما فيه، رحلة توقظ النيام ، حسب العبارة المشهورة التي يسندونها إلي علي بن أبي طالب رضى الله عنه: (الناس نيام فإذا ماتوا انتهوا) وعنده أن العقل مرشد جيد في هذه الرحلة ، ولكن إلي حدود ، حتى إذا ما بلغها ، فإن فضل الله هو الذي يقود السالك بعد ذلك إليه.
7- ونتيجة لما سبق فإن الإنسان لديه الإرادة الحرة للاختيار بين العقل والهوى ، مما يفرض عليه مسئولية كبيرة قوامها ألا بترك نفسه للهوى يستولى عليه ، ومن هنا يتحدد وضع سنائي إزاء هذه المشكلة التي يمكن وصفه بوضع وسط بين الجبر والاختيار فهو في الحقيقة ينظر إلى هذه المشكلة من خلال مذهبه العام الذي يقوم على الاعتقاد بأن الإنسان لديه الاستعداد لبلوغ قمة الكمال ، وفي هذا التصور يكون الجبر وسيلة للعلو والاختيار في نظر الصالحين ، ووسيلة انحطاط وتسفل في نظر الأشرار”.
خاتمة:
هذه هي أهم الأفكار والموضوعات التي تطرق لها سنائي الغزنوي في منظومته التي تأسى فيها بابن سيناء في رسالته حي بن يقظان ، واستضاء من نوره ، فلقد أخذ سنائي من ابن سينا فكره تصويره للعقل على هيئة شيخ تبدو عليه نضارة الشباب، ذلك الشيخ الصوفي الثائر الذي يهيب بمخاطبه أن يسارع إلي الخلاص ، ولا تعنيه الوسائل بقدر ما تعنيه الغاية ، ومنظومة سنائي الغزنوي التي تعتبر تحفة أدبية من حيث خصوبة الخيال وسطوته ، وتعدد الصور ، وقوة الإيحاء ، وبلاغة الشيبة الذي رغم دقته إلا أنه أمسى مألوفاً في أدبيات المتصوفة ، مثل تشبيهم للغضب بالسبع ، والشهوة بالبهيم ، هذه المنظومة التي رغم أنها تشيع بالحسن ، وتومض بالجمال ، إلا أنها مبهمة الألفاظ ، ملتوية الأشعار ، يحتاج قارئها إلي بوارق من الضياء حتى يدرك كنهها ، ويحيط بتفاصيلها ، ولن يتسنى له ذلك إلا إذا تحلى بالصبر واستظل تحت أفيائه.
هذه الدراسة استندت على عدة مراجع .


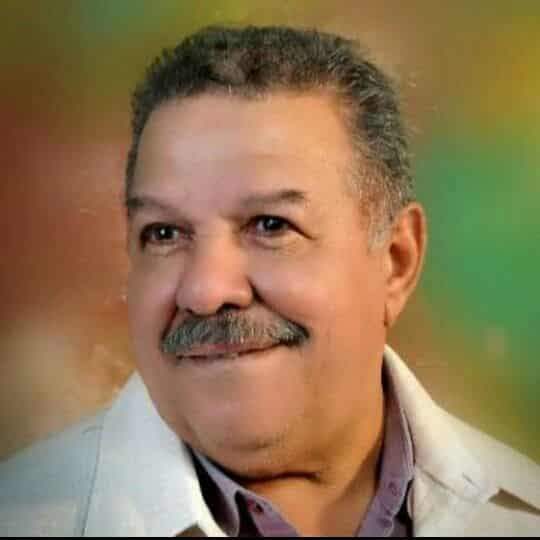


لا قريت كتاب سنائى ،
ولا مر عليك ،
تنقل بس !!!
تدليس عجيب .
طالما هي دراسة بمراجعها وجب تصحيح اللغة والإنشاء فيها:
أولا
(ونجد أن الباحثون الأوربيون) < أن الباحثين يا شيخ!!
ثانيا
(إلي أن بزغ نجم المستشرقان سنديو الإسباني وشيرولي الإيطالي)؟؟ < نجم المستشرقين الاثنين يا شييبخ!!
ثالثا
(أو بتعبير آخر أن دانتي لم يكن له قصب السبق في الإيتاء بهذا اللون من الأدب ، نعم لم يكن دانتي “)؟؟؟ الإتيان يا ش الإيتاء هو الإعطاء يا شييخ ودا حاجة تانية خالص
رابعا
(فرغم تهافت الباحثون عليها وتسبيحهم بحمدها) يا شيخ! تهافت الباحثين مضاف لأن المضاف إليه هو صفة التهافت وليس فعل تهافت يتهافت الباحثون!؟
خامسا
(هذه المرأة في واقع الأمر والدة مشبلة لمواليد ثلاث) ؟؟ هل المواليد إناث؟؟
وإلا فالصحيح مواليد ثلاثة ياشيخ!
سادسا
(فضلاً عن الأديان السماوية الثلاث)<الثلاثة
وبعدين يا شييبخ طالما الموضوع دراسة لماذا لا تكتب في خلاصتها رايك أنت؟؟
تحيه إلى شوبنهور ،
كاتب المقال ” فارغات ” ينقل بس !
وما ينقله فى مقالاته عن مصادر معروفه ،
صحيح عموماً من ناحية الأسلوب واللغه ،
أما ما يضيفه للمقال ” من عِنْدِياته ” ،
فهو مزيج من آلأخطاء اللغويه والنحوية
ومن ركاكة الأسلوب ، وفساد الذوق ،
وهو لا يعرف الصحيح من الخطأ ،
ويسعى للترويج لنفسه عن طريق التدليس ،
ينقل بس ، ولا يهمه شيئ !!!
😎 الإسلام دين تنعدم فيه الروحانيات لذا نشأت حوجة عند المسلمين الطقوسيين لإيجاد طريقة للهروب من الطقوس و النصوص
الصوفية والتصوف
عبدالمنعم عبدالعظبم
الصوفية والتصوف
رحلة فى طريق الحب
كتب عبدالمنعم عبدالعظيم
يعتبر التصوف علامة بارزة فى الفكر الإسلامي حيث ازدهر فى معظم البلاد الاسلامية واصبح للطرق الصوفية كيان ومريدين وتنظيمات واتسعت من بلاد الريف فى المغرب الى سهول الهند والفلبين والملايو وفى قلب افريقيا والجزائر
فالتصوف الإسلامي لا يخلق مجتمعا مغلقا بل نجح فى خلق علاقه بالناس قوامها الدعوة الى الله والسعى الى الرزق
وقد تمكن التصوف من الانتشار فى العالم الإسلامي ونافس فقهائه شيوخ الدين الرسميين ذلك ان غاية التصوف صفاء النفس وهداية الضالين واعادتهم الى الحضرة الالهية التى تتسع لكل شىء
واتخذ الصوفية من القص السهل البسيط اسلوبا لجذب الاتباع ومن حلقات الذكر التى تجمع الذاكرون لتلاوة القران ثم يرددون اسم الله منغما ولسماع للموسيقى الروحية ودخل الغناء فى قلب التصوف وقد كانت رابعة العدوية مغنية وفى قصائدها رنة الغناء العربى
ومع الغناء والموسيقى يشطح الصوفيين حين يطربهم السماع فيتمايلون ويتراقصون وجدا وابتكروا ما يعرف بالرقص الصوفى الذى يهز اوتار قلوبهم وينسيهم متاعب الحياة
ان التصوف فى جوهره حال او تجربة روحية خاصة يقول الامام الغزالى ان العلم وحده لا يجعل من العالم صوفيا ولكى يتذوق مذاق القوم لابد ان بسلك طريق القوم ويجاهد مجاهداتهم
وكون التصوف تجربة روحية اته شيء مختلف كل الاختلاف عن العلم الدينى والفلسفة الاسلامية فهو وليد العمل والمجاهدة النفسية والسلوك المرسوم
تعريف التصوف
الصوفية والتصوف من الكلمات المستحدثة فى الديانة الإسلامية وان البغداديون هم الذين استحدثوها ولم يكن لقب الصوفى معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لقبوا بالصحابة ثم التابعين وكان الزهد طابعا تطبعوا به وصفة اتصفوا بها
وظهرت الفرق الاسلامية وادعى اصحاب كل فرقة انهم على حق
يقول ماسينون فى دائرة المعارف الاسلامية ان التلقب بالصوفى ظهر مفردا فى النصف الثانى من الهجرة وسمى به جابر بن حيان صاحب الكيمياء وابو هاشم الكوفى اما كلمة صوفية فظهرت سنة 199 ه 814 م ظهرت فى الكوفة وكان عبدك الصوفى اخر أئمته
تضاربت الاقوال فى الاصل اللغوى لكلمة تصوف فقيل ان الكلمة من الصوف لياس الزهاد والانبياء او صفو من الصفاء او الى صفة المسجد فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والى رجل اسمه صوفة والى صوفيا اليونانية التى تعنى محبة الحكمة والراجح انه نسية الى الصوف
ويعرف ابوالحسن الشاذلى قطب الصوفية الكبير التصوف بانه تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية ومن صفات الصوفى عتده التخلق بأخلاق الله والمجاورة لأوامره وترك الانتصار للتفس وملازمة البساط بصدق البقاء مع الله
يمثِّل التصوُّف نزعة إنسانية، تعاقَب ظهورُها في حضاراتٍ مختلفة، بصور متفاوتة في التعبير عن شوق الرُّوح للتطهُّر والزُّهد فيما يتسابَق عليه الناس من خضرة ونضرة الدنيا، ورغبة في التعالي عن شهوات المادة، ونَبْذ حُطام اللذات؛ بُغية الارتقاء في سُلَّم الصفاء الرُّوحي، والتسامي في مراتب الكمال الخُلقي.
ولَم يكن المسلمون بِدْعًا في نزوع طائفة منهم – فُرادى وزَرافات – لنَبْذ زُخرف الدنيا، والسعي نحو زخرف الرُّوح، بيد أنَّ لكلٍّ خصائصَ تُميِّزه عنْ غيره مِن اختلاف وسائل، ومفارقة في الغايات، فيصير لكلِّ حضارة هُويَّتها في إبراز تلك النزعة الإنسانيَّة، بأن تَصبغَها بلغة ومُفردات وعقائد، تُناسِبُ نَسقها العام الديني والحضاري.
والتصوُّف حركة دينية انتشَرت في عهد الخلافة العباسية في القرن الثالث الهجري، كنزعات فردية تدعو إلى الزُّهد، وإن كان لها إرهاصاتٌ سابقة.
وبلغ عصر بني العباس مبلغُ الفتوة للحضارة الإسلاميَّة، وفيه بلَغت العلومُ شأوًا عظيمًا، وفُتحت أبوابُ الدنيا على المسلمين، ومن سنن الحضارات إن بَلَغت الترفَ المادي والعلمي أن تُولدَ الفلسفةُ في العلوم، وتُفقصَ الغرائب والطرائف في الفنون، فإذا فجَرَ العلماء، وفسَق القُرَّاء، وسفَك السلطانُ الدِّماء، وأخَذ على الحكم والحاجة الرِّشا، وافتَخَرت العامَّة بكسْب الحرام، ولَم يُغيِّر الخاصَّةُ مُنكرًا – صار المؤمن بين فارٍّ وصامتٍ، ومُتمنٍّ للموت أن يُدركَه قبل أن يُفتَن في دينه، وهذا الاتجاه يَنزع للزهد وكثرة العبادة، كردِّ فعلٍ مُضادٍّ للانغماس في الترف الحضاري، وأصحابه قد يكون بعضُهم ممن غرَف من الدنيا حدَّ التَّخَم، فعافها بعد أن كان لها سيِّدًا؛ كالملوك والأمراء، وكبار التجَّار والأثرياء، وآخرين سحَقتهم السنون حتى انقطعَ رجاؤهم من الدنيا، فأمَّلوا نصيبًا لهم في الدار الآخرة، وهذه طائفة عاملة ناصبة، لا تَألوا جهدًا في كد التعبُّد، وطول التهجُّد، ولا تَنوء بنكدِ العيش، ولا تملُّ قليلاً يقيم الصُّلبَ ليهبَّ.
وبواكير التصوُّف: التخوف وكثرة التعبُّد والتقشُّف، وزُهد في الدنيا ووَرَع في المباح، غير أنَّ ليس كلُّ زاهدٍ متصوِّفًا، ولا كل فقيرٍ يُسمى صوفيًّا.
وبدايات ظاهرة التصوُّف تكون فردية، ثم يتحلَّق من حولها الناس؛ لتنموَ كمًّا وكيفًا، إحصاءً وتحصيلاً، وهذه سِمة كلِّ العلوم، تكون عمليَّة، ثم تصيرُ علميَّة، فيُنَظَّر لِما يتعارف عليه، ويُفصَّل المنهج، ثم تتطوَّر لتُصبح طُرقًا مميزةً معروفة باسم الصُّوفيَّة، ويتوخَّى المتصوفةُ تربيةَ النفس والسمو بها؛ بُغية الوصول إلى معرفة الله تعالى.
والمؤثِّر الرئيس الأول في بزوغ بذرة التصوُّف، هو الحياة الاجتماعية للفرد، فلازَم بروز نزعة التصوُّف الشعور بتغيُّر الأحوال وسَيْرها من سيِّئ إلى أسوَأ، والاستدلال بفساد الظاهر على فساد الباطن، والنكير على طلاق العلم للعمل، فكان الزُّهد والنسك والتعبُّد – وهي من أساسيات مفهوم التصوُّف – في واقعها ثورةً نفسية على سوءِ سعي الناس في الدنيا، وانصرافهم عن الآخرة، وأخذ زُمرة العلماء والفقهاء صدارة المجالس للتفكُّه بالعلوم.
وأهلُ التحقيق مُتفقون على أنَّ التصوُّف نشَأ وترعْرَع في العراق بالبصرة؛ حيث برَزت أسماء كبرى أسهمَت في تأسيسه؛ منها: إبراهيم بن أدهم، وداود بن نصير الطائي، رابعة العدويَّة، معروف الكرخي، السري السقطي، الجنيد البغدادي، وبشر بن الحارث الحافي، أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدالصمد النوري، وأبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز،وابن عطاء البغدادي، وابن عثمان المكي، وغيرهم خَلق عظيم.
فأوَّل “ما ظهرت الصُّوفية من البصرة، وأولُ مَن بنى دويرة الصُّوفية بعضُ أصحاب عبدالواحد بن زي، وعبدالواحد من أصحاب الحسن، وكان في البصرة من المبالغة في الزُّهد والعبادة والخوف ونحو ذلك، ما لَم يكن في سائر أهل الأمصار؛ ولهذا كان يُقال: فقه كوفي، وعبادة بصريَّة.
وقد ظهَر على المتصوفة البصريين ما لَم يُحْكَ عن سواهم من الموت، أو الإغماء عند سماع القرآن، فقد رُوِي أنَّ زرارة بن أوفى -قاضي البصرة -قرَأ في صلاةِ الفجر سورة ﴿-;- فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾-;- [المدثر:]، فخرَّ ميتًا وآخرون كانوا يَخِرُّون صعقًا من آيات العذاب.
وأوَّل من نقَل التكلُّم بلفظ “التصوُّف” في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري – فقد تكلَّم به غيرُ واحدٍ من الأئمَّة والشيوخ – كأحمد (ت241هـ)، وأبي سليمان الداراني (ت215هـ)، وسفيان الثوري، والحسن البصري.
وأوَّلُ مَن عُرِف باسم صوفي في المجتمع الإسلامي: أبو هاشم الصوفي (150هـ وكان ممن يُجيدُ الكلام قبل منتصف القرن الثاني الهجري، وأمَّا صيغة الجمع (الصُّوفية)، فقيلَ: ظَهَرت عام 199هـ.
يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة – رحمه الله -: “في أواخر عصر التابعين حدَث ثلاثة أشياء: (الرأي، والكلام، والتصوُّف)، فكان جمهورُ الرأي في الكوفة، وكان جمهورُ الكلام والتصوُّف في البصرة، فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين، ظهرَ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وظهَر أحمد بن علي الهجيمي (200هـ)، تلميذ عبدالواحد بن زيد، تلميذ الحسن البصري، وكان له كلامٌ في القدر، وبنى دويرةً للصُّوفية، وهي أول ما بُني في الإسلامِ غير المساجد؛ للالتقاء على الذِّكر والسماع، وصار لهم حالٌ من السَّماع والصوت، وكان أهلُ المدينة أقربَ من هؤلاء في القولِ والعمل، وأمَّا الشاميون، فكان غالبهم مُجاهدين”.
يرى البعضُ أنَّ بدايةَ تطوُّر الفكر الصوفي كانت طبيعية، فقد ظهَر أولاً كتيَّارٍ يحاولُ مواجهةَ إقبال الناس على الدنيا بعد زمنِ الفتوحات الكبرى، وانشغال كثيرٍ من المسلمين عمَّا كان عليه رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه، فبدأ تيارٌ ينادي بالزُّهد، وظهَرتْ جماعاتٌ يُسمون الفقراء، وأخرى تسمَّى البكَّائين، وثالثة تسمَّى المُحبين، ثم ظهَر أقوامٌ من الصُّوفية أكثروا الكلامَ عن الجوعِ والفقر، والوساوس والخَطرات.
يقول ابنُ الجوزي: “كانت النسبة في زمنِ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – إلى الإيمان والإسلام، فيُقال: مسلمٌ ومؤمن، ثم حدَث اسمُ زاهد وعابد، ثم نشَأ أقوامٌ تعلَّقوا بالزُّهد والتعبُّد، فتخلَّوا عن الدنيا، وانقَطَعوا إلى العبادة، واتَّخذوا في ذلك طريقةً تفرَّدوا بها، وأخلاقًا تخلَّقوا بها، ورَأَوا أنَّ أول مَن انفرَد بخدمة الله تعالى عند بيته الحرام، رجلٌ يُقال له: “صوفة”، واسمُه: الغوث بن مر، فانتَسَبوا إليه لمشابهتِهم إيَّاه في الانقطاع إلى الله، فسُمُّوا بالصوفيَّة”.
فأمر التصوُّف كأصلٍ له أبعاد وجذورٌ تاريخية وعقَدية، أمَّا كظاهرةٍ بيِّنة للعِيان، تتميَّزُ عن غيرِها، ويمتاز أهلها بها، فهو أمر حادث في علوم ومِلَّة المسلمين، يقول ابنُ خلدون في كلامِه عن التصوُّف: “هذا العلمُ من العلومِ الشرعيَّة الحادثة في المِلَّة، وأصلُه أنَّ طريقَ هؤلاء القوم لَم تَزَل عند سلفِ الأمَّة وكبارها من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، طريقة الحقِّ والهداية، وأصلُها العكوف على العبادةِ والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زُخرف الدنيا وزينتها، والزُّهد فيما يُقبلُ عليه الجمهور من لذَّةٍ ومال وجاهٍ، والانفراد عن الخَلْقِ في الخَلوة للعبادة، وكان ذلك عامًّا في الصحابة والسلف، فلمَّا فشَا الإقبالُ على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجَنَح الناسُ إلى مخالطة الدنيا، اخْتُصَّ المُقبلون على العبادة باسم الصوفيَّة والمتصوِّفة”.
وقد انتسَب إليهم طوائفُ من أهلِ البدع والزندقة، ولكن عند المُحققين من أهل التصوُّف ليسوا منهم، كالحلاَّج مثلاً، فإنَّ أكثرَ مشايخ الطريق أنكَروه، وأخرَجوه عن الطريق؛ مثل الجُنيد بن محمد سيِّد الطائفة وغيره، كما ذكَر ذلك الشيخُ أبو عبدالرحمن السلمي في طبقاتِ الصُّوفية وذكرَه الحافظُ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد.
و”إنَّ الذين هاجَموا التصوُّف والطرق الصُّوفية، نظَروا إلى القشور، وترَكوا اللبَّ، نظَروا إلى ما يفعلُه بعضُ الجهلة من المُريدين والمُكتسبين ممن انتسَب للطُّرق، من أمورٍ لا يَرضى عنها الإسلام، ولا يَضرُّ التصوُّف والصُّوفية ظهورُ هذه الفئة من المتواكلين والدَّجالين، والمُشعوذين والبُلهاء، الذين يتكسَّبون من وراء لُبْس الخِرَق والهلاليل”
يقول Trimingham: “التصوُّف أمر طبيعي، ظهَر ونَما ضمن الإسلام نفسه، ولا يَدينُ إلا بالقليل لمُعطيات الثقافات الأجنبيَّة، وعلى الرَّغم من خضوع التصوُّف لإشعاعاتٍ فكرية صادرة عن الحياة الزُّهدية الصُّوفية المسيحيَّة الشرقية – فإنَّ النتاجَ كان نسيجًا إسلاميًّا، يتَّبع طرازًا إسلاميًّا متمايزًا، ومن ثَمَّ فإنَّ نظامًا صوفيًّا مُتقنًا، نشَأ وتَبَلور بصورةٍ ذاتية داخل الإسلام، ومهما كان الأثر الذي ترَكته الأفلاطونية المُحدثة، أو المذاهب الغنوصية، أو التصوُّف المسيحي، أو غير ذلك من الثقافات الأجنبية، فإنَّنا وبحقٍّ نعتبرُ التصوُّفَ – كما اعتَبره أهلُه – العقيدةَ الرُّوحية للإسلام، والسرَّ الجوهري الحقيقي للقرآن
يقول أبو زهرة بيانًا منه عن ينابيع التصوُّف الأُوَل: “نشَأ التصوُّف من ينبوعين مختلفَين تلاقَيا:
الينبوع الأول: هو انصرافُ بعض العُبَّاد المسلمين إلى الزُّهد في الدنيا، والانقطاع للعبادة، وقد ابتدَأ ذلك في عصرِ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فكان من الصحابة مَن اعتزَم أن يقومَ الليلَ مجتهدًا ولا يَنام، ومنهم مَن يصومُ ولا يُفطر، ومنهم مَن ينقطعُ عن النساء.
فلمَّا بلَغ أمرُهم النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((ما بالُ أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصومُ وأُفطر، وأصلي وأنام، وأتزوَّجُ النساء، فمَن رَغِب عن سُنَّتي، فليس مني).
ولقد نَهى القرآنُ عن بدعةِ الرَّهْبنة، فقال تعالى: ﴿-;- وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾-;- [الحديد :
ولكن بعد أن انتقَل النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – إلى الرَّفيق الأعلى، ودخَل الإسلام ناسٌ كثيرٌ من أهل الدِّيانات السابقة، كَثُر الزُّهاد الذين غالَوْا في الزُّهد في الدنيا ونعيمها، وفي وسطِ تلك النفوس وجَد التصوُّف مكانَه، ووجَد أرضًا خِصبة”
فالثابت مِن كُتُب كثيرٍ ممن عاصَر الصُّوفية وغيرهم: أنَّ أوَّل مَن أسَّس التصوُّف هم الشيعة، ومَرجعُ النَّشأة لرجلين منهم، هما:”عبدك”(ت 210هـ) مختصر عبدالكريم، وهو على رأس طائفة شيعيَّة، وأبو هاشم الكوفي الشيعي الصوفي (ت150هـ)[
فالتصوُّف وليد التشيُّع، وبادي أمر حركة التصوُّف الفرس، الذين يُمثِّلون عصبَ التشيُّع ودمَه الفوَّار، وكبار المتصوفة والمُنظِّرون له فرسٌ؛ كالبسطامي، والحلاَّج، ومعروف البلخي، وابن خضرويه البلخي، ويَحيى بن معاذ الرازي، وللتشيُّع أمشاجٌ فارسية متعدِّدة الثقافات والعقائد، وشيعةُ العراق زُمرة فِراقٍ، وشرذمة شِقاقٍ، دَأْبهم تشقيقُ الكلام، والتلفيق بين الأديان، وهذه سِيرتهم قبل الإسلام، وصنيعهم مع جمهرة الأديان التي حلَّت أرضَهم.
فهم يصبغون أيَّ دينٍ يردُّ عليهم بلبوسهم، ويُذيبونه في ثقافتهم وعقائدهم، فيَصطلحون على ما سلَف من أمرِهم بلغة ما ورَد على ديانتِهم الجديدة، فإن تبصَّر الواعي أمرَهم، درَى أنَّ كِسرى صار يُسمَّى إمامًا، والمرجع الشيعي صار يسمَّى شيخَ الطريقة، والأئمة الاثنا عشر هم الأقطاب والغوث، ومراتبُ دعاة الباطنيَّة الإسماعيلية، هم الأوتادُ والأتقياء والنُّجباء، والمريدون عند الصُّوفيَّة.
و”ليس من قبيل المصادفات أن تَنشأَ الحركة الصُّوفية المتطورة في البصرة – وهي بيئة شبه فارسية – والواقعُ أنَّ الدَّارس لا بدَّ أن يتوقَّفَ عند هذا العدد الهائل من الصُّوفية التي أصولُهم إيران، والذين تَرِد ترجماتهم في كتب التصوُّف العربيَّة، وأن يَستوقفَه أيضًا أنَّ هؤلاء جميعًا كانوا من أصحاب جوامع الكَلِم، وأنَّ بدايةَ التعمُّق الصوفي والإغراق في الرمز، أو ما عُرِف باسم الشَّطح، كان على يد أبي يزيد البسطامي، وهو من أصلٍ فارسي”
والطُّرق الصُّوفية تُشبه في نشْأتِها فكرةَ الحوزات الشيعيَّة، والمرجع الشيعي، ورُوَّاد الحوزة، فأصلُ الفكرة فارسي، وأصلُ كلمة “الخانقاه” فارسي تُطلقُ على المباني التي تُقام لإيواء الصُّوفية..
بيلاسوفا؛ أي: محبُّ الحِكمة، ولَمَّا ذهَب في الإسلام قومٌ إلى قريبٍ من رأيهم، سُمُّوا باسمهم، ولَم يَعرف اللقبَ بعضُهم؛ فنَسبهم للتوكُّل إلى الصفَّة، وأنَّهم أصحابها في عصر النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ثمَّ صُحِّفَ بعد ذلك”]، والقشيري ذكَر أنه “ليس لهذا الاسم أصلٌ في اللغة العربية”
و”كان تأثير النِّحَل الهندية في التصوُّف الفارسي عميقًا، ليس من حيث مطابقة بعض سِيَر الصُّوفية – وأشهرهم إبراهيم بن أدهم – لسيرة بوذا فحسب، بل في كثيرٍ من تفصيلات أفكاره، فالوصولُ إلى الله أو الحق، أو المطلق عند الجوكيين الهنود، يمرُّ بمرحلتين: “السمبراكناثا”؛ أي: تركيز الخاطر في نقطةٍ واحدة، “الإسمبركناثا”؛ أي: التجاوز عن صور الذَّات، والغوص في فكر الذات العليا، والمرحلة الأولى عند المتصوفة المسلمين تُسمَّى بمرحلة جَمْع الخاطر، أمَّا المرحلة الأخرى، فتسمَّى بالمُراقبة”
ويؤيِّدُ هذا القول المستشرقُ الألماني فون هامر، وعبدالعزيز إسلامبولي، ومحمد لطفي جمعة
ويُرجع ديورانت التصوُّف الإسلامي إلى أصولٍ كثيرة؛ منها: نزعة الزُّهد عند فقراء الهندوس، وغنوصيَّة مصر والشام، وبحوث الأفلاطونية الجديدة عند اليونان المتأخِّرين، وتأثير الرُّهبان المسيحيين الزَّاهدين المنتشرين في جميع بلاد المسلمين
ومَنبتُ التصوُّف البصرة، وهي موطنٌ لرُهبان النصارى؛ لذا شاع إنكار تشبُّه الصُّوفية في رَهبنتِهم بالنصارى، ومن ذاك نَقْدُ حمَّاد بن سلمة (157هـ)[ فَرْقدًا السَّبخي البصري (131هـ) ، حينما رآه مُرتديًا ثيابَ صوفٍ، فقال له: “ضعْ عنك نصرانيَّتَك هذه”
ويصفُ بعضُ الباحثين أنَّ “هذه الديانة المسيحية بتعاليمِها وتعاليم مُعتنقيها، قد أثَّرتْ في نشأة التصوُّف الإسلامي وتأثَّر بها”
ويرى البعضُ أنَّ المصادر الداخلية والخارجية كلها ينابيع استَقى منها التصوُّف، بصفته ظاهرة إنسانية عابرة للحضارات والأديان، تسعى للبحث عن الحقيقة في الصَّفاء الرُّوحي، وكثيرٌ من المتصوفة كانوا نصارى قبل إسلامِهم، أو من بيئةٍ نصرانية؛ كمعروف الكرخي.
و”هناك فئةٌ من أكابر المستشرقين؛ أمثال: وينفيلد، جوزيف فون هامر، ثولك، فون كريمر، كار هينرخ بيكر، هانز هينريخ شيدر، وكولد تسيهر، ونيكلسون – في أبحاثه الأولى – ربَطوا الحركةَ بتأثيراتٍ أجنبية؛ مسيحية وهندية، وفارسية ويونانية، فيرى بعضُهم أنَّ الزُّهدَ في الإسلام تقليدٌ لرَهبنة النُّساك من النصارى
والذي يظهرُ من بين هذه الاختلافات، أنَّ التصوُّف ظهَر بعد الإسلام في شكل زُهدٍ ورغبة في الدار الآخرة، وكَبْح جِماح النفس عن حبِّ الدُّنيا مَهْمَا أمكَن، ومدار التصوُّف زيادة في التعبُّد وسَعْي للتقشُّف، فافتَرق الناسُ في أمرِ هؤلاء الذين زادوا في أحوال الزُّهد والوَرَع والعبادة، على ما عُرِف من حال الصَّحابة، فقوم يذمُّونهم ويَنتقصونهم، ويَرمونهم بالبدعة، وقوم يجعلون هذا الطريقَ من أكمل الطُّرق وأعلاها، والتحقيق أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون، منهم الصالحون، ومنهم القاسطون، وبين أولئك عوام قد يَنسِبون لأئمَّتِهم من الأقوال والفِعال ما لا يصحُّ سندًا ولا أصلاً في التصوُّف..
على أنَّ أقطابَ التصوُّف وهم يَبنون هذا المسلك، صَعُب عليهم الابتعاد عن تيارات وأفكارٍ شتَّى مخالفة للإسلام، والتأثُّرُ بها، خاصة من الأتباع وبعض الفرس، وظهورها واضح جَلِي في معتقداتِهم وسائر سلوكهم، على المستوى الفردي أو الجماعي، بعد أن تنوَّعَ الأساس الذي قام عليه المذهب بادي الأمر.
نشأة الطرق الصُّوفيَّة:
يَروي المقريزي في الخطط عن أول دارٍ في الإسلام جَمَعت الصُّوفية، فيقول: “أوَّل مَن اتَّخذ بيتًا للعبَّاد والزُّهَّاد، زيدُ بن صوحان بن صبرة؛ وذلك أنَّه عَمَد إلى رجالٍ من أهل البصرة تفرَّغوا للعبادة، وليس لهم تجارة ولا غلال، فبنى لهم دُورًا وأسكَنهم فيها، وجعَل لهم ما يقوم بمصالحِهم؛ من مطعمٍ ومشرب، وملبسٍ وغيره، وكان ذلك في عهد أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه”.
وأمَّا عن أوَّل دارٍ للصوفيَّة بُنيت في مصر، فقد عُرِفت باسم (الخانقاه)؛ يقول المقريزى: “دار سعيد السعداء، دويرة الصُّوفية، هذه الخانكاه بخط رحبة باب العيد من القاهرة، كانت أولاً دارًا تُعرف في الدولة الفاطمية بدارِ سعيد السعداء، ويُقال: عنبر، وذكر ابن ميسر أنَّ اسمه: “بيان”، ولقبه سعيد السعداء، أحد الأساتذة المُحنَّكين، خدام القصر، عتيق الخليفة المستنصر، فلمَّا استبدَّ الناصرُ صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي بِمُلْك مصر بعد موت الخليفة العاضد، وغيَّر رسوم الدولة الفاطميَّة، ووضَع من قصر الخلافة، وأسكَن فيه أمراءَ دولته الأكراد، عَمِل هذه الدار برسم الفقراء الصُّوفية الواردين من البلاد الشاسعة، ووقَفها عليهم في سنة تسع وستين وخمسمائة، وولَّى عليهم شيخًا، ووقَف عليهم بستان الحبانية بجوار بركة الفيل خارج القاهرة، وقيسارية الشَّراب بالقاهرة، وناحية دهمر، ومرر البهنساوية، وشرط أنَّ من مات من الصُّوفية وترَك عشرين دينارًا ما دونها، كانت للفقراء، ولا يتعرَّضُ لها الديوان السلطاني، ومَن أرادَ منهم السفرَ، يُعطى تسفيرة، ورتَّب للصوفية في كلِّ يوم طعامًا ولحمًا وخبزًا، وبنى لهم حمَّامًا بجوارهم، فكانت أوَّل خانكاه عُمِلت بديارِ مصر، وعُرِفت بدويرة الصُّوفية، ونُعِت شيخُها بشيخ الشيوخ”.
والطرق والربط، والخانقاه والزوايا، كانت منهجيَّة إستراتيجية لصلاح الدين الأيوبي؛ لحفظ الأمن القومي، ومقاومة الترسُّبات الباطنية للدولة العُبيدية، والتسرُّبات النَّصرانية من حروب الإفرنج، وبَسْط سلطان الإسلام والعربية على البقاع الإسلاميَّة كافَّة،
أنَّ عبدالقادر الجيلاني – صاحبَ الطريقة القادرية (ت 561هـ) – هو أوَّل مَن نادى بالطُّرق الصُّوفية وأسَّسها، وكانت الرفاعية هي ثاني طريقة، وتَلَت هذه الطريقةُ المولوية المنسوبة إلى الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي
أ- أنَّ أوَّلَ مَن عُرِف بالصوفي، هو أبو هاشم الشيعي الكوفي (ت150هـ)، وكان معاصرًا لسفيان الثوري (ت 155هـ)، ولجعفر الصادق، ويُنسَب إلى الشِّيعة الأوائل، ويُسَمِّيه الشيعة مُخترعَ الصوفية، وهو الذي بنى زاويةً في مدينة الرملة بفلسطين، وكان أبو هاشم حُلوليًّا دَهريًّا، يقولُ بالاتحاد
ب- يذكر بعضُ المؤرِّخين أنَّ عبدك (مختصر عبدالكريم)، أو محمد (ت 210هـ)، هو أوَّل مَن تسمَّى بالصوفي، ويَذكر عنه الحارثُ المحاسبي أنه كان من طائفةٍ نصف شيعيَّة، تسمِّي نفسَها صوفية، تأسَّست بالكوفة، و”عبدك” كان رأسَ فِرقةٍ من الزنادقة، الذين زَعَموا أنَّ الدنيا كلها حرامٌ، لا يَحِلُّ لأحدٍ منها إلاَّ القوت؛ حيث ذهَب أئمَّةُ الهدى، ولا تَحِل الدنيا إلا بإمامٍ عادل، وإلاَّ فهي حرام، ومعاملة أهلها حرامٌ.
ج- يذهب ابنُ النديم في الفهرست إلى أنَّ جابر بن حيَّان (ت200هـ)[ – تلميذ جعفر الصَّادق (ت 208هـ) – أوَّل مَن تسمَّى بالصوفي، والشيعة تعتبرُه من أكابرهم، والفلاسفة ينسبونه إليهم
ويُطلقُ اسم التصوُّف في أوائلِ ظهوره “على جميع الصُّوفية في العراق في مقابل “الملامتية”، وهم الصُّوفية في خراسان، ثم أخَذ هذا الاسم يطلقُ بعد ذلك بقرنين على جميع أهل الباطن من المسلمين
وأوَّل مَن حدَّد نظريات التصوُّف وشرَحها، ذو النون المصريوأوَّل من بوَّبها ونشرَها: الجنيد البغدادي، وأوَّل مَن تكلَّم في علم الفناء والبقاء: أحمد بن عيسى أبو سعيد الخزاز شيخ الصُّوفية.
لأطوار التي مرَّ بها التصوُّف:
إذ “بدَأ التصوُّفُ باستنباطِ حياةٍ زُهديَّة من القرآنِ والسُّنة؛ سنة الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – وسُنة الصحابة، ثمَّ كان تصوُّفًا، ثمَّ أصبح التصوُّف علمًا يقابلُه قواعد عمليَّة، وقد احتضَن الأشاعرة – منذ أبي حامد الغزالي – التصوُّفَ، وأصبح جزءًا من حياة الخلف
يقولُ ابن خلدون في كلامه عن علم التصوُّف: “هذا العلمُ من العلوم الشرعيَّة الحادثة في المِلَّة، وأصلُه أنَّ طريقَ هؤلاء القوم لَم تَزَل عند سلفِ الأمَّة وكبارها من الصحابةِ والتابعين، ومَن بعدهم – طريقة الحقِّ والهداية، وأصلها العكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زُخرف الدنيا وزِينتها، والزُّهد فيما يُقبلُ عليه الجمهور من لذَّة ومالٍ وجاهٍ، والانفراد عن الخَلق في الخَلوة للعبادة، وكان ذلك عامًّا في الصحابة والسَّلف، فلمَّا فشَا الإقبالُ على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنَح الناسُ إلى مخالطة الدنيا، اختُصَّ المُقبلون على العبادة باسم الصُّوفية والمتصوِّفة”
فكان هدي الصحابة هو الأساس الذي نظَر إليه أئمَّة الصُّوفية والفقراء في تأصيلِ مناهج الزُّهد والنسك، وتطهير الرُّوح مما لَحِقَها من ترف الحضارة، حين فُتِحت الدنيا على المسلمين، وبعدت طوائفُ منهم عن نسكِ مَن سلَف، وغَلَبت رِقةُ الدِّين على الأفراد، وكَثُر الشِّبَع، وفشا الكسلُ والتَّواكُل، وانغمَسَت الناسُ في مَلَذَّات الدنيا، وكان بادئ هذا الأمر النصف الثاني من القرن الثاني الهجري.
يبدأ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وامتازَ هذا الطورُ بالحرص على الاتِّباع دون الابتداع، وعلى رأس هذا الطَّور ظهَر إبراهيمُ بن أدهم (ت 161 هـ)، وهو يغزو في بلاد الروم، وأبو سليمان داود بن نصر الطائي (ت 165هـ)، وقد انشغلَ بالعلم والفقه، واشْتَهرَ بالخَلوة والعبادة، ورابعة بنت إسماعيل العدوية البصريَّة، أمُّ الخير المشهورة بالزُّهد والصلاح (ت 185هـ)، والفُضيل بن عياض (ت 187هـ) في مكة، وشقيق البلخي (ت 194هـ)، وأبو حفص عمر بن مسلمة الحدَّاد (ت 260هـ)، كان أحدَ أئمَّة الصُّوفية،
يقول ابنُ القيم: “واجتمَعت كلمةُ الناطقين في هذا العلم أنَّ التصوُّف هو الخلق، وهذا العلم مَبني على الإرادة، فهي أساسه ومَجمع بنائه، وهو يشتملُ على تفاصيل أحكام الإرادة، وهي حركة القلب؛ ولهذا سُمِّي علمَ الباطن، كما أنَّ علم الفقه يشتملُ على تفاصيل أحكام الجوارح؛ ولهذا سُمِّي علمَ الظاهر”[
وكان شغل أئمَّة الصُّوفية إحياء السُّنن، والعَود على بَدْءٍ، ووَعْظ الناس بأنَّ ما في أيديهم قد يؤخَذُ منهم بمعاصيهم وانصرافهم عن السبيل المستقيم،
فامتازَ منهجُ المتقدِّمين في الجملة بالتعويل على الكتاب والسنة، واعتبارهما مصدري التلقي والاستدلال، ويُروى عنهم نصوصٌ كثيرة في ذلك وقال أبو عمر بن نجيد (ت366هـ)[ : “كلُّ وَجْدٍ لا يشهد له الكتاب والسُّنة، فهو باطل”.
وفي ذا الطور كان التصوُّف قائمًا على أُسسٍ “قد بُني عليها، وهي:
الأساس الأول: معرفة عقائد الإيمان.
الأساس الثاني: معرفة الأحكام الفقهيَّة.
الأساس الثالث: العمل بمقتضى العلم.
الأساس الرابع: الإخلاص في العمل
الإرادة.
نرى أنَّ التصوُّفَ “بدأ زُهدًا، فتصوُّفًا، ففلسفة، أو بمعنى أدقَّ: بدأ التصوُّف في مرحلتِه الأولى يتخذُ تصوُّراتِه وحقائقَه من القرآن والسُّنة، ثم انتقَل إلى مرحلةِ التصوُّف، فبينما كانت المرحلةُ الأولى مرحلةً عملية، كانت المرحلةُ الثانية مرحلةَ عملٍ ونظرٍ، فتكلم الصُّوفية عن الأذواقِ والمواجد، وخطراتِ القلب، ومراحلِ الطَّريق الصوفي، وأخذوا يُحدِّدون تفسيرات مقابلة لتفسيراتِ الفقهاء والمتكلِّمين للمعاني الدِّينية.
ومَضى التصوُّفُ في السير، فانقَلَب أخلاقًا عند أهل السُّنة والجماعة، وفلسفة عند طائفة، مزَجوه بعلومِ اليونان وبحِكمة المشارقة الأقدمين، والفيدا الهندي واليوجا، وتراث الهند جميعه، مزَجوا هذا كلَّه في فلسفة ظاهرُها إسلامي، وباطنُها غير إسلامي