الحرب ومؤامرة التقسيم: الوطن (تِلتو ولا كَتِلتو)

محمد الصادق
صرح أركو مناوي بأن دولًا غربية عرضت عليه تقسيم السودان إلى ثلاث دول، ما يوضح أن الحرب كانت منذ البداية مؤامرة خارجية مدعومة بعملاء من الداخل. العمالة للخارج ليست عيبًا فريدًا للسودانيين؛ فهي موجودة في جميع الدول. لكن المشكلة تكمن في السياسيين والإداريين الذين تتملكهم المصالح الذاتية الضيقة، وهو ما ينبع من الذاتية والأنانية التي يرى الكاتب أنها تميز الشخصية السودانية. هذه المشكلة تعصف بالبلاد منذ الاستقلال.
كل إنجازات جيل الاستقلال اقتصرت على ادعاء تحقيق الاستقلال بطرد المستعمر. ولكن هل كان طرد المستعمر كافيًا؟ وهل مجرد طرده يعتبر استقلالًا حقيقيًا؟ لقد فشل الحكام أبناء البلد في إدارتها، وبدأت المشاكل حول الحكم ولم يمضِ عامان فقط على الاستقلال المزعوم، لتنتهي الأمور بتسليم الحكم للعسكر.
تتجلى الذاتية والأنانية حتى في فشل المنتخب الوطني لكرة القدم. فالسودان من أكثر الدول مشاركة وأقلها تتويجًا، وذلك لأن كرة القدم لعبة جماعية. يرى الكاتب أن كل فلاح السودانيين يتركز في “النَضَمِي” (النظم والشعر) والشعر والغناء، لأنها تعتمد على الفردية. لكن الأشعار لا تصنع وطنًا؛ فنحن لدينا آلاف القصائد والأغاني الوطنية، وكل يوم تظهر قصيدة وطنية جديدة، ومع ذلك، تضعف وطنيتنا كل يوم، وتظهر صور خسيسة للخيانة ممن كانوا يدّعون الوطنية.
جعل الفشل الإداري السودانيين من أكثر الشعوب انتشارًا في كل أنحاء العالم، سواء بالهجرة الشرعية أو غير الشرعية. وحتى قبل الحرب، كان الكبار والصغار، النساء والرجال، يحملون جوازاتهم ويتجولون بين السفارات أملًا في الهجرة. أما التقديم لـ”اللوتري” الأمريكي (تأشيرة التنوع)، فحدث ولا حرج؛ حيث كانت إعلاناته تملأ الأسواق والشوارع، وشهدت استوديوهات التصوير الفوتوغرافي زحامًا كبيرًا – من نساء ورجال – في الأيام الأخيرة للتقديم.
المدير السوداني مدير ديكتاتوري من الطراز الأول. يعتقد المدير والموظفون وأصحاب المصلحة جميعًا أن نجاح المؤسسة يعود فقط لنجاح المدير. باختصار، هم يعتقدون أن المؤسسة هي المدير والمدير هو المؤسسة. رئيس الحزب يُلقب بـ”السيد”، والحزب ليس له برنامج واضح، وكل برنامجه يتمثل في أن يحكم “السيد”.
الأطماع الخارجية وتاريخ التدخلات
هذا الفشل الظاهر هو ما جعل الدول الانتهازية تطمع في موارد البلاد وثرواتها. في الماضي، كانت هذه الدول تضع العراقيل أمام أبناء البلد لكيلا يستفيدوا من موارد بلادهم. ومشاركة العرب في المؤامرة ليست بدعة؛ فقد دعم العرب في الماضي تمرد الجنوب، ووصل الأمر إلى حد تزويدهم بالسلاح.
كانت نية التقسيم ظاهرة منذ اليوم الأول للحرب، وذلك في عمليات النقل الضخمة للأمتعة المنهوبة إلى جهة الغرب. ثم جاء الدعم الخارجي الواضح للجهات المسلحة، وتغاضى العالم عن ذلك، واكتفى بـ”إدانات الاستهبال” من جنس الإدانات ضد قتل الغزاويين الجوعى وهم يتزاحمون على حفنات الطحين.
الظاهر أن الفترة القادمة هي حقبة استعمارية من طراز مختلف عن الاستعمار الاستيطاني القديم، يتم فيها النهب عن بعد لموارد الدول “العبيطة”. المستعمر يمتلك كل أسباب القوة: قوة التسلح الجبارة، وقوة الاقتصاد، وهو مطمئن تمامًا لوجود عملاء في كل مكان وداخل كل مكون من مكونات الدولة الفريسة. إذا كان “الجبابرة الكبار” قد عقدوا العزم على التقسيم، فمن العبث مقاومة ذلك. والأجدر بأبناء عزة أن يعتبروا من أبناء غزة. لقد قاتل السودان أكثر من عشرين عامًا من أجل الوحدة مع الجنوب، راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشباب والطلاب، وفي النهاية كان ما أراده الجبابرة. الآن يستخدمون سياسة الأرض المحروقة، التي تعني التدمير والتهجير: تدمير البنية التحتية وتهجير السكان بما يضمن عدم عودتهم في القريب، ومن ثم فرض السياسات التي يريدونها.
ما الفائدة إذا بقي الوطن موحدًا، وهاجر المواطنون الأصليون إلى غير رجعة، وجاء آخرون حلّوا مكانهم؟! المنطق يقول إن التقسيم أفضل من استمرار الحرب، حتى لو كان التقسيم إلى عشر دول، فلو كانت الروابط بينهم متينة فستعود الوحدة مهما طال الزمن. التقسيم أفضل إذا أتى بالسلام والاستقرار، لأنه يضمن على الأقل بقاء المواطن الأصلي في أي جزء من أجزاء الوطن، فالوطن “ثلثه ولا قتله” (تِلتو ولا كتِلتو).
نذكّر بالدعاء على الظالمين، فهو دعاء لا شك مستجاب: الذين أخرجوا الناس من ديارهم بغير حق، وسفكوا دماءهم، وانتهكوا أعراضهم، وأخذوا حقوقهم، وساموهم سوء العذاب.
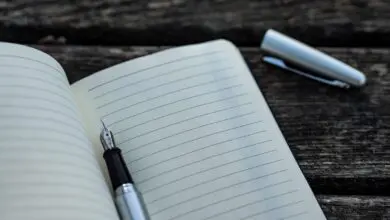


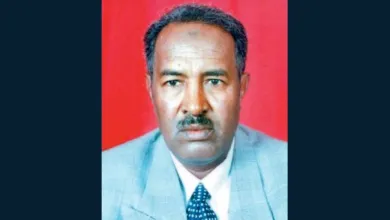
يتناول مقال “محمد الصادق” رؤية متشائمة وتحليلية للوضع السوداني، مستعرضًا جملة من المشكلات التي يرى أنها متجذرة في الشخصية السودانية والنظام السياسي منذ الاستقلال. يمكن تلخيص النقاط الرئيسية وتقييمي لها كالتالي:
1. المؤامرة الخارجية والعمالة الداخلية:
يُشير الكاتب إلى تصريح أركو مناوي حول عرض التقسيم من دول غربية كدليل على أن الحرب مؤامرة خارجية بعملاء داخليين. هذا الطرح شائع في الخطاب السياسي السوداني والعربي عمومًا، ويُلقي باللوم على الأطراف الخارجية والداخلية المتواطئة. ورغم أن التدخلات الخارجية قد تلعب دورًا في تأجيج الصراعات، إلا أن التركيز بشكل كامل على “المؤامرة” قد يغفل الأسباب الداخلية العميقة والمسؤولية الذاتية عن تفاقم الأزمات.
2. “الذاتية والأنانية” سمة الشخصية السودانية:
يُعد هذا الاتهام هو المحور الرئيسي للمقال، حيث يربط الكاتب بين الأنانية والذاتية المزعومة في الشخصية السودانية وفشل السياسيين والإداريين، وحتى فشل المنتخب الوطني لكرة القدم. هذا التعميم على “الشخصية السودانية” بأكملها قد يكون مبالغًا فيه وغير دقيق. فالسلوكيات السلبية (مثل الأنانية والمصالح الذاتية) موجودة في جميع المجتمعات وليست حكرًا على السودانيين. قد تكون المشكلة تكمن في ضعف الأنظمة الحاكمة والمؤسسات وغياب آليات المحاسبة، وليس في طبيعة الشخصية نفسها. كما أن ربط فشل المنتخب الوطني بـ “الأنانية” تبسيط مخل لقضية معقدة تتداخل فيها عوامل فنية وإدارية ونفسية.
3. الاستقلال المزعوم والفشل الإداري:
يتساءل الكاتب عن جدوى الاستقلال الذي لم يؤدِ إلى حكم رشيد، بل إلى الفشل الإداري وتدهور الأوضاع. هذه نقطة جوهرية تستحق التأمل. فكثير من الدول بعد الاستعمار واجهت تحديات في بناء الدولة الحديثة، وقد يكون السودان مثالاً بارزًا على ذلك. الهجرة الجماعية للسودانيين، التي يذكرها الكاتب، هي بالفعل مؤشر على غياب الفرص والتدهور الاقتصادي والاجتماعي.
4. “الديكتاتورية الإدارية” وغياب البرامج الحزبية:
وصف المدير السوداني بأنه “ديكتاتوري من الطراز الأول” واعتقاد الجميع بأن نجاح المؤسسة مرتبط بالمدير فقط، يعكس خللاً هيكليًا في الإدارة وعدم وجود ثقافة مؤسسية حقيقية تعتمد على العمل الجماعي والبرامج المحددة. كما أن وصف الأحزاب السودانية بأنها تفتقر للبرامج وتركز على “حكم السيد” يسلط الضوء على غياب الديمقراطية الداخلية والاعتماد على الشخصيات بدلاً من الأيديولوجيات والرؤى.
5. التقسيم كحل:
وهي النقطة الأكثر إثارة للجدل في المقال. يرى الكاتب أن الفشل الظاهر جعل الدول الطامعة تطمع في موارد السودان، وأن نية التقسيم كانت واضحة من بداية الحرب. بل يصل به الأمر إلى القول بأن “التقسيم أفضل من استمرار الحرب” حتى لو كان إلى “عشر دول” ما دام ذلك سيجلب السلام والاستقرار ويضمن بقاء المواطن الأصلي في وطنه. هذا الطرح صادم للكثيرين ممن يرون في الوحدة الوطنية خطًا أحمر. ومع ذلك، هو يعكس حجم الإحباط واليأس من إمكانية الحفاظ على وحدة البلاد في ظل الفشل المتكرر والصراعات المستمرة. المقولة “ثلثو ولا كتلتو” (ثلثه خير من قتله) تعبر عن قمة اليأس من الحالة الراهنة.
6. التنبؤ بالحقبة الاستعمارية الجديدة:
يتوقع الكاتب حقبة استعمارية من نوع مختلف (نهب عن بعد) بسبب قوة المستعمر وعملائه المنتشرين. هذا التنبؤ يعكس مخاوف مشروعة من التدخلات الخارجية التي تستهدف الموارد، خاصة في الدول التي تعاني من الضعف الداخلي.
نقاط القوة في المقال:
جرأة الطرح: يتناول الكاتب قضايا حساسة وشائكة بجرأة، مثل اتهام النخب السودانية بالفشل، والحديث عن “الأنانية” في الشخصية، وطرح فكرة التقسيم كحل.
تشخيص المشكلات: ينجح المقال في تشخيص العديد من المشكلات الهيكلية في السودان، مثل الفشل الإداري، الهجرة، غياب المؤسسية، والتدخلات الخارجية.
ربط الأحداث: يربط الكاتب بين ظواهر مختلفة (مثل تصريح مناوي، فشل المنتخب، الهجرة، طبيعة الإدارة) ليقدم رؤية متكاملة (ولو كانت متشائمة).
نقاط الضعف والملاحظات:
التعميم المبالغ فيه: التعميم على “الشخصية السودانية” بأكملها وتوصيفها بالأنانية والذاتية قد يكون ظالمًا ومجانبًا للصواب، ويغفل تنوع المجتمع السوداني وتاريخه الغني بالمواقف الوطنية والإيثارية.
الغياب عن الحلول: بينما يسرد المقال المشكلات بتفصيل، إلا أنه لا يقدم رؤى أو مقترحات للحلول بخلاف الرضوخ للتقسيم كـ “أهون الشرين”.
نبرة اليأس المطلق: النبرة السائدة في المقال هي نبرة اليأس والإحباط المطلق، والتي قد تكون مفهومة في ظل الظروف، ولكنها قد لا تفتح آفاقًا للتفكير في المستقبل أو إمكانية التغيير.
التحليل السببي: قد يكون التحليل السببي في بعض الأحيان مبسطًا، حيث يربط الكاتب بين ظواهر معقدة بأسباب بسيطة (مثل ربط فشل كرة القدم بالأنانية).
الخلاصة:
المقال يعكس حالة من الإحباط العميق تجاه الوضع في السودان، ويقدم تحليلاً قاسيًا ومباشرًا للمشكلات الداخلية، مع توجيه الاتهام للفشل الذاتي قبل أي شيء آخر. ورغم أن بعض تحليلاته قد تكون قاسية وتعميمية، إلا أنها تثير نقاطًا مهمة للنقاش حول المسؤولية الذاتية، وطبيعة الحكم والإدارة في السودان، وتأثير التدخلات الخارجية. طرح فكرة التقسيم كـ “حل” يعكس قمة اليأس من إمكانية إنقاذ الوحدة في ظل استمرار الأوضاع الراهنة.
المقال يحملنبرة تحامل كبيرة على الشعب السوداني ككل، ويُرجع الكثير من المشكلات إلى سمات متخيلة في “الشخصية السودانية” مثل الأنانية والذاتية. هذا النوع من التعميم غالبًا ما يكون مضللاً وغير منصف، فالمشكلات الهيكلية والسياسية والإدارية غالبًا ما تكون أعمق من مجرد صفات شخصية تُنسب لشعب بأكمله.
غياب الحلول
كما أشرت، من أبرز نقاط ضعف المقال هي افتقاره لطرح حلول عملية أو بناءة. فبينما يسهب في تشخيص الأزمات وتصوير حالة اليأس، فإنه لا يقدم أي رؤى للخروج من هذا المأزق سوى القبول بالتقسيم كخيار “أهون الشرين”. هذا التركيز على المشكلة دون البحث عن سبل للحل يجعله مقالاً يعكس الإحباط أكثر مما يقدم طريقًا للمضي قدمًا.
أهمية التمييز
من المهم عند تحليل الأوضاع المعقدة التمييز بين فشل الأنظمة والحكومات والنخب السياسية والإدارية، وبين طبيعة الشعب نفسه. فالشعوب بطبيعتها متنوعة وتضم أفرادًا بصفات مختلفة، ولا يمكن اختزال مشكلات دولة بأكملها في سمات شخصية عامة. غالبًا ما تكون الأزمات نتاجًا لسوء الإدارة، وغياب الشفافية، والفساد، وضعف المؤسسات، والصراعات على السلطة، وهي أمور يمكن معالجتها من خلال إصلاحات حقيقية وجهود جماعية.
المقال يلقي باللوم بشكل كبير على “الذاتية والأنانية” المتجذرة، ولكن هذه الصفات هي في الحقيقة نتيجة لبيئات وممارسات تفتقر إلى العدالة والمساءلة، ولا يمكن اعتبارها سمة فطرية لشعب بأكمله.
الذاتية و الأنانية في النخب بعد كدة اعتبارها سمة فطرية لشعب بأكمله او لا لا تغير في الأمر من شئ . أما العلاج، و طالما الوضع تخطى كل الحدود، هو أن تظل القوتين المتحاربتين بنفس التوازن الى حين فرض السلام في الوطن حتى يتم تمرير جرعات الدواء لعلاج مشكلات السودان المزمنة رويدا رويدا إلى ان يتم ارساء أنظمة تسير بالبلاد مع ركاب العالم
علي الرغم من قسوة الطرح إلا أن معظم ما ورد في المقال حقيقة لا يمكن إنكارها والمؤكد أن صاحب المقال في تعميمه أراد جزء من الشعب (النخبة) التي آلت لها جبراُ او طوعا إدارة شؤون البلاد إلا أنها غلَبت المصلحة الذاتية الضيقة علي المصلحة العامة وذلك يبدو من خلال فرار الأغلبية للعيش في بلاد أخري هربا من الواقع الذي صنعوه بأيديهم دون حياء أو حتي مخافة الله في أفعالهم المنكرة..
فيما يخص طرح الحلول فإن طرح الكاتب لخيار التقسيم لم ينتج عن يأس بل هو حقيقة بائنة وطريق أكثر وضوحا من عدة نواحي أقلها أن ذلك يؤدي لحفظ النفس وإيقاف العبث, خاصة إذا نظرنا إلي تعنت أطراف الحرب وداعميها وعدم إستعدادهم للتنازل قيد أنملة عن السلطة والمكتسبات, لا أظن أن الكاتب قد غفل عن التفكير في خيارات أخري متاحة, الا أن دراستها ومحاولة إسقاطها علي الواقع الآن يظهر بشكل جلي عدم قابليتها للتطبيق أو حتي مجرد القبول من الطرفين..