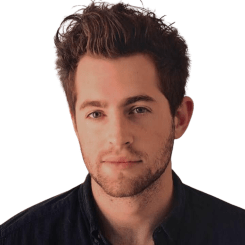
هناك حروبٌ تُؤثّر ظاهريًا على ضمير العالم، وهناك حروبٌ تختفي منه تمامًا. لفهم السبب، علينا أولًا أن نفهم طبيعة كارثة السودان، والخطوط الفاصلة الأيديولوجية التي تُهدّد بكشفها.
قبل ستة أشهر فقط من مذبحة حماس في 7 أكتوبر ، اندلعت أعمال عنف في 15 أبريل 2023 داخل المؤسسة العسكرية السودانية. لم يكن انقلابًا بالمعنى التقليدي، بل انحدارًا إلى حرب أهلية، حيث واجهت القوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف عالميًا باسم حميدتي.
بدأ القتال في الخرطوم، قلب الولاية، وسرعان ما امتد غربًا إلى دارفور، حيث أعاد إحياء أحلك صفحات تاريخ السودان. لم تُغطَّ المجازر التي استهدفت شعب المساليت حقها في التغطية الإعلامية، ومع ذلك وصفها مراقبون من جهات خارجية بأنها أعمال تطهير عرقي . وبحلول أوائل عام ٢٠٢٥، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت إبادة جماعية ، وكانت الجماعات غير العربية، مثل المساليت، الضحايا الرئيسيين والأهداف المقصودة.
الإحصاءات مُذهلة، لكنها لا تُشير إلا إلى الهاوية. يواجه ما يقرب من 25 مليون شخص الآن جوعًا مُدقعًا ، وهي أكبر أزمة جوع في العالم اليوم. وقد تأكدت حالات المجاعة في أجزاء من شمال دارفور. ويُقدر أن أكثر من 522 ألف طفل لقوا حتفهم بسبب الجوع وحده، بينما لا يزال العدد الحقيقي للقتلى – بما في ذلك الذين قُتلوا بسبب العنف والمرض والنزوح القسري – غير قابل للقياس. في الخرطوم وحدها، لقي ما لا يقل عن 61 ألف شخص حتفهم، منهم 26 ألفًا قُتلوا مباشرةً في المعارك.
ونزح أكثر من 8.8 مليون سوداني داخليًا، وفرّ أكثر من 3.5 مليون لاجئ عبر الحدود. ووثّقت نقابة الصحفيين السودانيين أكثر من 40 جريمة حرب في مايو/أيار 2023 وحده. وأصيب أو قُتل عشرات الصحفيين. كما استُهدف العاملون في المجال الإنساني، حيث قُتل 18 منهم واعتُقل كثيرون آخرون.
ولم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولا تزال الحرب مستمرة بعواقب إنسانية وخيمة وتداعيات إقليمية. هناك حروبٌ تُؤثّر ظاهريًا على ضمير العالم، وهناك حروبٌ تختفي منه تمامًا. لفهم السبب، علينا أولًا أن نفهم طبيعة الكارثة السودانية، والخطوط الفاصلة الأيديولوجية التي تُهدّد بكشفها.
لا يمكن تحريف حرب السودان إلى روايات قوية تثير غضبًا بين عاكسي العدالة المعاصرين، الذين لا يزال البعض يسميهم نشطاء. لا يوجد أشرار استعماريون. لا أشباح صهيونية. لا شركات لمقاطعتها. لا يمكن تعريفها بأنها معركة بين “الظالم” و”المظلوم”، ولا ثنائية واضحة بين “المقاومة” و”الاستعمار”.
إنها حرب ما بعد الاستعمار، حرب أفريقية، حرب عربية، حرب إسلامية، حرب بين فصيلين وحشيين يدعي كل منهما الشرعية بينما يعمل في ظل إفلات من العقاب. قوات الدعم السريع مسؤولة تاريخيًا عن فظائع لا توصف: عمليات قتل بدوافع عرقية، واغتصاب جماعي، وتجنيد الأطفال.
القوات المسلحة السودانية تقصف أحياء بأكملها حتى لا وجود لها. كل من الجناة والضحايا هم في الغالب من السود والعرب والمسلمين. لا توجد قضية تقدمية يمكن الترويج لها. لا ذنب ليبرالي يمكن تطهيره. لا ملصق يمكن طباعته في الوقت المناسب لشهر الفخر. وهكذا، تختفي الحرب. لكن اختفاء السودان ليس صدفة، بل هو الفصل الأخير في قصة أطول وأكثر إدانة – قصة عن الضمير الانتقائي للغرب ما بعد الحداثي، وعن الأنقاض الأيديولوجية التي نسميها الآن التقدم.
لنتذكر: في دارفور، قبل عقدين من الزمن، لمح العالم لأول مرة عواقب هذا الفظائع الانتقائية. بين عامي 2003 و2005، شنت ميليشيات الجنجويد، بدعم من الحكومة الإسلامية السودانية، حملة إبادة جماعية ضد القبائل غير العربية. لم يلحظ العالم ذلك إلا لفترة وجيزة.
كانت هناك احتجاجات جامعية محدودة. كان هناك بعض المشاهير يرتدون أساور “أنقذوا دارفور”. ولكن بمجرد أن فشلت الحرب في أن تندرج ضمن مخطط دقيق للذنب الإمبريالي، تلاشت الاهتمام. لم يكن الجناة مؤهلين للغرض. لم يكونوا أمريكيين. لم يكونوا صهاينة.
كانوا عربًا سودانيين، وكثير منهم مسلمون متدينون، والإبادة الجماعية التي شنوها لم تكن ضد الكفار، بل ضد إخوانهم المسلمين الذين اعتبروا غير عرب بما فيه الكفاية. هذا الصمت هو سابقة اليوم. في السنوات التي تلت ذلك، ومع تقدم السودان نحو الديمقراطية، عومل نضاله لا بالتضامن بل بالريبة – ومن المفارقات أن الليبراليين الغربيين رأوا الليبرالية السودانية بعين الاستعلاء. ويمكن للمرء أن يتخيلهم خلف الأبواب المغلقة – وإن لم يكونوا علنًا – يتساءلون: من هم هؤلاء المسلمون السود والعرب الذين يتحدثون بلغة الديمقراطية الدستورية والقانون العلماني؟ كان من الأسهل والأكثر رواجًا اعتبار الرجل الإسلامي القوي عمر البشير حصنًا منيعًا ضد الإمبريالية بدلًا من الاستماع إلى المعارضين الذين سجنهم وعذبهم.
حتى بعد ثورة 2019، عندما أطاح الشباب السوداني بالبشير عبر احتجاجات سلمية، ملوحين بالأعلام ومرددين هتافات الحرية، تثاءب العالم. فالتقدميون الغربيون أنفسهم الذين أشادوا بميدان التحرير في مصر، والذين رفعوا راية الثورة السورية قبل أن يتخلوا عنها، قابلوا الحركة الديمقراطية السودانية بلا مبالاة، أو أسوأ من ذلك، بازدراء.
وعندما أُطيح بتلك الحكومة المدنية الهشة بانقلاب عام 2021، بالكاد عبّر الغرب عن ندمه ومضى قدمًا. الآن، حانت النهاية. وما زال العالم ينظر بعيدًا. لماذا؟ أعتقد أن الإجابة تكمن في البنية الهوياتية السائدة في هذا العصر. يبدو أن الرادار الأخلاقي لليسار الغربي مُصمم ليس لمعاناة البشر، بل للمنفعة الأيديولوجية.
ولماذا يُعدّ السودان غير ملائم لهذه المؤسسة؟ إنه بلدٌ يُفصح انحداره إلى سفك الدماء عن الانهيار التام لحلم ما بعد الاستعمار – حلمٌ وُلد في قاعات محاضرات باريس وأوهام الثورة في الجنوب العالمي. كان حلمًا تولّد على يد بعضٍ من أكثر الشخصيات الفرنسية إفلاسًا فكريًا في القرن العشرين – من فوكو إلى دريدا. وقد تبنّى جيلٌ من الأكاديميين الغربيين نظرياتهم كنصوصٍ أخلاقية، بعد أن آمنوا بأن القمع لا يمكن أن يتدفق إلا في اتجاهٍ واحد. والآن، بينما ينهار السودان في إبادة جماعية (مرةً أخرى)، تصمت تلك الأصوات نفسها. لا يمكنها استيعاب هذا النوع من المعاناة. إنه لا يتوافق ولا يُؤكّد. يتدفق القمع في الاتجاه الآخر. لا يُقدّم أي خلاص رمزي.
علاوة على ذلك، يكشف السودان ليس فقط عن عنف أمراء الحرب، بل عن فشل تراث سياسي بأكمله. يكشف انهيار القومية العربية في ظل حكم اللصوص. يكشف عن خيانة العدالة الإسلامية، التي لا يمكن بطبيعتها إلا أن تُفضي إلى الاستبداد. يكشف عن عجز القومية الأفريقية ومؤسساتها، وجبن الدبلوماسية العالمية، والنزعة الإقليمية الأخلاقية لليسار الغربي.
ومع ذلك، في خضم هذا الكابوس، وفي المدن المحاصرة، يواصل الأطباء إجراء العمليات الجراحية دون تخدير. وينظم المدنيون قوافل غذائية تحت تهديد الغارات الجوية. والنساء، اللواتي تحملن وطأة هذه الحرب، يواصلن رفع أصواتهن ضد كلا الفصيلين، مخاطرات بالاغتصاب والموت من أجل حقهن في التعبير. ما يطلبه السودان إذن ليس فقط المساعدة أو التدخل، بل الذاكرة أيضًا. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر دفنَ التقوى الكسولة ذات المنفعة الأيديولوجية. إن الحرب المنسية، أو لنقل الممحوة، ليست حرب السودان، بل هي حربك أيها الغربي العزيز.
– صموئيل هايد كاتب وباحث سياسي، يقيم في تل أبيب، إسرائيل. ويعمل في معهد سياسات الشعب اليهودي، وعمل سابقًا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومعهد رصد السلام والتسامح الثقافي، ومركز كيب تاون للهولوكوست والإبادة الجماعية.



