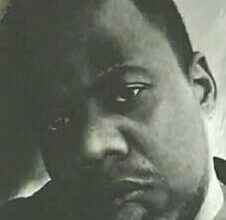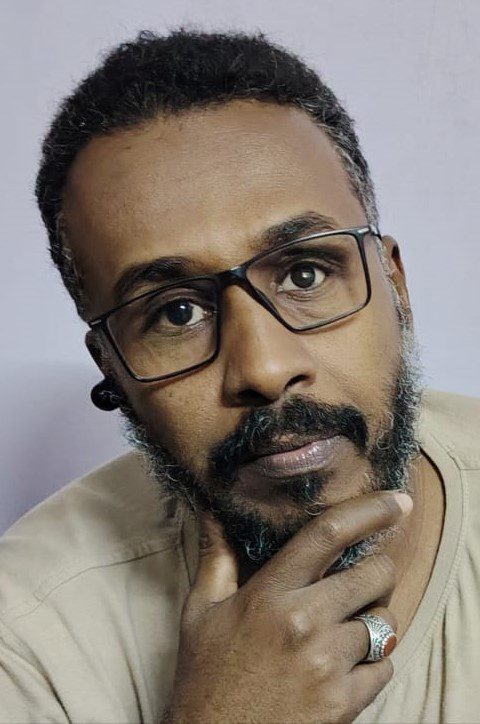
في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية في السودان، وتحديدًا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإمارات بمنع
شركات الطيران السودانية من الهبوط في مطاراتها وإيقاف الشحن البحري، وجدت حكومة الأمر الواقع نفسها
أمام انهيار متسارع في قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع جنوني في سعر الدولار، وانكشاف شبه كامل في
منظومة النقد الأجنبي. وبدلًا من أن تتجه إلى إصلاحات هيكلية أو تفاهمات سياسية، اختارت أن تُحكم قبضتها
على الاقتصاد عبر سلسلة من القرارات التي لا تعكس سوى منطق السيطرة، لا منطق الإنقاذ.
تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس لم يكن سوى إعادة إنتاج لنهج مركزي لا
يملك أدوات الإصلاح، بل أدوات التوجيه القسري. اللجنة، التي يفترض أن تكون معنية بإدارة الأزمة، جاءت
في سياق من التداخلات السياسية والاقتصادية، حيث تغيب الشفافية، وتُهيمن المصالح الضيقة، ويُعاد إنتاج
أدوات السيطرة لا أدوات التنمية. لم تُعلن الحكومة عن آليات عمل اللجنة، ولا عن معاييرها، مما يجعلها أقرب
إلى غرفة عمليات أمنية منها إلى هيئة اقتصادية مستقلة.
القرار بمنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الشروط المصرفية والتجارية، وإن بدا في ظاهره محاولة
لضبط السوق، إلا أنه في الواقع يُهدد بانقطاع سلاسل التوريد، ويخلق ندرة في السلع الأساسية، ويُفتح الباب واسعًا أمام التهريب. حين تُغلق القنوات الرسمية، يُصبح السوق السوداء هو البديل، وتُصبح الأسعار رهينة للمضاربين، وتُدفع الطبقات الفقيرة ثمنًا مضاعفًا لانعدام الرؤية. هذا القرار لا يُعالج الأزمة، بل يُعيد إنتاجها في شكل أكثر قسوة، ويُحول الاقتصاد إلى ساحة مغلقة لا يدخلها إلا من يملك النفوذ أو القدرة على التحايل.
القرارات المتعلقة بالذهب تمثل أخطر ما جاء في هذه الحزمة، ليس فقط لأنها تمس المورد الاقتصادي الأهم في البلاد، بل لأنها تكشف عن توجه احتكاري صارخ، يُعيد إنتاج الطفيلية الرأسمالية تحت غطاء الدولة. إخضاع
الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره قد يبدو إجراءً رقابيًا، لكنه في ظل غياب مؤسسات مستقلة، يتحول إلى أداة للهيمنة. أما حصر شراء وتسويق الذهب في جهة واحدة، تلتزم بتوفير العملة الصعبة للمستوردين، فهو احتكار صريح، يُسلم عملية التسويق والتصدير لفرد أو جهة بعينها، تُحدد الأسعار، وتُقرر من يستحق الحصول
على النقد الأجنبي، ومن يُقصى.
هذا التحول من اقتصاد السوق إلى اقتصاد مركزي احتكاري لا يُدار عبر مؤسسات رقابية مستقلة، بل عبر
شبكات سلطوية تُعيد إنتاج نموذج الدولة الريعية، حيث تُحتكر الموارد وتُوزع الامتيازات على أساس الولاء لا
الكفاءة. غياب الشفافية والمساءلة في تحديد الجهة المحتكرة، وآليات التسعير، والضمانات التي تحمي المعدنين، يُعد بيئة خصبة للفساد، ويُضعف ثقة المواطنين في الدولة، ويُحول القرارات الاقتصادية إلى أدوات للهيمنة لا
للتنمية.
والأخطر من ذلك، أن الاجتماع خلص إلى اعتبار تخزين أو حيازة الذهب من غير مستندات رسمية جريمة
تهريب، بغض النظر عن الموقع أو الكمية. هذا يعني ببساطة أن من لا يخضع للسعر الذي تحدده الجهة
المحتكرة، يُصادر ذهبه ويُزج به في السجن، في مشهد يُعيد تعريف الجريمة لا علاقة لها بالفساد أو النهب، بل بعدم الانصياع لسلطة التسعير. إنها سياسة تُجرّم الفقراء، وتُحصّن أصحاب النفوذ، وتُعيد إنتاج منطق العقوبة لا منطق العدالة.
تفعيل دور قوات مكافحة التهريب، وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة، لا يُقرأ إلا في سياق عسكرة
المورد الاقتصادي، وتحويل مؤسسات الدولة الأمنية إلى أدوات لحماية مصالح نافذين داخل السلطة. فحين
تُستخدم القوة لضبط الذهب، لا لضبط السوق، يُصبح التهريب نفسه جزءًا من منظومة القرار، ويُصبح الأمن
الاقتصادي مرهونًا بمن يملك النفوذ، لا بمن يملك الحق.
الذهب، كمورد اقتصادي استراتيجي، لم يعد يُدار بمنطق الإنتاج، بل بمنطق الحرب. حين يُستخدم لضبط
الولاءات، وتمويل شبكات النفوذ، وتحييد الخصوم، يُصبح الاقتصاد نفسه أداة سياسية، لا تنموية. هذه السياسات تُقصي آلاف العاملين في القطاع غير الرسمي، خاصة المعدنين التقليديين، وتُهدد مصادر رزقهم، وتُحولهم إلى (مجرمين) في نظر القانون، مما يُفاقم التوتر الاجتماعي ويُضعف الاستقرار.
لم تمر هذه السياسات دون انتقادات دولية. فقد صنّفت مؤسسة Brand Vision السودان ضمن أسوأ ثمانية
اقتصادات في العالم لعام 2025، مشيرة إلى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 37.5%،
وارتفاع التضخم إلى 146%، واعتماد الحكومة على طباعة النقود لتغطية العجز. هذه المؤشرات الكارثية
تعكس غياب أي برنامج اقتصادي واضح، وتُظهر أن الأزمة ليست مجرد خلل في السياسات، بل انهيار في
منظومة الحكم الاقتصادي.
من زاوية تحليلية، يبدو أن تشكيل اللجنة والقرارات المصاحبة لها تُعيد إنتاج تجارب سابقة فاشلة، حيث يُستخدم الاقتصاد كأداة للسيطرة السياسية، لا كوسيلة للإنقاذ الوطني. الاعتماد على لجان طوارئ وإجراءات أمنية لا يعكس فهمًا علميًا لإدارة الاقتصاد، بل يعكس تخبطًا وتهربًا من المسؤولية. هذه الحزمة الاقتصادية، وإن بدت متماسكة شكليًا، إلا أنها قديمة متجددة، لا تتناسب مع حجم التدهور الحالي، وتُغلق الطريق أمام أي مسار تفاوضي جاد.
حين تُدار الموارد بهذه الطريقة، تُصبح الحرب وسيلة لحماية الامتيازات، لا أزمة يجب حلها. استمرار الحرب
يُخدم مصالح من يحتكرون الذهب، ويُحول الاقتصاد إلى ساحة صراع، لا إلى أداة لبناء الدولة. في هذا السياق، لا تُدار الدولة بمنطق الإنقاذ، بل بمنطق الهيمنة. ولا تُبنى السياسات على أسس وطنية، بل على حسابات ضيقة، تُغلق أبواب المستقبل، وتُحكم إغلاق نوافذ الأمل.