دولة “56” ومؤتمر السودنة الثاني المقترح

عبدالحافظ سعد الطيب
وما كان يمكن النظر إليها كفشل مطلق أم تجربة مركّبة فيها بعض الإيجابيات رغم هشاشتها البنيوية.
من أجل كل الحقيقة
في البدء لست بصدد استقطاب سياسي اوخلق تشاكس
تاريخيًا: اليسار السوداني، وعلى رأسه الحزب الشيوعي، هو من أدخل مصطلح “المشكل السوداني” إلى قلب الخطاب السياسي بصفته أزمة بنيوية لا مجرد صراع محلي أو جهوي.
بتسلسل تاريخي وفكري واضح:
💥أولًا: مؤتمر المائدة المستديرة (1965)
هذا المؤتمر عُقد لمناقشة أزمة الجنوب، التي كانت آنذاك توصف بـ”التمرد”.
الأحزاب التقليدية (الأمة، الاتحادي، جبهة الميثاق الإسلامي حاليا هم الذين يحكمونا غصب لمدة 36 عام ) طرحت المسألة كأزمة أمنية أو تمرد انفصالي.ولازال
💥الحزب الشيوعي السوداني رفض هذا الطرح، وأكدوا أن ما يحدث هو أزمة وطنية ناتجة عن خلل في بنية الدولة منذ الاستقلال. بمعنى انه لازال ينشر في الوعي حول حل الازمة السودانية
🔴 التحوّل الذي قام به اليسار هنا هو إعادة تعريف الأزمة:
ليست “أزمة جنوب”، بل أزمة مشروع وطني فاشل أنتج التهميش، والمركزية، والتمييز الإثني والثقافي.
ثانيًا: مساهمة اليسار الحزب الشيوعي السوداني في تحليل الأزمة
💥الحزب الشيوعي منذ الستينات بدأ يتحدث عن “المسألة القومية”، و”الاستعمار الداخلي”، و”البرجوازية الطفيلية”.
في منشوراته وتحليلاته (منها وثيقة 1971، وبرنامج 1977، والبرنامج الانتقالي 1986)، أكّد أن:
التهميش ليس فقط في الجنوب، بل يشمل دارفور، جبال النوبة، شرق السودان، النيل الأزرق.
الأزمة السودانية هي نتاج تحالف طبقي-ثقافي-سياسي يسيطر على الدولة من المركز. والمركز ليس الشمال والخرطوم بل اقتصادي
ثالثًا: الحزب الشيوعي حول دارفور
في حين كانت أغلب القوى التقليدية تصف ما يحدث في دارفور بأنه صراع قبلي، أو مجرد تمرد محلي،
كان الحزب الشيوعي أول من قال إن دارفور تعاني من نفس التهميش البنيوي الذي تعانيه بقية الأطراف.
بعض المفكرين اليساريين (داخل وخارج الحزب) مثل عبد العزيز حسين الصاوي، تاج السر مكي، الحاج وراق، وعبد الله علي إبراهيم ساهموا في تفكيك هذا التناول.
النتيجة:
نعم، الحرب الشيوعي السوداني هو من بلور خطاب “المشكل السوداني” كأزمة دولة وليس مجرد صراع محلي.
هو الذي قدّم تحليلًا بنيويًا للمركز والهامش، للطبقة والدولة، للهوية الثقافية، وهوية المشروع الوطني.
وبذلك فتح الطريق نظريًا أمام حركات الهامش المسلحة والمدنية لكنهم اهملوا متابعة النجاح (المسألة شبية بطرحة برنامج مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية المتبني الان حتى من قبل اليمين) الا الان : يحاربون المركز الجغرافي يعقدون التسويات لاعادة إنتاجه ابتعدوا عن السلطة يقولون ، بل نحارب نظامًا فكريًا واقتصاديًا وثقافيًا أقصى الجميع ما عدا نفسه.
وهنا هذا المركز يعيد إنتاج نفسه بتسويات مع الحركات المسلحة
🔻نقطة أخيرة مهمة:
رغم هذا الدور الريادي، إلا أن اليسار نفسه لم يسلم من أخطاء، مثل:
تقصيره في التواصل الشعبي العريض. وعدم وجوده بجانب الحركات المسلحة هو ماادي الي فقدانها بوصلة الثورة وأهداف وقضايا شعوبها
ضعف التحالفات الاستراتيجية مع الجماهير المنتجة للخيرات المادية وهي لازالت في الهامش. وللحق الان يصلح في اخطائة بين الجماهير وهذا مايغضب
الفصائل المهادنة النظام أو الاستسلام للواقع الليبرالي
لكن رغم كل ذلك، يبقى دوره في طرح وتأسيس خطاب “المشكل السوداني” واضحًا ومتقدّمًا على كل التيارات الأخرى.
الجواب المختصر:
لا، لا يمكن القول إن دولة 56 كلها سوء جملة وتفصيلًا. هي تجربة فاشلة على مستوى بناء الدولة/الأمة، نعم، لكنها ليست فراغًا محضًا ولا ظلامًا دامسًا. لقد حدثت فيها محاولات للبناء، وأُنجزت بعض الأشياء، لكن هذا لا يلغي فشلها الجذري في المهام الكبرى: الوحدة الوطنية، العدالة الاجتماعية، التنمية المتوازنة، وبناء هوية سياسية جامعة.
مقترحات لحل المسألة في نقاط
ما الذي تحقق جزئيًا؟
تأسيس مدن تكونت فيها اللحمة السودانيه مثل الأبيض، مدني، الفاشر، بورتسودان، نيالا كمراكز إدارية واقتصادية، رغم عدم شمولية أو عدالة التنمية.
شبكات تعليمية أولية أنتجت طبقة من المتعلمين والمثقفين (الذين قادوا لاحقًا الثورات والانقلابات معًا!).أيضا منهم من يخون الا الان قضايا شعوبه
بنية تحتية أساسية (طرق، سكك حديد، مشاريع زراعية كمشروع الجزيرة، خزان سنار).نعلم ان م الجزيره اسسة المستعمر لمصااحة
تجربة ديمقراطية ولو ناقصة في فترات قصيرة من عمر الدولة.
ثقافة سياسية وشعرية وموسيقية ساهمت في التأسيس لوجدان سوداني (مثال: إذاعة أمدرمان، المسرح القومي، شعر الحقيبة، أغاني المقاومة).
ثورات شعبية (64، 85، 2018–2019) كانت في ذاتها علامات على الوعي الشعبي والحس الجماعي الرافض للديكتاتورية.
❌ ما الذي لم يُنجز (وهو الأخطر)؟
لم تُبْنَ أمة بالمعنى الحقيقي: لم تتشكل هوية وطنية موحدة، بل بقيت البلاد موزعة بين هويات إثنية/جهوية/دينية.
فشلت الدولة في إعادة توزيع السلطة والثروة، بل كرّست المركزية بشكل أكثر ضراوة.
تحوّلت النخب الحاكمة إلى وكلاء لمصالح خارجية أو لمصالحهم الذاتية.
الجيش لم يكن جيشًا وطنيًا جامعًا بل كان أداة لإعادة إنتاج المركز وقمع الهامش.
لم تُبنَ دولة قانون، ولم تُحسم مسألة العلاقة بين الدين والدولة، أو بين العسكر والمدنيين.
❗إذن، كيف نفسّر الأمر؟
السودان منذ 56 لم يكن “دولة” بالمعنى الكامل، بل مشروعًا معلقًا، هشًا، تهيمن عليه بنية استعمار داخلي:
دولة دون أمة، سلطة دون مشروع، إدارة بلا عدالة.
ولكن وسط هذا الخراب، أنتج الشعب السوداني نضالًا ملحميًا لا يمكن تجاهله، وجاءت الثورات كأهم ما أنجزته دولة 56 من أسفل، لا من فوق. الثورات ليست ضد دولة 56 فقط، بل هي في جزء منها استمرار لمحاولات تأسيس أمة حقيقية—لكنها حتى الآن هُزِمت أو أُجهضت.
📝 خلاصة سياسية:
من الخطأ اختزال دولة 56 في الفشل فقط، لكن يجب إدراك أن بعض مظاهر البناء كانت سطحية أو غير عادلة أو جاءت رغم الدولة لا بفضلها.
لا يمكن بناء المستقبل دون تفكيك بنية 56 وإعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة: لامركزية حقيقية، عدالة انتقالية، جيش وطني جديد، علمانية عادلة، اقتصاد تضامني، وهوية جامعة.


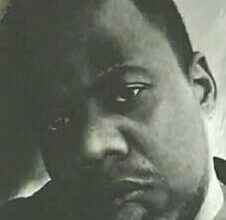

ايها الشعب لا تقبلوا الفساد و المفسدين . ما في شئ فوق القانون و الدستور. الهمجية التي يقودها الانقلاب و إلى الآن لابد أن تنتهي. ايها الشعب ، لو نظرتم لحالكم الذى أبكى العدو و الدواب من شدة ما انتم عليه من شتات و تخبط و سذاجة مما جعلكم خاضعين للاوغاد و الرجعيين و الهوام من قبيلة العسكر و السلفيين و أصحاب النفوس المريضة. ايها الشعب ما أكثر اغبياءكم و العالم في فن التطبيقات و تقنيات لا تتوقف عند حد معين ايها الشعب لم تتعرفوا على السباكة او خدمة الاسعاف و في جوع و أمراض. رعايا دولة يعتلي مناصب ادارتها شذاذ الآفاق و تعادون أمثال حمدوك!! محن !!! و الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث فتأمل!