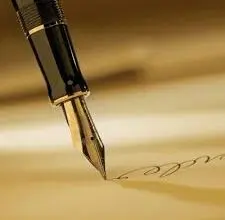ليست الأزمة الاقتصادية في السودان مجرد عجز في الأرقام أو خلل في الموازنة، بل هي سؤال فلسفي عميق عن معنى الدولة ومصير الشعوب حين تتحول السلطة إلى غنيمة، وتصبح الحرب قدرًا يوميًا.
فالأمم، كما قال ابن خلدون، تنهض حين تتماسك عصبيتها الجامعة، وتنهار حين تتفكك الروابط بين الناس وتستبدّ فئة قليلة بالثروة والقوة. والاقتصاد ليس حسابًا مصرفيًا معزولًا، بل هو صورة لحياة الناس، مرآة لكرامتهم، وميزان لعدالتهم. وحين يفقد هذا الميزان توازنه، فإن ما ينهار ليس الجنيه ولا الناتج المحلي فقط، بل فكرة الوطن ذاته.
منذ اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٣ دخل السودان نفقًا مظلمًا، حيث انكمش الناتج المحلي بنسبة ٤٠٪ في عام واحد (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، مع توقعات بمزيد من الانكماش عند -٠٫٤٪ في ٢٠٢٥ (صندوق النقد الدولي). أما الناتج المحلي الاسمي فقد تراجع إلى نحو ٤٩٫٩ مليار دولار في ٢٠٢٤ (البنك الدولي)، بينما يبلغ بالقيمة الحقيقية (تعادل القوة الشرائية) حوالي ٢٢٣ مليار دولار (موقع وورلد إيكونوميكس). التضخم تجاوز ١٢٠٪، مع توقعات ببلوغه ١١٩٪ خلال ٢٠٢٥ (مجلة أفريكان بيزنس)، ما جعل الجنيه السوداني يفقد قيمته بوتيرة متسارعة أمام الدولار، إذ تجاوز سعر الصرف في السوق الموازي ١٢٠٠ جنيه للدولار الواحد (تقارير اقتصادية محلية).
خسر السودان منذ اندلاع الحرب ما يقارب ٤٫٦ مليون وظيفة (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة خصوصًا بين الشباب. وارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من ٧ ملايين شخص إضافي (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، ليصبح أكثر من نصف السكان في دائرة الفقر متعدد الأبعاد. أما من حيث الأمن الغذائي، فإن ٢٤٫٦ مليون مواطن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم من يضطر لتناول النباتات البرية للبقاء على قيد الحياة (وكالة أسوشيتد برس).
وعلى الصعيد الاجتماعي، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى نزوح داخلي يقدَّر بأكثر من ١٠ ملايين شخص منذ اندلاع القتال (الأمم المتحدة، مكتب الشؤون الإنسانية)، ليصبح السودان أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم. أما التعليم فقد انهار عمليًا، إذ إن أكثر من ١٩ مليون طفل حُرموا من التعليم بسبب الحرب وإغلاق المدارس (منظمة اليونيسف)، فيما يعاني النظام الصحي خسائر تفوق ١١ مليار دولار نتيجة تدمير المستشفيات ونقص الكوادر الطبية (وكالة رويترز).
أما البنية التحتية فقد أصابها دمار شامل، إذ تحتاج الخرطوم وحدها إلى ٣٠٠ مليار دولار لإعادة إعمارها (وكالة رويترز)، بينما تتجاوز فاتورة الدمار على مستوى السودان أكثر من تريليون دولار (وكالة رويترز). وفي جانب الموارد، بلغ إنتاج الذهب في ٢٠٢٤ نحو ٨٠ طنًا بقيمة تزيد عن ٦ مليارات دولار (صحيفة فايننشال تايمز)، لكن أكثر من نصف هذه الكمية يُهرَّب إلى الخارج عبر شبكات غير شرعية مرتبطة بالصراع، مما يحرم الدولة من عائداتها.
ولعل من أخطر ما يضاعف هذه الأزمة وجود حكومتين متنازعتين؛ واحدة في بورتسودان والأخرى في نيالا. هذا الانقسام لا يخلق فراغًا دستوريًا فقط، بل يزيد من تفتت الموارد وازدواجية القرار، ويجعل الاقتصاد رهينة لصراع الشرعيات بدل أن يكون مجالًا للتنمية. التجارب التاريخية تُظهر أن وجود حكومتين داخل بلد واحد يحوّل الدولة إلى ساحة تناحر لا إنتاج، ويجعل المواطن يدفع الثمن مضاعفًا في حياته اليومية.
في مواجهة هذا الخراب، لا تكفي لغة الرثاء ولا التوصيف البارد، فالسؤال الحاسم هو؛ كيف نخرج الآن وغدًا من هذه الهوة السحيقة؟ على المدى الآني، لا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن يبدأ قبل إسكات صوت البنادق ووقف الحرب، إذ إن النزيف العسكري يبتلع كل موارد الدولة. هنا تبرز ضرورة إنشاء غرفة طوارئ اقتصادية تحت إشراف محايد، تضم خبراء سودانيين ودعمًا أمميًا، لإدارة الغذاء والدواء بصورة شفافة تمنع الاحتكار والفساد.
السيطرة الفعلية على قطاع الذهب باتت ضرورة وجودية، لا مجرد مطلب اقتصادي، عبر فرض رقابة صارمة وربط جزء من العملة الوطنية باحتياطي الذهب لتقليص التضخم المنفلت. أما تحويلات السودانيين بالخارج، التي تتجاوز مليارات الدولارات سنويًا، فينبغي أن تُستقطب بقنوات رسمية بأسعار قريبة من السوق الموازي، بدل أن تضيع في شبكات المضاربة. كذلك يجب فتح الموانئ وتفعيل الصادرات الزراعية والحيوانية بسرعة، بترتيبات مؤقتة وشفافة، لتأمين العملات الصعبة وتخفيف الضغط على الجنيه. هذه خطوات إسعافية، لكنها تمنح الجسد المتهالك فرصة لالتقاط أنفاسه.
أما على المدى الاستراتيجي، فإن المعركة الحقيقية تكمن في إعادة بناء الدولة على أساس عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة والعدالة وتوزيع الموارد بعدالة بين الأقاليم. لا بد من تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الذهب والزراعة التقليدية، عبر إدخال الصناعات التحويلية، وتبني التكنولوجيا الزراعية، وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الذي يجعل السودان جسرًا بين إفريقيا والعالم العربي.
كما أن إصلاح النظام المصرفي وربطه بالنظام المالي العالمي ضرورة ملحّة لبناء ثقة المستثمرين واستعادة دورة رأس المال. الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس: تعليم مهني يخلق جيلًا قادرًا على الإنتاج، وتمويل مشاريع صغيرة تدعم الطبقة الوسطى وتعيد لها دورها التاريخي كضامن للاستقرار. ومن أجل المستقبل، ينبغي إنشاء صندوق سيادي تُودع فيه عائدات الموارد الاستراتيجية مثل الذهب والزراعة، بعيدًا عن أيدي الفساد والمحسوبية، ليكون صمام أمان للأجيال القادمة. إن هذه الحلول، آنية كانت أم استراتيجية، ليست وصفة اقتصادية مجردة، بل معركة سياسية وأخلاقية في المقام الأول. فإما أن تُنفذ بإرادة وطنية جامعة، أو ستظل حبرًا على ورق، فيما ينزلق السودان أكثر فأكثر إلى قاع الفوضى.
إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان ليست أزمة أرقام وحسابات مصرفية فحسب، بل هي أزمة قيِّم ومعنى، أزمة ثقافة سياسية انهارت أمام سطوة السلاح والفساد، وأزمة مجتمع أُريد له أن يعتاد الخراب حتى يفقد مناعته. حين يتعوّد الناس على العيش بلا كهرباء، بلا دواء، بلا مدارس، بلا أمن غذائي، فإن الخطر الأكبر لا يكمن في الفقر نفسه، بل في تحوّله إلى “ثقافة عادية”، إلى نمط حياة يُعاد إنتاجه جيلاً بعد جيل. هنا يتجاوز الانهيار الاقتصادي حدوده التقنية ليصبح انهيارًا اجتماعيًا ثقافيًا، ينخر في جذور المجتمع ويحوّل الإنسان من مواطن له حقوق إلى كائن يلهث خلف البقاء.
فالاقتصاد ليس مجرد تبادل للسلع، بل هو تجسيد للقيم التي تحكم حياة الناس. فإذا كانت العدالة غائبة، تصبح الأسواق ساحة للنهب، وإذا كانت الأخلاق مستباحة، فإن الثروة تتحول إلى وقود للحرب، وإذا كان العقل الجمعي مثقلاً بالكراهية والانقسام، فإن أي مشروع للتنمية يتحوّل إلى سراب. من هنا نفهم أن جوهر المشكلة سوداني بالأساس، قبل أن يكون مؤامرة خارجية أو لعبة مصالح دولية، وأن الحل لن يأتي من عواصم العالم بل من داخل هذه الأرض التي أنجبت أعظم الثورات والانتفاضات.
ثقافيًا، يدفع السودان ثمن التهميش التاريخي للمعرفة والتعليم والإبداع. أمة أهملت مدارسها وجامعاتها، وقمعت مفكريها، وضيّقت على مثقفيها، لا يمكن أن تنتج اقتصادًا قويًا. فالمجتمع الذي يطرد عقله المفكر لا بد أن يقع أسيرًا لمغامري السلاح وتجار الذهب. أما اجتماعيًا، فإن التمزق الإثني والقبلي، واستغلال الدين في السياسة، جعل الاقتصاد مجرد انعكاس لتوازنات القوة لا لحاجات الشعب. إن بقاء هذه التشققات يعني أن كل محاولة إصلاح اقتصادي ستظل معلّقة في الهواء.
إن لكل أمة لحظة مواجهة مع نفسها. ولعل اللحظة السودانية قد حانت، إما أن نعيد بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والمعرفة، وإما أن نستسلم لقدر الانهيار. ليست القضية كيف نعيد الإعمار بعد تريليون دولار من الدمار، بل كيف نعيد المعنى إلى فكرة الوطن، وكيف نعيد الثقة بين المواطن والدولة، وكيف نكسر الحلقة الجهنمية التي تجعل من الحرب اقتصادًا، ومن الفساد نظام حكم، ومن الفقر أسلوب حياة.
هنا يكمن التحدي، هل نسمح للأجيال القادمة أن ترث بلدًا محطمًا، أم نصنع من محنتنا بداية جديدة؟ التاريخ لا يرحم الأمم التي تتنازل عن حقها في البقاء، والثقافة لا تشفق على الشعوب التي تهجر العقل، والفلسفة لا تُنصف من يفرّط في معنى الحرية. السودان أمام مفترق طرق، إما نهضة تقودها الإرادة الشعبية الواعية، وإما سقوط حر يجعل من أرض النيلين مجرد هامش منسي في خرائط العالم.
إنها لحظة الحقيقة، لحظة لا ينفع فيها التبرير ولا التعلّل. فإما أن ننهض ونكسر القيود التي كبّلتنا، أو نترك أنفسنا فريسة لأرقام تتزايد خرابًا كل عام. وحينها لن تبقى لنا دولة نختلف حولها، ولا وطن نتجادل في هويته، بل ركام منسي، وشعب تائه فقد البوصلة. والسؤال الذي سيبقى معلقًا في عنق كل جيل، هل ضيعنا السودان إلى الأبد، أم صنعنا من جراحه ميلادًا جديدًا؟