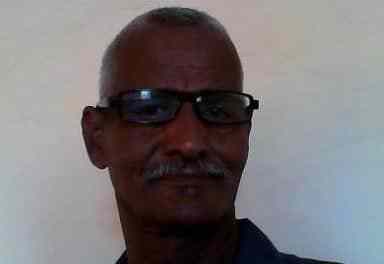تطور الموقف الأمريكي تجاه قضايا السودان….من نشوة الثورة إلى منطق المحاسبة (٢٠١٩ – ٢٠٢٥)

منذ عام ١٩٩٧، حين فرضت إدارة بيل كلينتون عقوباتها الأولى على السودان، ارتبط اسم الخرطوم في الذاكرة الأمريكية بملفات الإرهاب، ثم بملف دارفور الذي استخدمته واشنطن في العقد الأول من الألفية كدليلٍ على التزامها “الإنساني” بعد غزو العراق. ومع إدارة باراك أوباما ظهر الوجه الأكثر حذرًا للسياسة الأمريكية، إذ حاولت واشنطن إجراء تطبيعٍ ناعمٍ مع نظامٍ كانت تعتبره خصمًا أيديولوجيًا. لكن النتيجة كانت واحدة؛ سياسةٌ لا تريد انهيار النظام ولا تريد نجاحه.
أصبح السودان ساحةً لتجريب أدوات “الدبلوماسية العقابية”، حين استخدمت واشنطن ملفات عديدة لتبرير التدخلات الإنسانية الأفريقية ذات الطابع القانوني. ومع مرور الوقت أدرك الأمريكيون أن السودان ليس هامشًا جغرافيًا، بل محورًا يربط بين البحر الأحمر والقرن الإفريقي وحزام الساحل، وهي مناطق تتنازعها قوى كبرى مثل الصين وروسيا وتركيا، فضلًا عن نفوذ الخليج.
في هذا السياق، ظلت واشنطن تتعامل مع السودان بقدرٍ من الحذر والريبة، لا تراه دولةً يمكن الوثوق بها، ولا خصمًا يمكن تجاهله. ومع اندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٨، وُضع أمام الإدارة الأمريكية امتحان جديد؛ كيف يمكن دعم التحول الديمقراطي في بلدٍ تسيطر عليه المؤسسة العسكرية وتتحكم فيه مصالح إقليمية متناقضة؟
ثم جاءت ثورة ديسمبر ٢٠١٨ لتكسر الصمت القديم، وتضع أمام الولايات المتحدة سؤالًا وجوديًا عن معنى القيم التي تتغنّى بها في العالم. كانت واشنطن تتابع المشهد كمن يرى في البعيد انعكاسًا لوجهه؛ شعبٌ خرج يطالب بالحرية والسلام والعدالة، ولكن من دون قيادةٍ موحدة، ومن دون ضماناتٍ بأنّ الديمقراطية الوليدة لن تُختطف من جديد. وفي تلك اللحظة بدا الموقف الأمريكي كأنه صراعٌ بين ضميرين؛ ضميرٍ يريد دعم التغيير، وضميرٍ آخر يخشى الفوضى.
في الأسبوع الذي تلا سقوط نظام عمر البشير في أبريل ٢٠١٩، امتلأت مراكز القرار الأمريكية بتحليلاتٍ متناقضة. بعضهم رأى أنّ السودان فرصةٌ نادرة لبناء نموذجٍ مدنيٍّ جديد في إفريقيا، وآخرون حذّروا من أن المدنيين لا يملكون أدوات السيطرة، وأنّ العسكر سيتربّصون بالانتقال ليعيدوا إنتاج الدولة القديمة. وكانت تلك هي بذرة التردّد الأمريكي التي ستطبع الموقف لسنواتٍ لاحقة؛ بين الانبهار بالثورة والريبة من ثمنها، وبين الخطاب الأخلاقي والبرود السياسي.
واشنطن، التي طالما رفعت راية الديمقراطية، وجدت نفسها أمام اختبارٍ ميدانيٍّ في بلدٍ لم يهدأ يومًا. فقد تعلّمت من تجاربها السابقة في ليبيا والعراق أنّ دعم الثورات بلا خطةٍ نهائية يؤدي إلى الفوضى، لذلك اختارت في البداية ما تسميه مراكز أبحاثها “الصبر الاستراتيجي”، أي الانتظار الموجّه؛ مراقبة الأحداث دون التدخل المباشر.
غير أنّ السودان، كعادته، لم يمنح المراقبين وقتًا طويلًا للتفكير. في غضون أشهرٍ قليلة تحولت الفرحة بالثورة إلى أسئلةٍ صعبة حول إدارة السلطة، وبدأت واشنطن تُدرك أنّ مشكلتها ليست مع النظام القديم فحسب، بل مع بنية الدولة نفسها. ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحوّل الكبرى؛ من التشجيع إلى الردع، ومن الدبلوماسية الناعمة إلى المحاسبة العلنية، ومن الوعد الأخلاقي إلى الحساب المالي.
ليتلخّص الموقف الأمريكي تجاه السودان منذ ٢٠١٩ في ثلاثة خطوطٍ متداخلة
الأول هو التحفّظ السياسي الذي ميّز المراحل الأولى للثورة، والثاني التصعيد القانوني بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، والثالث التحوّل الأخلاقي بعد اندلاع الحرب في ٢٠٢٣، حين اكتشفت واشنطن أنّ ما يجري في السودان ليس صراعًا على السلطة فحسب، بل اختبارٌ لضمير العالم بأسره.
قال الرئيس جوزيف بايدن في خطابٍ متلفز عام ٢٠٢٣؛ “ما يجري في السودان ليس نزاعًا محليًا فحسب، بل مأساة إنسانية تضع العالم أمام امتحانٍ جديدٍ في الدفاع عن الكرامة البشرية”. وبذلك أعلن رسميًا تحوّل السياسة الأمريكية من المراقبة إلى الفعل. فلم تعد القضية شأنًا إفريقيًا، بل مرآةً لما تبقى من إنسانية العالم.
في الأسابيع الأولى اكتفت واشنطن بإصدار بيانات القلق ودعوات ضبط النفس، وكأنها تراقب من بعيد لتتبين وجهة الرياح. وعندما سقط نظام عمر البشير في أبريل ٢٠١٩، انتقلت فجأة من مقعد المتفرّج إلى مقعد الراعي الحذر، إذ رأت في السودان فرصةً لاستعادة نفوذها في إفريقيا بعد سنواتٍ من التراجع.
ومع صعود الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، بدا لواشنطن أن السودان يمكن أن يكون نموذجًا لتحالف الديمقراطية والأسواق، حيث يتلاقى الإصلاح الاقتصادي مع قيم الحرية السياسية. إلا أن ضعف المؤسسات وتربّص العسكر وتشتت القوى المدنية جعل الموقف الأمريكي يتأرجح بين الحماسة والتردد. وفي يونيو ٢٠١٩، بعد مجزرة القيادة العامة، اكتفت الولايات المتحدة بتعيين مبعوثٍ خاص هو دونالد بوث لمتابعة التطورات، بينما بقيت على مسافةٍ حذرة من الشارع الثائر.
وجاء التحول الأبرز في أكتوبر ٢٠٢٠ حين أعلن الرئيس دونالد ترمب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد اتفاقٍ مالي لتسوية قضايا التعويضات مع ضحايا العمليات الإرهابية. القرار بدا في ظاهره مكافأةً للانتقال الديمقراطي، لكنه في جوهره كان خطوةً مشروطة بمصالح اقتصادية واستراتيجية، لا التزامًا أخلاقيًا خالصًا. فواشنطن أرادت أن تكافئ السودان سياسيًا قبل أن يكتمل نضجه المؤسسي، وهو ما فتح الباب أمام هشاشةٍ لاحقة في العلاقة.
ثم جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ليكشف حدود ذلك التردد. فحين أطاح الفريق عبدالفتاح البرهان بالحكومة المدنية، أعلنت واشنطن تعليق مساعداتٍ بقيمة سبعمئة مليون دولار، وصرّحت بأن “الانقلاب العسكري يقوّض تطلعات الشعب السوداني”. وبعدها فرضت وزارة الخزانة برئاسة جانِت يلين عقوباتٍ على قوات الاحتياطي المركزي لتورطها في قمع المتظاهرين، مؤكدةً أن “المؤسسات الأمنية التي تستخدم موارد الدولة لإيذاء المدنيين ستُحاسب”. كان ذلك بداية مرحلة الردع المالي، حين انتقلت واشنطن من لغة النصح إلى لغة المحاسبة.
وعندما اندلعت حرب أبريل ٢٠٢٣، بين الجيش وقوات الدعم السريع، دخلت الولايات المتحدة مرحلةً جديدة عنوانها الردع الاقتصادي الذكي. ليصدر بايدن أمرًا تنفيذيًا يتيح تجميد أصول كل من يهدد استقرار السودان ويقوّض الانتقال الديمقراطي. وأعلن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان أن ما يحدث في السودان “إهانةٌ لضمير العالم”، مؤكدًا أن واشنطن ستفرض قيودًا على من يواصل الحرب ويعرقل المساعدات. وفي اليوم ذاته، قالت وزيرة الخزانة جانِت يلين إن بلادها “تغلق شرايين التمويل التي تغذي آلة القتل في السودان”، لتبدأ فعليًا هندسة الردع المالي الموجّه ضد أطراف الصراع.
منذ ذلك الوقت تحركت الرباعية الدولية التي ضمّت حينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، كمنصة دعمٍ للانتقال السياسي، لكنها ما لبثت أن تحوّلت بعد الانقلاب ثم الحرب إلى أداة ضغطٍ دولية، فأكدت في بياناتها المتتالية أن “أي سلطة لا تستند إلى المدنيين لا شرعية لها”. ومع انطلاق مفاوضات جدة عام ٢٠٢٣، قادت الرباعية محاولات الوصول إلى هدنةٍ إنسانية دون أن تنجح في وقف القتال، لكنها رسّخت للمرة الأولى مفهوم “المحاسبة المشتركة”.
وفي منتصف ٢٠٢٤ أصبحت بيانات الرباعية أكثر حزمًا ومتطابقة في لهجتها مع خطابات الخارجية الأمريكية. وحين أعلنت واشنطن في يناير ٢٠٢٥ أن ما جرى في دارفور يرقى إلى الإبادة الجماعية، أصدرت الرباعية بيانًا أكدت فيه أن “العدالة شرطٌ لا يمكن تجاوزه لتحقيق السلام”. وفي سبتمبر من العام ذاته دعت إلى هدنةٍ إنسانية لثلاثة أشهر ووقفٍ لأي تدخلٍ خارجي، محمّلةً الدول الممولة للسلاح والمال مسؤولية استمرار الحرب.
وفي يناير ٢٠٢٥ أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسميًا أن ما حدث في دارفور “إبادة جماعية ارتكبتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة”، مؤكدًا أن واشنطن “ستلاحق الجناة في كل مكان”. تلا ذلك فرض عقوباتٍ على محمد حمدان دقلو (حميدتي) ثم على عبدالفتاح البرهان، في خطوةٍ فُسرت بأنها تأكيد على توازن العدالة. وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو أن بلاده “ستواصل تعطيل تدفق السلاح والتمويل إلى القادة العسكريين الذين يستهينون بحياة المدنيين”، بينما صرّح وكيل الخزانة برادلي سميث بأن “الشركات الممولة للحرب ستُعامل كمنظماتٍ إجرامية عابرةٍ للحدود”. وفي أبريل ٢٠٢٥ عُيّن مسعد بولس مستشارًا رئاسيًا لشؤون إفريقيا، فأكد في أول تصريحٍ له أن “السياسة الأمريكية تجاه السودان تقوم على السلام والشراكة والازدهار، وأن المساعدات ليست ورقة مساومة بل التزامٌ أخلاقي”.
في الوقت نفسه تصاعد البعد الإنساني في الخطاب الأمريكي؛ قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن “المجاعة في السودان ليست كارثةً طبيعية بل جريمةٌ متعمدة”، وأعلنت واشنطن في يونيو ٢٠٢٤ مساعداتٍ بقيمة ثلاثمئة وخمسة عشر مليون دولار. وفي مجلس الأمن، حذرت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد من “عودة دارفور إلى مسرح الجرائم الإنسانية”، مؤكدةً أن “العالم يجب أن يستيقظ على الكارثة أمامه”. وفي الكونغرس شدّد كريس كونز، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، على أن “القتال في السودان كارثيٌّ على المدنيين”، فيما وصف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيم ريش الصمت الأمريكي بأنه “تواطؤٌ أخلاقي”.
ليظهر التناقض والتردد في تراجع الدور الإنساني الأمريكي بصورةٍ لافتة منذ مطلع عام ٢٠٢٥، بعد أن كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تشكّل العمود الفقري لجهود الإغاثة، ممولةً نحو ٤٤٪ من إجمالي الاستجابة الإنسانية الدولية خلال عام ٢٠٢٤، بميزانيةٍ قاربت ٧٠٠ مليون دولار. لكنّ القرار التنفيذي رقم ١٤١٦٩ الذي أصدره الرئيس الأمريكي في يناير ٢٠٢٥ أدّى إلى تجميد أكثر من ٨٠٪ من أنشطة الوكالة حول العالم، بما في ذلك السودان. ووفق تقارير مشروع “آيه كابس” عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، توقّفت نحو ٨٠٪ من المطابخ المجتمعية ومراكز الإغاثة المموّلة أمريكيًا، باستثناء بعض برامج “الإنقاذ الحياتي” كالدواء والغذاء الطارئ. هذا التراجع المفاجئ عمّق الفجوة الإنسانية في السودان وترك ملايين المدنيين في مواجهة الجوع والمرض، بينما اكتفت واشنطن ببيانات القلق وعبارات التعاطف الأخلاقي.
وبعد ستّ سنواتٍ من الثورة يمكن القول إن الموقف الأمريكي مرّ بثلاث مراحل؛
مرحلة التشجيع (٢٠١٩–٢٠٢٠) التي ركّزت على رفع العقوبات والدعم الرمزي، ثم مرحلة الردع (٢٠٢١–٢٠٢٣) عبر العقوبات ومراجعة العلاقات، وأخيرًا مرحلة المحاسبة (٢٠٢٤–٢٠٢٥) التي شهدت توصيف الإبادة وتفعيل الرباعية كأداةٍ للضغط الدولي. ومع ذلك بقيت الفجوة بين القول والفعل واسعة. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس مايك ماكول إن “البيانات لا تُسكت المدافع، والتصريحات لا توقف القتل”، وهي عبارة تختصر المأزق الأخلاقي الذي تعيشه واشنطن بين ضميرها الإنساني ومصالحها السياسية.
بلغ الموقف الأمريكي ذروة النضج الأخلاقي دون أن يبلغ ذروة الفاعلية. فالولايات المتحدة اليوم تتحدث بلغة العدالة، لكنها ما تزال عاجزة عن تحويل خطابها إلى حمايةٍ ملموسة للمدنيين. ومنذ ستّ سنواتٍ والسودان مرآةٌ تكشف ازدواجية العالم؛ بين من يتحدث باسم الإنسانية، ومن يتربّح من آلامها. قالت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في كلمتها الأخيرة أمام مجلس الأمن؛ “التاريخ لن يغفر لنا إذا وقفنا مكتوفي الأيدي بينما يُباد شعبٌ بأكمله”، وهي عبارة تختصر جوهر اللحظة؛ لحظة التردد بين الجغرافيا والضمير.
إنّ ملامح الأشهر المقبلة تُنذر بمرحلةٍ أكثر تعقيدًا في علاقة واشنطن بملف السودان. فبعد أن استنفدت الإدارة الأمريكية أدوات الضغط السياسي والعقوبات المالية، تبدو على وشك الانتقال إلى مرحلة إعادة الهيكلة الدبلوماسية، أي نقل الملف من وزارة الخارجية إلى تنسيقٍ أوسع بين البيت الأبيض والكونغرس والوكالة الأمريكية للتنمية والرباعية الدولية. هذا التوجّه لا يعني تصعيدًا عسكريًا، بل إعادة توزيعٍ للنفوذ بحيث تُصبح واشنطن المنسّق الأعلى لشبكة الضغط التي يديرها حلفاؤها الخليجيون ميدانيًا.
من المرجّح أن تُكثّف الولايات المتحدة خلال عام ٢٠٢٦ العقوبات الفردية والقطاعية لتشمل شبكات الذهب والتحويلات المرتبطة بالجيش والدعم السريع معًا، وأن تربط تقديم المساعدات الإنسانية بشروطٍ تتعلق بالوصول الميداني وتثبيت وقف إطلاق النار. كما ستشهد المرحلة المقبلة توسيع التنسيق الأمريكي الأوروبي حول السودان بعد إدراك بروكسل وواشنطن أنّ ترك الملف في يد الرباعية وحدها لم يعد كافيًا.
في المقابل، تشير تصريحات وزير الخارجية مارك روبيو ومسعد بولس الأخيرة والمتكررة، إلى أن البيت الأبيض يتهيأ لطرح خطة سياسية متكاملة لإعادة الانتقال، تستند إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتكون الرباعية طرفًا ضامنًا فيها. وستضغط واشنطن على القاهرة وأبوظبي والرياض لإجبار البرهان وحميدتي على القبول بوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، مع التهديد بعقوباتٍ اقتصادية على من يعرقل التنفيذ.
على الصعيد الميداني، يُتوقع أن تستمر الحرب بوتيرةٍ منخفضة حتى منتصف ٢٠٢٦، مع تزايد التمدد الإنساني الأمريكي عبر USAID وتفعيل مبادرة “الإغاثة مقابل الالتزام” التي تربط دخول المساعدات بوقف استخدام الغذاء كسلاح. وفي حال فشل ذلك المسار، ستتجه واشنطن إلى تدويل الأزمة بالكامل عبر قرارٍ أمميٍّ جديد يحدّد ولاية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار ، وهو ما تعمل عليه الآن فرق من وزارة الخارجية والبنتاغون بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
من المرجَّح أن تتبنى واشنطن في تعاملها مع أطراف الشأن السوداني منهجًا مزدوجًا يقوم على الردع والاحتواء وإعادة التأسيس في آنٍ واحد. فمع الجيش، ستواصل استخدام العقوبات الانتقائية وتجميد التعامل المالي مع الشركات التابعة له، لكنها ستُبقي قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة بوصفه المؤسسة التي لا يمكن تجاوزها في أي تسوية مقبلة. وستسعى إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة ضمن خطة إصلاحٍ تدريجية تضعها لجان مشتركة من وزارة الدفاع الأمريكية والبنك الدولي، بحيث يتحول الجيش من لاعبٍ سياسي إلى مؤسسة مهنية خاضعة لرقابة مدنية، تمهيدًا لإعادة تأسيس الدولة على نموذج “جيش الدولة لا جيش النظام”.
أما مع قوات الدعم السريع، فستعتمد واشنطن سياسة التجفيف المالي والعزلة السياسية الكاملة، بالتوازي مع إحالة قياداتها إلى آليات العدالة الدولية، وربط أي حوارٍ مستقبلي معها بانسحابها من المناطق المدنية وتسليم المتورطين في الانتهاكات. وستضغط على حلفائها الإقليميين، خاصة في الخليج، لوقف أي دعمٍ مالي أو لوجستي يمكن أن يُطيل عمر هذه القوة خارج سلطة الدولة.
وفيما يخصّ الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فإنّ واشنطن لن تسعى إلى تصفيته سياسيًا بقدر ما ستعمل على تحييده دوليًا عبر تجميد أصوله ومنعه من الحركة الدبلوماسية، مع بناء مسارٍ قانوني يقود إلى مساءلته أمام القضاء الدولي، وهو مسارٌ تدعمه الرباعية بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
فيما يتعلّق بالحركة الإسلامية السودانية وأذرعها السياسية والمالية، فإنّ واشنطن ستتجه إلى مرحلة التجفيف المنهجي لا المواجهة المباشرة. فالتجارب الأمريكية السابقة، في أفغانستان والعراق وسوريا أقنعتها بأنّ محاربة الأيديولوجيا لا تجدي، ما لم تُحاصر مصادر القوة المادية. لذلك تركز الإدارة الأمريكية حاليًا على تفكيك البنية الاقتصادية للحركة عبر تتبّع شركاتها ومصارفها ومؤسساتها الخيرية داخل السودان وخارجه، خاصة تلك التي تنشط من تركيا وماليزيا والإمارات.
حيث اشارت تقارير الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن القومي إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد إدراج شخصيات إسلامية بارزة في قوائم العقوبات الفردية، مع فرض قيودٍ على حركة الأموال المرتبطة برجال الأعمال المقرّبين من النظام السابق. كما تدرس واشنطن، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، توسيع تعريف الإرهاب العابر للحدود ليشمل المنظمات الإسلامية التي تمارس نفوذًا سياسياً تحت غطاء العمل الخيري أو الدعوي.
سياسيًا، تتبنّى واشنطن مقاربة “الاحتواء السلبي”؛ فهي لا تنوي حظر الإسلاميين كليًا في الخطاب العلني، لكنها تسعى إلى نزع شرعيتهم العملية عبر عزلهم عن المشهد المدني الجديد وتقييد وصولهم إلى السلطة، تمامًا كما حدث في النموذج التونسي بعد ٢٠٢١. أما أذرعهم في الجيش والأجهزة الأمنية، فستخضع لمراجعة دقيقة في أي عملية “إعادة تأسيس” للمؤسسات النظامية، على أن يُمنع ضباطهم من المناصب العليا خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
بهذا النهج، تراهن واشنطن على تقليم أظافر الإسلاميين دون تحويلهم إلى شهداء سياسيين، مع الاعتماد على الرباعية الدولية لتأمين الغطاء الإقليمي، خصوصًا أن بعض عواصم الخليج أصبحت ترى في تمدّد الإسلاميين تهديدًا مباشرًا لاستقرارها. وهكذا، فإن ما ينتظر الحركة الإسلامية السودانية في العامين المقبلين ليس اجتثاثًا علنيًا، بل اختناقًا بطيئًا ومدروسًا يقطع عنها الموارد والمكانة والتأثير، حتى تتحول من لاعبٍ مهيمنٍ إلى ظلٍّ بلا وزن في مستقبل السودان السياسي.
أما القوى المدنية، فتبدو اليوم في نظر واشنطن ركيزة المرحلة المقبلة رغم تشتتها وتراجعها الميداني. لذلك ستعمل الإدارة الأمريكية على إعادة هندسة المشهد المدني عبر دعم تحالفٍ جديد يضم التيارات المستقلة ولجان المقاومة والنقابات وتحالف تأسيس بشقّه المدني، مع إبعاد الواجهات الحزبية القديمة التي ارتبطت بالفشل أو بالاستقطاب الأيديولوجي. وستراهن على صمود هذه القوى كضمانٍ لاستدامة الانتقال، مقدمةً لها حزم دعمٍ فني وسياسي بإشراف مباشر من الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الأوروبي، في إطار ما يُعرف داخل دوائر القرار الأمريكية ب”خطة التأسيس الثانية للدولة السودانية”.
بهذا النهج، لا تراهن واشنطن على طرفٍ بعينه، بل على إعادة بناء الحقل السياسي كله ليولد منه كيانٌ وطنيٌّ جديد بمرجعية مدنية، تحكمه قواعد المحاسبة والشفافية، وتُحاط بإشرافٍ دولي مرحليٍّ تضمنه الرباعية. فالمستقبل القريب لن يكون صراعًا على السلطة بين البرهان وحميدتي، بل صراعًا على من يملك شرعية التأسيس للدولة السودانية الجديدة في ظلّ عينٍ أمريكيةٍ لا تنام.