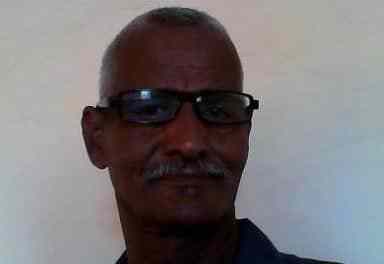قراءة في جدلية التحرر وبناء الإنسان بين نار الإيمان ونور الفكر
في التاريخ لحظات لا تمرّ مرور الغيم، بل تترك ندوبها في الذاكرة الجمعية للأمم، وتُعيد تشكيل وعيها بالعالم وبذاتها. هناك، في باريس، اندلعت ثورةٌ لم تهدم القصور وحدها، بل هدمت المفاهيم القديمة عن السلطة والعقل والإنسان. وهنا، على ضفاف النيل، قامت ثورةٌ أخرى من رحم الإيمان والكرامة، رافعةً راية الخلاص من الظلم والاستعمار، ومبشّرةً بدولةٍ تعيد للسوداني حقه في أن يكون سيد نفسه ووطنه.
الثورة الفرنسية والثورة المهدية، وإن تباعدتا في الزمان والمكان، إلا أنهما تلتقيان في الحلم الإنساني بالتحرر، وتفترقان في الطريق إليه: فإحداهما أقامت الدولة على نور الفكر، والأخرى أطفأت الفكر بنار القداسة.
حين دوّت صيحات الثورة الفرنسية عام 1789، كانت فرنسا تموج بالتحولات، تبحث عن ميلادٍ جديدٍ للعقل بعد قرونٍ من الخضوع للكنيسة والملوك. لم تكن الثورة مجرد انتفاضةٍ ضد الجوع والضرائب، بل تمردًا على نظامٍ فكريٍّ كاملٍ جعل الإنسان تابعًا للسلطة باسم السماء. فجاءت الثورة لتعلن ميلاد “المواطن” بدل “الرعية”، وشرّعت الدساتير التي جعلت الشعب سيد نفسه. ألغت الامتيازات الطبقية، وأقامت نظامًا مدنيًا فصل الدين عن الحكم، وجعل التعليم أساس المواطنة والحرية.
من رماد المقاصل خرج الفكر الحديث، ومن دماء الثائرين وُلدت الدولة التي جعلت المدرسة مصنع الحرية والعقل. أدرك الفرنسيون أن الدم لا يُثمر وحده، وأن الطريق إلى الخلاص يمرّ من الكتاب والمناهج والعلم. فكان أن تحوّل غضب الشارع إلى وعيٍ منظم، ومن الفوضى خرجت الجمهورية التي علّمت أبناءها كيف يصنعون التاريخ بدل أن يكونوا ضحاياه.
أما في السودان، حين أعلن الإمام المهدي دعوته عام 1881، كانت البلاد ترزح تحت ظلمٍ مزدوج: استبدادٍ داخليٍّ فاسدٍ واستعمارٍ أجنبيٍّ يمتصّ خيراتها. فالتف حوله الناس لأنهم وجدوا فيه رمزًا للخلاص وبصيص أملٍ يردّ إليهم كرامتهم. ومن حوله تجمعت قبائل السودان على رايةٍ واحدة، فكانت المهدية أول تجربةٍ لتوحيد البلاد على حلمٍ دينيٍّ ووطنيٍّ مشترك.
لكن الحلم، في زهوه الأول، لم يلبث أن اصطدم بالواقع الصعب. إذ لم يطل حكم الإمام المهدي نفسه أكثر من عامٍ واحد (1885-1886)، ثم آل الأمر إلى خليفته عبد الله التعايشي، الذي حكم ثلاثة عشر عامًا، فحوّل الثورة الروحية إلى سلطةٍ مغلقةٍ على ذاتها. لم يكن الخليفة رجل فكرٍ أو مشروعٍ معرفيٍّ لبناء الدولة، بل كان يهوى السيطرة والإخضاع. حتى رسالة الإسلام السامية التي جعلت من التعليم والعقل ركناً لبناء الإنسان، غابت عن أيام حكمه.
حلَّ “ورد المهدي” محلّ المدرسة، وحلّ التبجيل محلّ التفكير، وغُسلَت العقول بالإيمان بالشخص لا بالمبدأ. تحوّل الدين من وسيلةٍ لتحرير الروح إلى أداةٍ لتقديس الزعيم، فبدلاً من أن تُفتح الكتاتيب لتعليم القرآن، فُتحت الساحات لترديد الأناشيد وتمجيد الخليفة والمهدية. وهكذا أُغلقت أبواب المعرفة باسم الطاعة، وغابت روح الاجتهاد تحت ظل الخوف والقداسة.
بل إن عبد الله التعايشي، الذي أوعز للإمام المهدي منذ البداية أنه “المهدي المنتظر”، فعل ذلك تودّدًا وطمعًا في القرب والنفوذ، حتى جعله المهدي نائبًا له، فكان ذلك المدخل الذي تسلّل منه إلى السلطة بعد رحيله. ومن يومها، تحوّل الحلم الإصلاحي إلى حكمٍ فرديٍّ باسم الدين، يضرب بالسيف كل صوتٍ مخالف، ويطفئ بالعقيدة نور العقل.
وحين غابت المدرسة، ضاعت الدولة. فبينما كانت فرنسا بعد ثورتها تبني الجامعات والمعاهد وتخطّ قوانينها بمداد العلم، كانت المهدية تغلق الأبواب على فكرٍ واحد لا يقبل السؤال. وبينما كانت باريس تضع أُسس الجمهورية التي لا تموت بموت قائدها، كانت أم درمان تترنح تحت دولةٍ قائمةٍ على الولاء الشخصي، لا على النظام.
وحين سقطت الدولة المهدية في معركة كرري عام 1898، لم يكن سقوطها عسكريًا فحسب، بل سقوطًا فكريًا وروحيًا أيضًا، لأن الثورة لم تبنِ عقلًا يحرسها. فدخل المستعمر من الباب ذاته الذي خرج منه، ولكن هذه المرة مسلحًا بالمعرفة والإدارة والتنظيم. وهكذا، ورث السودان مؤسساتٍ صنعها الإنجليز، ما زال يعيش داخلها حتى اليوم — من القصر الجمهوري الذي كان سرايا الحاكم العام إلى الجامعات التي أنشئت لخدمة مشروعٍ استعماريٍّ لم يغادر عقولنا بعد.
واليوم، بعد أكثر من قرنٍ على المهدية، ما زال السودان يدفع ثمن الثورة التي لم تكتمل. فما زال الإنسان السوداني يتطلع إلى الخارج بحثًا عن الخلاص، وما زال نظام الدولة يُدار بذات العقل القديم الذي يقدّس الزعيم وينسى الإنسان. ما أشدّ المفارقة حين يكون البلد الذي أشعل ثورته باسم الدين، عاجزًا عن تطبيق جوهر الدين في بناء الإنسان وتعليم العقل.
لقد منحتنا المهدية شعورًا بالكرامة، لكنها لم تمنحنا أدوات الحفاظ عليها. أنقذت الجسد من القيد، لكنها تركت الروح في ظلام الجهل. جعلتنا نرفع الرأس أمام المستعمر، لكنها لم تترك لنا مدرسةً ترفعنا بعد رحيله.
في المقابل، كانت الثورة الفرنسية تزرع في أبنائها درسًا خالدًا: أن التحرر لا يكتمل إلا حين يُحرر العقل، وأن بناء الدولة يبدأ من بناء المواطن لا من سقوط النظام. فبالعقل والتعليم تجاوز الفرنسيون دماءهم وانقساماتهم، وصنعوا من الثورة فجرًا جديدًا للعالم الحديث. أما السودان، فقد ظل أسير الحنين إلى الثورة الأولى، دون أن يتعلم كيف يُكمِل معناها.
إن مأساة السودان اليوم ليست في الحروب وحدها، بل في غياب الرؤية الفكرية التي تجعل من كل ثورةٍ مشروعًا
لبناء الإنسان، لا مجرّد انفجارٍ عاطفيٍّ ينتهي مع قائده. فالثورة التي لا تُنجب مدرسةً تبقى يتيمةً في التاريخ، والحرية التي لا تستند إلى وعيٍ ومعرفةٍ تتحوّل إلى فوضى. نحن بحاجةٍ إلى ثورةٍ ثالثة، لا بالسيف بل بالعقل، لا ترفع راية الدين أو الغرب، بل راية الإنسان السوداني حين يدرك أن رسالته الحقيقية أن يُكمِل ما لم تفعله المهدية: أن يبني الوطن بالعلم لا بالشعار، وبالمدرسة لا بالمنبر.
فالثورة المهدية كانت حلمًا عظيمًا لم يكتمل، والثورة الفرنسية كانت كابوسًا دمويًا أنجب حضارة. الأولى خلّصت الجسد من المستعمر لكنها لم تحرّر العقل من الجهل، والثانية حرّرت العقل فشيّدت وطنًا جديدًا للروح والجسد معًا. وبين هذين الطريقين يقف السودان اليوم، يتلمّس نوره في ليلٍ طويل، يبحث عن معناه في معركةٍ جديدة — معركةٍ ضد الجهل، ضد الاستبداد، ضد التاريخ الذي لم يُكتب بعد كما يجب. وحين ينتصر العقل في السودان، لن تكون الثورة حدثًا مضى، بل ميلادًا دائمًا لأمةٍ عرفت أخيرًا أن الإيمان بلا فكرٍ عبادةٌ ناقصة، وأن الفكر بلا إيمانٍ حريةٌ عمياء، وأن الوطن لا يقوم إلا حين يتعانق الاثنان في إنسانٍ واحد.