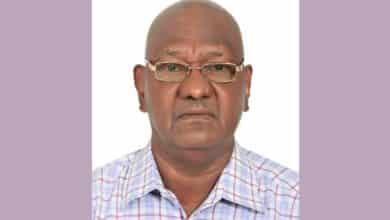تمثل الحرب الأهلية الرابعة في السودان (2023 – حتى الآن) أحد أكثر الصراعات تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، إذ تتقاطع فيها خطوط السلطة والهوية والمصالح الإقليمية والدولية.
في قلب هذا المشهد الملتبس تتصارع ثلاثة أقطاب رئيسية: الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية التي تمثل إرث انتفاضة ديسمبر.
وبينما تستعر المعارك على الأرض، تدور حرب موازية في ميدان المعلومات والتضليل، حيث تُستخدم الأكاذيب والتشويه كسلاح لإسقاط الشرعية وتقويض الثقة العامة.
تقوم استراتيجية العسكرة على التشويه المنهجي والتخوين، إذ توجيه اتهامات متكررة لتحالفات مدنية مثل «تقدم» و«صمود» بالتواطؤ مع قوى مسلحة أو العمل لصالح أجندات خارجية لا يخدم فقط صورة الخصم
بل يعيد رسم ساحة الصراع من مدني–عسكري إلى عسكري–عسكري، ما يبرر استمرار الهيمنة العسكرية ويقوّض إمكانيات الانتقال الديمقراطي. في هذا الإطار تتحول الأخبار المضللة والمعلومات المجتزأة إلى قذائف إعلامية
تُسقط مصداقية مناضلين وسياسيين كانوا جزءاً من النضال ضد النظام البائد.
القوى المدنية نفسها تقف أمام معضلة وجودية مركبة: تستمد شرعيتها من انتفاضة ديسمبر ومطالبها بدولة مدنية، لكن واقع الحرب يفرض عليها الانخراط في سياسات واقعية قد تتطلب تواصلاً تكتيكياً مع أطراف إقليمية ودولية
أو حتى فصائل محلية لتحقيق ممرات إنسانية أو حلول مؤقتة. في هذا الفضاء الهش حاول اتفاق أديس أبابا (يناير 2024) أن يقدم صيغة توازن بين وقف الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية وتشكيل إدارة مدنية مشتركة
لكنه سرعان ما استُعمل كسلاح إعلامي لتشويه القوى المدنية، بتغليط الجمهور وصبغ أي تواصل بالتواطؤ مع «قوى الظلام».
التضليل المستخدم ضد المدنيين يشتغل على مستويات متداخلة. يُفصل السياق التاريخي لسجل القادة النضاليين ليجردهم من مرجعيتهم الثورية، ثم تُحوّل دوافع التحالفات أو اللقاءات الدبلوماسية إلى تهمة «التبعية للأجندات الأجنبية»
وفي النهاية تُتغاضى عن مواقف هذه القوى الأخلاقية من انتهاكات الفصائل المسلحة، ليُصوّر صمت أو مصالح تكتيكية على أنها رضوخ أخلاقي أو سياسي. نتائج هذا الخطاب لا تقتصر على التشويه الإعلامي فحسب
بل تمتد إلى إجراءات قضائية ودبلوماسية تستهدف شخصيات مدنية، وقد تصل إلى محاولات استنزافها أساسياً عبر حملات سمعة منظمة.
من جهة أخرى، شهد الخطاب المدني انزياحاً عملياً يصح اعتباره تعبيراً عن نضج سياسي أكثر منه تراجعاً. فقد انتقل جزء من الخطاب من شعارات ثورية أحادية إلى خطاب إدارة أزمة يركّز على بناء تحالفات تكتيكية وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق
على الأرض. هذا التحول يعكس إدراكاً بأن المواجهة المباشرة مع العسكر دون أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق قد تفضي إلى مزيد من التمزق الوطني. ومع ذلك فإن هذا المنحى يوفّر متنفساً للمنتقدين لتصوير التحول كتنازل أخلاقي
وهو تحويل منطقي مبني على تضليل متعمد.
لمواجهة هذه الديناميكية السامة تحتاج القوى المدنية إلى مقاربات تستعيد فيها المبادرة في ساحة المعنى.
يتطلب ذلك بناء تحالفات أفقية مع قطاعات اجتماعية واسعة من قبائل ونقابات وأحزاب تاريخية، وتبنّي استراتيجية اتصال شفافة توضح التعقيدات السياسية وتفصّل دوافع كل خطوة وتزيل اللبس قبل أن يستغله خصومها.
كما ينبغي إعادة طرح مفهوم السيادة ليس كقالب أمني جامد بل كسيادة شعب وحقه في تقرير المصير، مع إعلاء مبدأ المساءلة لمرتكبي الانتهاكات بغضّ النظر عن انتماءاتهم.
إن نقد القوى المدنية بلا مسوغات واقعية لم يعد مجرد خطأ تحليل، بل مساهمة فعلية في إطالة أمد الحرب وإضعاف فرصة الانتقال الديمقراطي.
وبعد سنوات من التضحيات والثمن الباهظ الذي دفعه الشارع السوداني، يصبح الدفاع عن المشروع المدني واجباً وطنياً وأخلاقياً يتطلب شفافية من القيادات
ووضوح رؤية، وتضامناً شعبياً يشتغل على مستوى الوعي والآليات العملية معاً. فالمعركة ضد التضليل ليست مجرد مواجهات إعلامية، بل صراع على ذاكرة الأمة وهوية الدولة ومستقبلها.