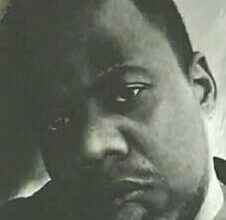تفكيك خطاب الاستعلاء في مشروع عبد الرحمن عمسيب الانفصالي

مدخل تمهيدي
في خضم المشهد السوداني المأزوم، حيث تتقاطع القبيلة مع الدولة، والهوية مع السلطة – وذلك بفرض سرديات تُمجّد جماعة معيّنة أو تُقصي أخرى كما هو حال الدولة السودانية القائم منذ الاستقلال – يبرز خطاب عبد الرحمن عمسيب، بوصفه نموذجًا صارخًا لاستعلاء عرقي ومعرفي يرتدي عباءة التحليل السياسي، بينما ينزلق عن وعي إلى مستنقع العنصرية البغيضة.
عبد الرحمن عمسيب، وإن بدا في الظاهر كمفكر استراتيجي، وباحث أكاديمي في العلوم السياسية، والاجتماعية، بل وخبيراً في الاستراتيجية العسكرية، والخطط الحربية – كما في ديباجة تعريفه لنفسه – لينأى بها عن عالم “اللايفاتية”. يستخدم أدوات التحليل الوصفي، والمنهج التاريخي، للكشف عن الأسباب الكامنة وراء، جذور الصراع في السودان، إلا أن خطابه لا يلبث أن يكشف عن تموضعه العميق في أرضية قبلية جهوية ضيقة، تسعى لإعادة تشكيل الدولة على أسس التمايز العرقي والصفاء الإثني.
المفارقة المؤلمة هنا، أن من يدّعي الرغبة في “تصحيح” المسار السياسي السوداني، إنما يعمل في جوهر مشروعه على تفخيخ نسيج الدولة وتفكيكه، بدعوى التفوق العرقي والمعرفي على حساب من أطلق عليهم (الرائعون) ازدراءً مقنعا وسخرية خفية يواري بها في طيات اللغة وكثافتها ما عجز عن التصريح به علنا. ومصطلح الرائعون في سياقه “العمسيبي” يعتبر ذو ظلال بغيضة ليس هنا مجال تفكيكه.
في خطابه الراتب، يتحدث عمسيب، بلغة تنضح بالاستعلاء، ليس فقط من حيث تفوق “شلته” المختارة على الآخرين – النهريين العظماء – كما يحلو له تسميتهم، بل أيضًا بتقديم ذاته كمن يمتلك “فهمًا أرقى” لطبيعة الصراع في السودان وأزماته السياسية المعقدة. غير أن هذا الفهم المزعوم يغفل أو يتغافل عن حقيقة تاريخية جوهرية، أن القبيلة بوصفها مكونًا اجتماعيًا أسبق من الدولة الحديثة، كانت دومًا تتفاعل مع السلطة وفق ميزان “القوة” لا وفق خطاب الطهر والنقاء العرقي.
وعمسيب يعلم جيدا، إن العلاقة بين القبيلة والدولة لم تكن يومًا علاقة تطابق أو تنافر حتمي، بل علاقة جدلية معقدة، يحكمها “التفاوض” كما في النزاعات المطلبية، و “التحالف” الخفي والمعلن، كما في ضرب المكونات الاجتماعية بعضها ببعض – ثنائية عرب زرقة – وأحيانا الصراع التناحري المزمن، كـ حرب الجنوب المتناسلة التي انتهت بانفصاله، بل وأحيانًا أخرى التماهي والذوبان في الدولة نفسها فتصبح الدولة هي القبيلة هوية وثقافة. والقبيلة هي الدولة، ثروة وسلطة ونفوذا و”تمكينا”.
لكن عمسيب، في سعيه الحثيث لإعادة صياغة هذه العلاقة على أساس استعلائي، يقوّض أي إمكان لنشوء مشروع وطني جامع. إنه ينسف ما يمكن تسميته بـ”تعادل القوة”، حيث لا تكون قوة القبيلة من ضعف الدولة، ولا قوة الدولة من سحق القبيلة، بل من تكاملهما في مشروع سياسي مشترك، يسعى لمصلحة وخير جميع القبائل، التي تشكل في مجموعها السودان.
ينطلق عمسيب” أيضًا من فرضية أن الدولة السودانية قد تأسست على تحالفات قهرية بين المركز والقبيلة، وأن القبائل المهمّشة ظلت دومًا على هامش السلطة مما دفعها إلى حمل السلاح للمطالبة بحقوقها “المشروعة” في الثروة والسلطة، وإقامة دولة العدالة، مما صنع دولة “الصراعات الكبرى”، والتي على أساسها بنى عمسيب، نظريته ورؤيته للإنفصال عنها، وإقامة دولة النهر والبحر ذات التجانس العرقي – ولا ادري لماذا يتقدم النهر على البحر؟- لكن ما يتجاهله عمسيب، وربما يتعمد إغفاله، هو أن القبيلة ليست نقيضًا للدولة، بل كانت حاضنًا اجتماعيًا للدولة في مراحل تشكّلها الأولى، ورافعة من روافع النظام السياسي في الدولة السودانية ما قبل وما بعد حقبةالاستعمار.
وفي المقابل يوظف عمسيب، فكرة الهامش والتهميش لإنتاج هامش جديد متخيل قائم على “الاستعلاء العكسي”، إن صحت العبارة واستقام معناها، حيث يُعاد تشكيل “الهُوية” بوصفها مجالاً نقيًا، خاليًا من الاختلاط، مقاومًا للتنوع، قائمة على رفض “الآخر”، لا لأنه “خميرة عكننة”، ومصدر للصراعات والحروب فحسب، بل لأنه دخيل إثنيًا وثقافيًا، وشكلاً، “ما بشبهونا” “ويا نحن، ويا هم” وكأنما تماثل وتطابق وتشابه السحنات والثقافات واللهجات ركنا دستوريا من أركان الدولة دونه لا معنى لوجود الدول بشكلها القائم!.
هذا النوع من الاستعلاء الفكري هو ما يسمح لخطابات مثل خطاب عبد الرحمن عمسيب، أن تُضفي الشرعية على عنصرية مقنّعة، تتدثر بمفاهيم مثل: “الحق التاريخي في الحكم”، “التميّز الإثني”، “الخصوصية الثقافية”، لكنها في جوهرها تقوم على إنكار مشترك المواطنة، ونفي الشرعية عن الآخر المختلف والذي يتهكم عمسيب في لهجته متخذا كلمة “شِيفْ” على سبيل المثال ميدانا لسخريته، وكلمة شِيفْ بالمعنى الفصيح المغاير للدارج تعني (أنظر )، وفي ذات الوقت نجد ان عمسيب نفسه كي يتأكد من موقف متابعيه او تابعيه بانهم يتفقون معه في سردية ما، يستعمل كلمة “مُشْ” وتعني (أليس كذلك)؟ دون ان يعترف للآخرين بحقهم في استعمال اللهجة التي تفرضها بيئاتهم المختلفة.
إن أكبر خطر يواجه السودان اليوم ليس في انهيار مؤسسات الدولة فقط، فهذه يمكن إعادة بناءها، بل في تفكك الوعي الوطني والنسيج المجتمعي، حين يصبح التاريخ سلاحًا انتقائيًا، والمعرفة وسيلة إقصاء، والهوية مشروع استعلاء. وحين يتحول “النقد السياسي” إلى خطاب عنصري مغلّف، فإننا لا نكون بصدد تحرير العقول وفك عقالها من نير التخلف والتبعية، بل إعادة إنتاج لأسوأ أشكال الهيمنة، تلك التي تأتي باسم النقاء والتفوق العرقي.
الخطير في خطاب عمسيب أنه لا يكتفي بنقد المركز أس البلاء وصانع الأزمات – وهذا في ذاته مشروع وضروري – بل يُراد له أن يكون خطابًا انفصاليًا مقنّعًا، يبرر التشرذم والانعزال بمفردة “الاستحقاق التاريخي في الريادة”. وهنا يتحول التحليل السياسي إلى أداة للتبرير الأخلاقي للعنصرية، ويُستخدم الفهم السوسيولوجي لتكريس الإقصاء والهيمنة والتعالي على الآخرين باعتبارهم ضحايا جغرافية وتاريخ، ومظاليم طبيعة، فعليهم تحمل وزر تبعات ذلك!.
من هذا المنطلق، فإن مشروع عمسيب، لا يمكن قراءته إلا في سياق تفكيك الدولة السودانية من الداخل، عبر إحياء الهويات المتجانسة والنقاء المتوهم، وإضفاء مسحة من المشروعية الفكرية على مشاريع التقسيم. لا يهم هنا إن كان الخطاب يصدر عن ضحية تاريخية، كما يستدعي عمسيب “المظلومية من الماضي البعيد” أو مركز قابض ومهيمن، ما يهم هو أن المنطلقات القائمة على التفوق والاستعلاء تنتهي دومًا إلى أشكال جديدة من الطغيان، حتى وإن جاءت باسم التحرر وفك الارتباط عن دار فور.
وفي الختام، أركان الدولة ثلاث، أرض وسلطة وشعب، وجاءت كلمة “شعب” خالية من أداة التعريف، ولم تسبقها أو تلحقها صفة، مثل الانسجام والتجانس أو الوحدة الثقافية أو التميّز الحضاري، أو الشبه حد التماثل بين أفراد المجموعة الواحدة الذي يحدد اختلافهم عن الآخرين، وغيرها من التصنيفات التي لا تنطوي إلا عن وهم ذاتي، ونزعات رغبوية في مرحلة الطفولة المتأخرة، التي تطورت في تدهورها، إلى أن بلغت حد الأنانية المتقوقعة، التي لا ترى في هذا العالم الفسيح إلا انعكاس ذاتها.