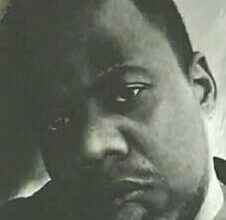لماذا يجب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية؟ سقوط القداسة وحق العالم في العدالة

علاء خيراوي
منذ أن خرج الإنسان من غار الخوف إلى فضاء الدولة، ظلّ الدين والسياسة في صراعٍ مكتومٍ حول من يمتلك حقّ تفسير الغيب ومن يملك إدارة الأرض. وعبر القرون، كانت كل محاولةٍ لدمج المقدّس بالسلطة تنتهي إلى طغيانٍ جديدٍ يرفع لافتة السماء ليحكم بها الناس. من كنائس القرون الوسطى إلى دولة الخلافة في أواخر أيامها، ومن المحاكم التفتيشية إلى جمهورية المرشد، يتكرّر المشهد ذاته؛ حين يستعير السياسي لسان الله، يتحوّل الدين إلى سلاحٍ والأمة إلى رهينة.
في هذا السياق التاريخي الطويل، لم تكن جماعة الإخوان المسلمين سوى أحدث تجليات ذلك الوهم القديم؛ وهم “الدولة المقدّسة”. فمنذ نشأتها في مصر عام ١٩٢٨ على يد حسن البنّا، خرجت الفكرة من عباءة الدعوة إلى دهاليز السياسة، ومن منابر المساجد إلى مكاتب التنظيم. لم تمضِ أعوامٌ قليلة حتى أنشأ البنّا “الجهاز الخاص” المسلّح الذي نفّذ سلسلة اغتيالات سياسية في الأربعينيات، أبرزها اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي عام ١٩٤٨ ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر عام ١٩٥٤، لتتحوّل الجماعة من حركةٍ دعويةٍ إلى تنظيمٍ سرّيٍ مغلقٍ يرى في العنف وسيلةً للتغيير.
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تمددت الجماعة في المشرق والمغرب والخليج وأوروبا وأميركا، مستخدمةً الجمعيات الخيرية والتعليمية والدعوية كأدواتٍ لتثبيت نفوذها وتجنيد الأتباع تحت شعار “الإسلام هو الحل”. في مثير من الدول، من بينها السودان، نشأت فروعٌ تحمل الاسم أو الفكر ذاته، وتبنّت فكرة “التمكين” من داخل الدولة لا من خارجها، حتى تحوّلت في بعض البلدان إلى سلطةٍ موازية أو حاكمة.
بعدها خرجت الجماعة من حدودها الجغرافية الأولى لتتحول إلى شبكةٍ أيديولوجية عابرةٍ للحدود. فخطابها الموحّد ومناهجها التعليمية وأدبياتها التنظيمية كانت تنسخ نفسها في كل بلدٍ تُزرع فيه، حاملةً معها منطق “الطليعة المؤمنة” التي ترى في المجتمع الجاهلي عدوًّا يجب إصلاحه أو استتابته. ومع مرور الزمن، صار مشروعها يقوم على فكرة مزدوجة؛ إصلاح العالم بالدين، والسيطرة على الدين بالسياسة. وهو ما جعلها في نظر خصومها لا حركة إصلاحٍ، بل بنيةً فكرية تسعى إلى احتكار التفسير الإلهي وإعادة تشكيل المجتمعات وفق عقيدتها الخاصة.
وفي السودان تحديداً، كان عام ١٩٨٩ نقطة التحول حين دبّر الإسلاميون انقلاب الثلاثين من يونيو الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية وأقام دولةً أيديولوجيةً باسم “الإنقاذ”. ومنذ تلك اللحظة، ارتبط اسم الحركة الإسلامية السودانية، وهي الامتداد المحلي للفكر الإخواني، بكل فصول القمع والحروب التي مزّقت البلاد.
في السودان، لم يكن انقلاب ١٩٨٩ حدثًا عابرًا في مسار الدولة، بل لحظة مفصلية غيّرت هوية الوطن ومصيره. فقد أحكم الإسلاميون قبضتهم على كل مفاصل الدولة تحت شعار “التمكين”، وأسسسوا منظومة حكمٍ عقائديةٍ جعلت الولاء للتنظيم فوق الولاء للوطن. تحوّل الاقتصاد إلى شبكة مصالح مغلقة، واحتُكر التعليم والإعلام، وأُخضعت مؤسسات الأمن والقضاء لخدمة المشروع الإسلامي السياسي. في الجنوب، رُفعت رايات “الجهاد” ضد مواطنين سودانيين بحجة محاربة التمرد، وفي دارفور تحوّل الخطاب الديني إلى وقودٍ للحرب الأهلية، حيث أُنشئت مليشيات “الدفاع الشعبي” و”الجنجويد” التي ارتكبت جرائم إبادةٍ وتطهيرٍ عرقي موثقةٍ في تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
خلال ثلاثة عقود من الحكم، قُسّم السودان جغرافيًا وعرقيًا واقتصاديًا. تمكّنت الحركة الإسلامية من زرع أذرعها داخل مؤسسات الدولة والشركات والبنوك والجامعات، فصنعت طبقة بيروقراطية تابعةً لها، واحتفظت بشبكاتٍ ماليةٍ ضخمة موازية لاقتصاد الدولة الرسمي. كانت تلك الشبكات بمثابة “القلعة الاقتصادية” التي ضمنت بقاء النظام حتى عندما انهار سياسيًا. وحتى بعد سقوط البشير في ٢٠١٩، ظلّت بقاياها تعمل في الخفاء، تموّل الفوضى وتُعيد إنتاج الولاءات القديمة تحت لافتاتٍ جديدة.
ولم يكن العنف حكراً على السودان. ففي الجزائر، شهدت البلاد في التسعينيات صراعاً دامياً بين الدولة والجماعات الإسلامية المسلحة التي استلهمت فكر الإخوان، بينما واصل التنظيم في مصر نشاطه السري بعد حظره وارتبطت بعض فصائله بحوادث تفجير واغتيالات متفرقة. أما في سوريا، فقد واجه النظامُ في الثمانينيات تمرداً مسلحاً قاده الإخوان انتهى بمجزرة حماة الشهيرة عام ١٩٨٢، التي قُتل فيها عشرات الآلاف بين استبداد النظام وتطرّف الجماعة. وفي الأردن، اتخذت السلطات عام ٢٠٢٥ خطوةً حاسمة بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها بعد اتهامها بتشكيل خلايا غير مشروعة والتخطيط لهجماتٍ باستخدام طائراتٍ مسيّرة وصواريخ محلية الصنع لزعزعة الأمن الوطني، إضافةً إلى تلقي دعم خارجي وتمويل أنشطةٍ خارج الأطر القانونية. وقد نفت الجماعة هذه الاتهامات، غير أن القرار مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في الموقف الأردني من إدارة وجودها إلى تفكيك بنيتها المؤسسية، ليغدو الأردن مثالًا جديدًا على انتهاء زمن التسامح الرسمي مع التنظيمات العابرة للحدود التي تعمل تحت غطاء الدعوة والسياسة.
وفي ليبيا وتونس، برزت الحركة الإسلامية بأسماءٍ مختلفة عقب ثورات “الربيع العربي”، حيث دخلت في العملية السياسية وحققت بعض المكاسب الانتخابية، لكنّ ممارساتها الفكرية والتنظيمية ظلّت مثار جدلٍ بسبب نزعتها الإقصائية وسعيها إلى أسلمة المجال العام. وحتى في أوروبا وأميركا، وجدت الجماعة موطئ قدمٍ عبر منظماتٍ ومراكز ثقافية تتبنّى خطاباً مزدوجاً؛ تسامحٌ في العلن، وبناء نفوذٍ ديني، سياسيٍ منظّمٍ في الخفاء، ما دفع أجهزة الأمن الأوروبية إلى وصفها بأنها “التهديد الهادئ طويل الأمد”. وهكذا تراكم سجل الجماعة عبر قرنٍ من الزمن ممتلئًا بالدماء والخيبة، من اغتيال النقراشي إلى دارفور، ومن حادث المنشية في مصر إلى بيوت الأشباح في الخرطوم، مرورًا بسنواتٍ من الإرهاب الفكري والتنظيمي الذي اتخذ من الدين غطاءً ومن الدولة ساحةً لتصفية الخصوم.
ورغم إنكار الجماعة المتكرر لمسؤوليتها عن العنف، فإنّ تاريخها يعجّ باعترافاتٍ متفرقة لقادتها السابقين تكشف جانباً من التناقض بين خطابها العلني وسلوكها الفعلي. ففي مقابلةٍ مع مجلة “ذا نيويوركر” عام ٢٠٠٨، أقرّ أحد القياديين التاريخيين بأنّ الجماعة شهدت بضع حالات من العنف في تاريخها، معظمها اغتيالات سياسية، وهو اعترافٌ ضمنيّ بأن العنف لم يكن طارئًا على فكرها بل جزءًا من أدواتها منذ الأربعينيات. كما أشار تقريرٌ بحثيٌّ حديثٌ في موقع “مودرن دِبلومسي” أن الفكر الإخواني نفسه يُطَرّز العنف في النصّ ويبرّر الاغتيال كفعلٍ مشروع ضدّ من يخالفهم، ما يؤكد أن الجذر الأيديولوجي للعنف ليس عارضًا بل متأصلًا في بنيتها الذهنية.
وذهب “معهد هدسون الأمريكي” في تحليله لعام ٢٠٢٣ إلى أنّ ما يُسمّى “الجهاز الخاص” الذي انشئ في الخمسينات من القرن الماضي، للإخوان هو النموذج الأول للحركات الجهادية الحديثة، إذ جمع بين التنظيم السريّ والعقيدة التعبوية المقاتلة. ورغم أن هذه الشهادات لم تأتِ في شكل “اعترافات جنائية” مكتملة الأركان، إلا أنها تمثل، في سياقها السياسي والفكري، إقرارًا غير مباشرٍ بأنّ الجماعة مارست العنف وشرعنته حين احتاجته، ثم أنكرتْه حين حوسبت عليه، وهي عادة التنظيمات التي تقدّس نفسها وتعتبر الحقيقة خيانةً للعقيدة.
اليوم، بعد قرنٍ تقريبًا على ميلادها، تقف الجماعة أمام المرآة الدولية عاريةً من شعاراتها؛ فقد تحوّلت من خطاب الإصلاح إلى لغة الرصاص، ومن الدعوة إلى التنظيم، ومن الدعاء إلى التحريض. إن مشروع تصنيفها تنظيمًا إرهابيًا في الكونغرس الأميركي ليس معركةً سياسية بل إعلان فشلٍ فلسفي لفكرةٍ ظنّت أن الإيمان يمكن أن يتحوّل إلى جهازٍ إداري، وأن الدولة يمكن أن تُدار بروح الجماعة لا بقوانين المواطنين.
وفي مساعٍ جديدة، واصل الكونغرس الأميركي في مساعيه التشريعية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، عبر مشاريع قوانين متعاقبة كان آخرها مشروع قانون مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢١ المعروف باسم “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية”، الذي قدّمه السيناتور تيد كروز وعدد من زملائه الجمهوريين. دعا المشروع وزارة الخارجية إلى إجراء تقييم رسمي لمدى استيفاء الجماعة لمعايير التصنيف الإرهابي المنصوص عليها في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، وإلى تقديم تقريرٍ للكونغرس يوضح الأدلة على تورط الجماعة في أنشطة عنفٍ وتمويلٍ إرهابي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ورغم أن المشروع لم يُقرّ نهائياً حينها، فقد أعيد طرحه لاحقاً بصيغةٍ أكثر وضوحًا في مجلس النواب الأمريكي عام ٢٠٢٥ تحت اسم “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية للعام ٢٠٢٥”، والذي نصّ صراحةً على إلزام وزارة الخارجية بإدراج الجماعة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من صدور القانون، ما لم تقدّم الوزارة تبريرًا مكتوبًا يثبت العكس. وقد جاء هذا التطور التشريعي في ظل تزايد القناعة داخل دوائر الأمن القومي الأميركي بأن فكر الجماعة يمثل “الخزان الأيديولوجي الأكبر للتطرف المعاصر”، وأن استبعادها من قوائم الإرهاب بحجة تنوع فروعها لم يعد مبرراً في ظل الأدلة الميدانية المتراكمة. وهكذا انتقلت القضية من كونها مطلباً سياسياً إلى نقاشٍ مؤسسي داخل الكونغرس، يعبّر عن تحوّل في الوعي الأمريكي تجاه العلاقة بين الفكر الإخواني والإرهاب العابر للحدود، وهو تحولٌ يضع واشنطن أمام اختبارٍ أخلاقي وتشريعي في مدى اتساقها مع مبادئها في محاربة التطرف أياً كان لونه أو لغته.ورغم أن بعض الدوائر الاستخبارية تحفظت بدعوى تمايز فروع الجماعة في العالم، فإنّ الاتجاه الغالب داخل الكونغرس أصبح يميل إلى أن الفكر أخطر من السلاح، وأن من يشرعن العنف لا يختلف عن من يمارسه.
وفي الرد على الذين يرو ان تنظيمات الإخوان المسلمين المتعددة في العالم لا تشكل كيانًا موحدًا، نقول ان التعدد الشكلي للفروع لا يلغي وحدة المنهج، إذ يجمعها فكر واحد وبيعة فكرية وتنظيمية أصلها مدرسة حسن البنّا وسيد قطب. لقد صُممت اللامركزية في الجماعة لتكون درعًا وقائيًا يتيح التملص من المسؤولية عند كل مواجهة، لا دليلاً على استقلال تلك الفروع. أمّا الادعاء بأن بعض الأذرع تمارس نشاطًا “سلميًا”، فلا ينفي أن الأصل العقائدي واحد هو الذي أنجب خطاب التكفير والتمكين، وخرجت من عباءته التنظيمات الأكثر تطرفًا. وتصنيف الإخوان لا يستهدف التدين أو العمل السياسي الإسلامي، بل يواجه النسق الفكري العابر للحدود الذي يجعل الولاء للتنظيم فوق الوطن، ويحوّل الدين إلى أداة صراع لا وسيلة إصلاح
في أوروبا والعالم العربي، اتخذت المواجهة أشكالًا موازية. ففرنسا شدّدت الرقابة على الجمعيات المرتبطة بالفكر الإخواني بعد سلسلة تقارير أمنية حذّرت من اختراق مؤسسات التعليم والمجتمع المدني. وفي ألمانيا وهولندا وبلجيكا وبلدان البلقان، وُضعت عشرات الجمعيات تحت المراقبة، بينما حظرت النمسا رسميًا رموز الجماعة وشعاراتها. أما في الخليج العربي ومصر، فقد سبق التصنيف منذ سنوات، حين أدرجت السعودية والإمارات والبحرين الجماعة في قوائم الإرهاب عام ٢٠١٤، معتبرةً أن مشروعها يهدد الأمن الوطني ويقوّض سيادة الدولة باسم “الأمة”. وفي تونس والمغرب، بقيت بعض الأذرع السياسية في المشهد لكنها فقدت الزخم الشعبي بعد أن انكشف ضعف أدائها وانغلاقها الفكري.
إن بقاء الحركة الإسلامية في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في السودان يشكّل خطرًا بنيويًا على أي مشروعٍ وطنيٍّ للنهضة أو الإصلاح. فهذه الحركة، التي نشأت على فكرة “التمكين” لا المشاركة، ترى الدولة غنيمةً لا مسؤولية، وتعتبر الاقتصاد وسيلة تمويلٍ للولاء لا للبناء. ومنذ استيلائها على السلطة عام ١٩٨٩، أحكمت قبضتها على البنوك والشركات والمؤسسات العامة، فحوّلتها إلى شبكاتٍ حزبية مغلقة تعمل خارج منظومة الشفافية والمحاسبة. وحتى بعد سقوط نظامها في ٢٠١٩، ظلّت هذه الشبكات الاقتصادية والأمنية تعمل في الخفاء، تموّل الفوضى وتُضعف الدولة، لتبقى قادرة على تعطيل أي مسارٍ مدنيٍّ حقيقي.
لقد حاولت جهات دولية وإقليمية، ومن ضمنها ما عرف “بخارطة طريق الرباعية” لتهيئة الانتقال بعد الحرب إبعاد ممثّلي الحركة عن ترتيبات ما بعد النزاع كخطوة استباقية، لكنّ هذه الخطوة وحدها لا تزال ناقصة، فقد تعيد ترتيب الوجوه لكنها لا تفكك البُنى، ولا تفرض ضمانات كافية لمنع عودة شبكاتها الدفينة. وبهذا المعنى تبقى الحركة الإسلامية “دولةً عميقة” متمتِّعةً بقدرةٍ على الانبعاث ما لم تُتخذ إجراءاتٍ قانونيةٍ حاسمة تلي التهميش المؤقت، ومن أهمها إخراجها من الحياة السياسية عبر تصنيفها كمنظمة إرهابية ومن ثم تفكيك شبكاتها الاقتصادية والأمنية. إن استمرار هذه المنظومة في الحياة العامة يعني بقاء دولةٍ موازية تمتصّ موارد الوطن وتمنع ميلاد دولة عادلةٍ حديثة؛ وتفكيك هذا الإرث ليس عملاً انتقاميًا، بل ضرورة وطنية لحماية فكرة الدولة نفسها من الانهيار.
إنّ ترك الدولة العميقة التي تسيطر عليها الحركة الإسلامية دون مواجهةٍ جذرية سيقود السودان إلى دورةٍ جديدةٍ من الانهيار المزمن. فهذه البُنية التي صاغتها الجماعة خلال ثلاثة عقود لا تزال تحتفظ بمفاتيح المال والإدارة والولاءات داخل مؤسسات الدولة، وتعمل كجهازٍ موازٍ يفرغ أي عملية انتقال من مضمونها. فإذا لم تُقتلع هذه الشبكات قانونيًا وسياسيًا، فستعيد إنتاج السلطة تحت مسمياتٍ جديدة، وستُفرغ الاتفاقات من روحها كما فعلت مرارًا منذ التسعينيات.
إنّ الخطر الحقيقي لا يكمن في عودة الإسلاميين إلى الحكم صراحةً، بل في بقائهم كطبقة ظلّ تتحكم في مفاصل القرار، وتدير الصراع من وراء الستار. حينها لن تكون الحرب الأخيرة نهاية الخراب، بل بدايته الجديدة بأدواتٍ أكثر دهاءً. لذلك فإنّ أي تسويةٍ لا تتضمن تفكيك هذه المنظومة وملاحقة مواردها السياسية والاقتصادية، ستمنحها فقط وقتًا كافيًا لإعادة التموضع. إنّ مستقبل السودان المدني لن يُبنى ما دامت الدولة العميقة تتنفس داخل جسد الدولة الحديثة، وما لم تُقطع شرايينها المالية والتنظيمية بقرارٍ وطني ودولي واضح يصنّفها ضمن الكيانات الإرهابية، ويمنع عودتها إلى المشهد تحت أي لافتةٍ جديدة.
إن نهج الإخوان في جوهره نقيض للإسلام نفسه، لأنهم جعلوا الولاء للتنظيم فوق الولاء لله، وجعلوا الدين وسيلةً للسيطرة لا طريقًا للخلاص. فالدين في أصله جاء ليحرر الإنسان من عبودية السلطان، وهم أعادوه عبداً تحت راية “المرشد” و”البيعة”، في مفارقةٍ مؤلمةٍ بين ما نزل من السماء وما يُمارس على الأرض.
ولذلك فإنّ تصنيف الحركة الإسلامية السودانية والإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية ليس استهدافًا للدين أو المؤمنين، بل تحريرٌ للدين من سطوة التنظيم، وحمايةٌ للحرية والعدالة والسلام من الاستغلال باسم السماء. فكل مشروعٍ يستبدل الوطن بالجماعة، ويجعل الولاء للحزب مقدّماً على الولاء للإنسان، هو مشروعٌ مضادّ لفكرة الدولة الحديثة ولجوهر الإسلام الإنساني الذي جاء ليقيم العدل لا السلطان.
إن تصنيف هذه الجماعات خطوة نحو سلامٍ عالميٍ أكثر صدقًا وعدالةٍ أكثر إنسانية، لأن مواجهة التطرف لا تكون بالقمع وحده، بل بفضح زيفه الفكري، وكشف تناقضه مع مقاصد الدين الكبرى. لقد آن للعالم، وللسودان خاصة، أن يغلق هذا الملف المظلم، لا بروح الانتقام بل بروح العدالة، حتى يتطهر الدين من شوائب السلطة، وتتعافى الدولة من سرطان الأيديولوجيا. عندها فقط، يمكن أن يولد الوطن من جديد، حرًّا، عادلًا، وسالمًا من قداسةٍ زائفةٍ جعلت من الله غطاءً للدماء.