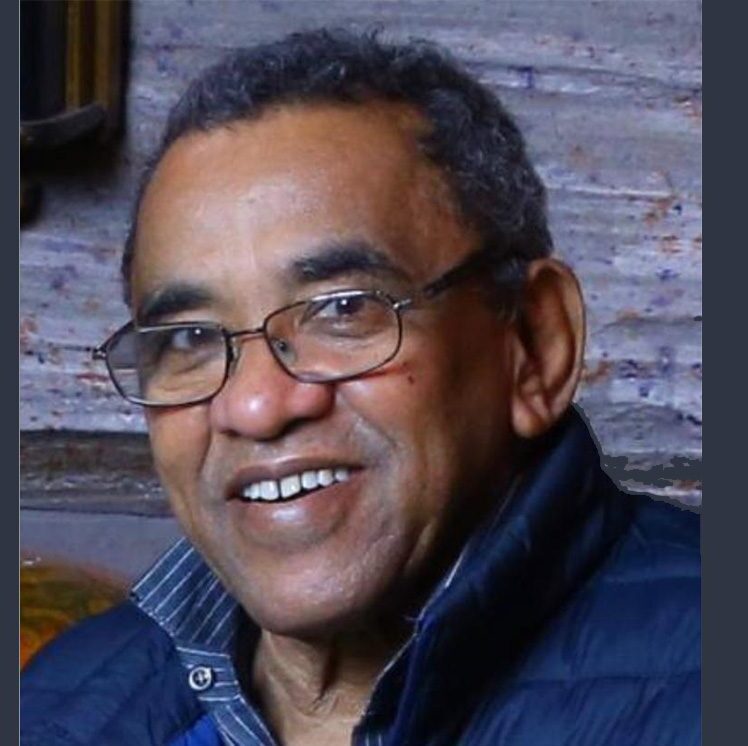
صباح اليوم، وصلتني رسالة واتساب يقول فيها كاتبها:
«اصدق ايه يا دكتور؟ الفاشر صامدة في إيد الجيش والمشتركة، تم نظافة المدينة هذا الصباح، وما زال في الأطراف.»
قرأتُ الرسالة وأنا أستمع في اللحظة ذاتها إلى إذاعة الـ BBC، تنقل خبراً عاجلاً:
«قوات الدعم السريع تسيطر بالكامل على الفاشر.»
ابتسمت، ثم تمتمت: لاحول ولا قوة إلا بالله.
منذ عام ١٩٦٤ وأنا أتعامل مع الكيزان، أعرف طريقتهم: قول النقيض بثقة، حتى يصبح الوهم عقيدة.
من هذا الإصرار ولدت صحيفتي الحائطية القديمة في جامعة الخرطوم — مقصّات — التي كانت تتندر على الكيزان والشيوعيين معًا.
أتذكّر مرةً أنني رأيت بعيني شيوعيًا وكوزًا يتعاطيان العرقي في بيت عرسٍ في الخرطوم بحري، ثم اشتدت المناقشة بينهما: كلٌّ منهما يقسم أن الآخر سيدخل النار!
لكن إصرار الكوز كان أقوى وأعجب — كأنما يحمل في جيبه شهادة دخول الجنة مختومة بختم الحركة الإسلامية.
واليوم، بعد ستين عامًا، لم يتغيّر شيء.
ما زالوا يصدّقون ما يريدون، لا ما يحدث.
حتى وهم يرون المدن تسقط، يردّدون: «الفاشر صامدة.»
ثم حين تتهاوى، يغيّرون الرواية في لحظة: «الجنجويد ارتكبوا إبادة عرقية.»
لا أحد ينكر الجرائم إذا ثبت وقوعها، لكن الإنكار الانتقائي هو جوهر الخديعة: أن تراهم يتباكون على ضحايا دارفور اليوم بعد أن صنعوا آلة القتل بأنفسهم بالأمس.
فالإنكار عند الكيزان لم يكن مجرد وسيلةٍ لتبرير الفشل، بل أصبح نظام حكمٍ قائمٍ على قلب الحقائق.
طوال عقود، كان الإعلام عندهم يخلق واقعًا موازيًا — وطن “ينتصر” وهو ينهار، وجيش “وطني” يقتل أبناءه، وحركة “إسلامية” لا تعرف من الإسلام إلا الشعارات.
وهكذا، تحوّل الإنكار إلى جمهوريةٍ قائمةٍ بذاتها، لها رئاسة وأجهزة وناطقون رسميون، يعيش مواطنوها داخل الفقاعة، يستهلكون الأكاذيب كما يستهلكون الخبز.
الفاشر لم تسقط في يد أحد؛ إنها تحرّرت من الأكاذيب، ولو مؤقتًا.
المدينة التي عرفت المجاعة والحصار، لم يكن فيها “نظافة هذا الصباح”، بل نظّفت نفسها من خطاب الكذب.
في زمن “جمهورية الإنكار”، يصبح قول الحقيقة عملاً ثوريًا، ويصير الضحك على الكذب مقاومة.
لذلك كانت “مقصّات” — في زمنها — أكثر من صحيفة حائطية؛ كانت تمرينًا على كسر الخوف من السلطة والقطيع.
واليوم، في الفاشر، يتكرّر التمرين ذاته على نطاق الوطن كله:
مدينةٌ محاصَرة تعيد تعريف الشجاعة، ووعيٌ جمعي يخرج من بين الركام ليفضح دولة الكذب.
من صحيفة مقصّات إلى الفاشر، ما زال الدرس نفسه قائمًا:
الشمولية لا تموت بالكلمة، بل بالوعي الذي يرفض تصديق الكذب ولو تزيّن بالوطنية.



