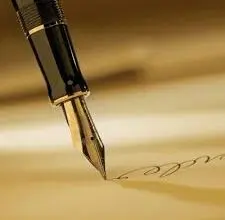يقدّم الدكتور وليد مادبو في مقاله “نشيد الدم” خطابًا يزعم تحرريًا، يسعى لتفكيك مركزية النخب النيلية عبر استدعاء رمزية “تحرير الفاشر”. غير أن هذا الخطاب، في جوهره، يقع في فخ التناقض الجدلي؛ إذ يحاول التحرر من نظام الهيمنة عبر تبنّي أدواته الإقصائية ذاتها، فيعيد إنتاج المنطق الذي ينتقده — وإن تحت لافتات جديدة.أولاً= المأزق الإبستمولوجي — حين يتحول النقد إلى مرآة للذات يسقط مقال مادبو في ما يمكن تسميته بـ”مفارقة النقد الذاتي”، حيث يتحول الخطاب الناقد للاستعلاء إلى خطاب استعلائي آخر. فالدعوة إلى “تحرير الفاشر من نخاسة النخب النيلية” — كما يقول مادبو حرفيًا- «تحرير (وليس سقوط) الفاشر يعني بالضرورة تخلص الريف الدارفوري كافة من وصاية العصابة الإنقاذية، بيد أن الدلالة الكبرى تتمثل في تحرر هذه الشعوب من هيمنة النخب النيلية التي تسللت إلى موقع النفوذ الاقتصادي والسياسي…
من خلال امتهانها لدور النِّخاسة في تجارة الرق»[^1] — تظل أسيرة الثنائية الزائفة (المستعمِر/المستعمَر) التي نقدها فانون ومفكرو ما بعد الاستعمار.
إنها استبدال لهيمنة بأخرى تحت شعار التحرر، في وقتٍ يفترض أن تتحول فيه الممارسة السياسية من صراع هويات إلى مشروع عقد اجتماعي قوامه سيادة القانون لا العصبية، كما صاغه روسو وكانط. فبناء هوية وطنية على أساس الدم
أو العرق ليس تحررًا، بل تراجع عن مبدأ المواطنة ذاته.ثانيًا: فلسفة التاريخ والذاكرة الجريحة — بين التذكر والانتقام يقرأ مادبو التاريخ بانتقائية، محوّلًا الماضي إلى سردية أحادية تختزل تعقيداته في ثنائية ظالم ومظلوم. مثل هذه القراءة تتجاهل درس مدرسة الحوليات الفرنسية (بروديل ومن معه) التي رأت في التاريخ تراكبًا لطبقات الزمن الاجتماعي لا صراعًا أحاديًا.
ومع الاعتراف الكامل بجراح دارفور التاريخية — من التهميش الاستعماري إلى مجازر 2003-2004 — وكما يعترف مادبو نفسه بـ”الإشراقات” التي طبعت مساهمة النخب النيلية في بناء الدولة بعد الاستقلال
(في الإدارة، التعليم، القضاء، الشرطة)[^2]، إلا أن إلقاء “ذنب تاريخي” على جماعة إثنية بعينها هو انزلاق من النقد البنيوي إلى اللوم الجمعي، وهو ما حذرت منه هانا أرندت وبول ريكور. فحين تتحول الذاكرة إلى أداة للثأر
تفقد دورها كجسر نحو الوعي، وتتحول إلى سجن يعيد إنتاج الكراهية.ثالثًا: سوسيولوجيا السلطة — من العرق إلى البنى الهيكلية
يخلط المقال بين “النخب النيلية” كبنية سلطوية قائمة على تحالف مصالح، وبينها ككيان عرقي متجانس.
وهذا خطأ تحليلي يتجاهل مقولات بورديو حول رأس المال الرمزي والثقافي كآليات لإعادة إنتاج الهيمنة، وهي تتجاوز الإثنية والجغرافيا معًا.
[^3] فالتحرر لا يكون بإحلال مركزية مضادة مكان المركز القائم، بل بتفكيك منطق المركزية ذاته. وهو ما دعا إليه إدوارد سعيد حين حثّ على تجاوز الثنائيات الزائفة — مركز/أطراف، شمال/جنوب — نحو فضاء هجين تتعايش فيه الهويات بلا وصاية.
[^4]رابعًا: الأخلاق والسياسة — استحالة فصل الوسائل عن الغايات
الدعوة إلى “تحرير الفاشر” كحدث عسكري رمزي — كما يصفها مادبو: «اقتلعوا آخر شِعبة من ‘زريبة عمسيب’ تمهيداً لتفكيك إرث العبودية» — تصطدم بالمبدأ الأخلاقي القائل بأن الغاية لا تبرر الوسيلة.
فالمشروع الذي يبدأ بالعنف لا يمكن أن ينتهي بالسلام.
وهذا ما أدركه غاندي ومارتن لوثر كينغ حين جعلوا اللاعنف وسيلة للتحرر الإنساني لا للصراع الهوياتي. تجربة جنوب أفريقيا بقيادة ديزموند توتو تقدم الدليل الأوضح: العدالة التصالحية لا الانتقامية هي الطريق نحو معالجة جروح التاريخ.
فمجتمع يُبنى على الثأر، كما يقول هابرماس، يعيد إنتاج الظلم في دائرة لا تنتهي.خامسًا: نحو إبستمولوجيا تحررية جديدة — تجاوز ثنائية الجلابة والزرقة المعضلة الجوهرية في خطاب “نشيد الدم” هي بقاؤه داخل الإطار المعرفي نفسه الذي ينتقده. فهو لا يفكك الهيمنة، بل يعيد توزيعها.
إن التحرر، كما يطرح أمارتيا سن، لا يتحقق بتغيير المتحكمين، بل بتوسيع قدرات البشر جميعًا عبر مؤسسات تكفل المساواة والفرص والكرامة.
يجب أن ننتقل من سؤال “من يحكم؟” إلى سؤال “كيف نبني نظامًا يمنع أي أحد من الهيمنة؟”.سادسًا: البيان التأسيسي لمواطنة ما بعد الهوية إن دروس الصراع السوداني تفرض علينا الانتقال من شعارات الدم إلى فلسفة الإنسان. ولتحقيق ذلك، يلزمنا مشروع وطني يقوم على أربع ركائز= القطيعة مع البيولوجيا السياسية= فصل تام بين الهوية والمواطنة كما دعا إليه هابرماس في مفهوم “الدستورية الوطنية”.
الاعتراف بالتعدد دون انغلاق- تبني نموذج “التعددية التكاملية” التي توازن بين الخصوصية والوحدة.
العدالة شرط المصالحة: العدالة التصالحية أساس لبناء المستقبل المشترك.
عقد اجتماعي جديد: يؤسس للمساواة في المواطنة وعدالة التوزيع وتداول السلطة.
وفي سياق الحرب الدائرة منذ 2023، تُقدم مبادرات مثل “نداء السودان الجديد” (2024) أو لجان المقاومة في الفاشر نموذجًا أوليًا لعقد اجتماعي يجمع بين أبناء النيل ودارفور، بعيدًا عن سرديات الدم والانتقام.من سردية الدم إلى سردية الإنسان لن يتحقق “تحرير الفاشر” بتحويلها إلى رمز للانقسام، بل حين تُستعاد بوصفها رمزًا للوطن المشترك. فالتحرر لا يكون بفتح جراح جديدة بل بترميم القديمة، ولا بالحديث عن دماء تُراق بل عن حياة تُبنى.
وكما يستشهد مادبو بالآية: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾، فإن التحرر الحقيقي ليس في عكس الهيمنة، بل في تحقيق هذه الإرادة الإلهية عبر عدالة تصالحية تشمل الجميع — من النيل إلى دارفور في وطن لا يُحكم بالدم، بل بالقانون والكرامة المشتركة. كما قال ألبير كامو في الإنسان المتمرد: “أتمرد، إذن نحن موجودون” — تمرد يبدأ بمواجهة الكراهية داخلنا، لا خارجنا فقط. فمستقبل السودان لا يُكتب بالحقد بل من خلال الاعتراف بأن إنسانيتنا المشتركة أكبر من هوياتنا المتنازعة.