جيل الإنقاذ بين اللذة والذنب: السودان في مرايا المكبوت النفسي

م. معاوية ماجد
“حيثما كان المكبوت، هناك سيعود.”
— سيغموند فرويد
في زمنٍ تشتعل فيه الخرائب في الفاشر والجنينة ونيالا، وتسيل الدماء في طرقات المدن المنسية، يطلّ جيلٌ من رماد الإنقاذ وهو يرقص.
جيلٌ يملأ فضاءات القاهرة وعواصم أخرى بعيدة، بالموسيقى والضحك، ينثر العطور في الهواء، ويغمر منصّات التواصل بصور الأعراس الباذخة والاحتفالات الصاخبة.
وفي وطن يختنق بأنينه، ثمة أمهات يفتشن في التكايا عن جوال دقيقٍ يسند حياة أطفالٍ بلا غد، ونساء يبحثن بين الركام عن خرقةٍ تستر الجسد، وصراخ فتياتٍ تحت الأسقف المنهارة لا يسمعه أحد.
هذه المفارقة ليست عبثًا، بل تجسيدٌ دقيق لما سمّاه فرويد بـ”عودة المكبوت” — حين تنفجر الرغبة المكبوتة بعد طول كبت، لا في وعيٍ حرٍّ ناضج، بل في شكلٍ هائجٍ من الإفراط والضياع.
لقد ربّت الإنقاذ أبناءها على الخوف لا على الإيمان، وعلى الطاعة لا على التفكير.
كانت دولةً تتغذّى من فوبيا الجسد واللذة، من شيطنة الفرح وتقديس الألم.
لم يكن الدين فيها إيمانًا يحرّر، بل سوطًا يجلد.
ثلاثة عقودٍ من التديين القسري للحياة، من عسكرة الروح والمجتمع، صنعت “أنا أعلى” متضخّمًا فوق كل مواطن، يراقب أنفاسه وخطواته وملابسه وأحلامه.
كان قانون النظام العام الذي فرضته الإنقاذ أقسى تجليات هذا القهر.
قانونٌ جعل الخروج إلى الشارع مغامرة أخلاقية، والنزهة تهمة، والابتسامة شبهة.
اعتُقل الآباء لأنهم ساروا بجانب بناتهم، واقتيدت الفتيات لأنّ بنطالًا أخفى أكثر مما أظهر، لكنه استفزّ سلطةً لا ترى في المرأة إنسانًا بل مشروع خطيئة.
كانت بيوت الخرطوم وأم درمان وكل مدن السودان، تعيش في فزعٍ دائم، النساء يسرن وظهورهن مثقلةٌ بالعيون التي تترصّد، والرجال يلتفتون خوفًا من شرطيٍّ يتربّص عند زاوية السوق.
حتى الضحكة كانت تمرّ عبر رقابةٍ خفية، كأن الهواء نفسه أصبح مراقَبًا.
في ظلّ هذا الخوف اليومي، كبُتت الرغبة، جُفّف الخيال، وتحول الجسد السوداني إلى مساحةٍ من الممنوعات.
كان على الإنسان أن يُسكت جسده ليكون طاهرًا، وأن يقمع رغبته ليُعدّ صالحًا، وأن يُخفي فرحه ليُعتبر تقيًّا.
ثم حين انهار النظام، لم يخرج الوعي من بين الأنقاض، بل خرج المكبوت بكل شراسته القديمة.
في القاهرة، تلك العاصمة التي تحوّلت إلى مرآةٍ كبرى للمنفى السوداني، تتجلّى المأساة في صورٍ ساطعة وموجعة. أعراسٌ تُقام في قاعاتٍ فارهة تُزيّنها الأضواء والورود، نساءٌ ورجالٌ وشبابٌ وفتيات يتباهون بملابس فاخرة، وضحكاتٍ تفيض في ليلٍ لا يعرف الظلام إلا من الأخبار. معارض للثياب السودانية تُعرض فيها تصاميم تتجاوز أسعارها الخمسين ألف دولار،
بينما في مدن الوطن المحترقة نساءٌ يبحثن عن ما يستر الجسد لا ما يُزّين،
ومزاراتٌ تفوح منها رائحة العطور التقليدية السودانية، تُعرض فيها زينة العروس بكل تفاصيلها الباذخة، بينما في الوطن الجريح نساءٌ يتعطرن بغبار المعارك المتصاعد من حوافر الخيل، وزئير عربات الدفع الرباعي، وَيَتَزَيَّنَ قصراً
بأنفاس المغتصبين الوحوش. إنه التناقض الذي يصنعه الكبت حين يتحول إلى نقيضه — من الزهد القسري إلى الترف المفرط، من الإنكار إلى الانغماس
يقول فرويد:
“القمع لا يُميت الرغبة، بل يجعلها تتخفّى في ثوبٍ آخر.”
وهكذا لبست الرغبة السودانية اليوم ثوب العطر والذهب والاحتفال.
لكنها ليست رغبةً بالحياة بقدر ما هي رغبةٌ في الهروب منها.
جيلٌ كان يُجلَد لأنه تزيّن، فها هو الآن يُغرق نفسه في الزينة.
جيلٌ كان يُؤمر بالصمت، فها هو يصرخ بالموسيقى.
جيلٌ أُجبر على طمس الجسد، فها هو يحتفل به، لا لأنّه تحرّر، بل لأنه لم يتعلّم بعد معنى الحرية.
المرأة، التي كانت لعقودٍ رهينة قانونٍ يلاحقها في الأسواق، صارت اليوم ترفع رأسها في العلن، لا لتغري، بل لتقول: “أنا هنا، جسدي ليس عيبًا بل شهادة على أنني نجوت.”
ومع ذلك، فإن هذه الحرية الجديدة، غير المشروطة بالوعي، تُهدّد بأن تُعيد القيد في شكلٍ آخر — قيد الصورة، قيد المظاهر، قيد الاستعراض الذي يستبدل سياط الواعظ بعدسات الكاميرا.
أما الرجل السوداني الذي نُزعت منه البوصلة، فيعيش اليوم بين لذّةٍ لم يتعلّم حدودها وذنبٍ لم يتعلّم معناه.
من تربّى على أناشيد الجهاد ومناهج الولاء والطاعة يجد نفسه الآن بين ضجيج الحفلات وألوان المدن الغريبة، كطفلٍ خرج من الكهف إلى الضوء فبهَره البريق وأعماه.
إنه جيلٌ يعيش صراع “الهو” الذي تحرّر فجأة من سلطة “الأنا الأعلى”، من قيد الدولة الدينية، لكنه لم يجد بعد “الأنا” التي تنظم حريته وتوجّهها.
وهذا ما يجعل صراخه في الملاهي، وصوره على الشاشات، وضحكاته المبالغ فيها، أشبه بصرخةٍ مؤجلة، لا فرحًا نقيًّا.
ما نعيشه اليوم ليس ترفًا بريئًا ولا انحلالًا عابرًا، بل عرضًا لمرضٍ جماعيٍّ قديم — جرح القهر الذي لم يُعالَج بعد.
لقد ورث هذا الجيل تركة ثقيلة من الخوف والتناقض، وحين أُتيحت له الحرية، لم يعرف كيف يستخدمها إلا ضد نفسه.
إنه جيلٌ يحاول أن يتصالح مع جسده ومع رغبته ومع وطنه في آنٍ واحد، لكنه يفعل ذلك بعشوائية الظمآن.
ولذلك، فإن الحلّ لا يكمن في الإدانة ولا في الوعظ، بل في الفهم.
في أن نقرأ هذا السلوك كأعراضٍ نفسية لوطنٍ مريضٍ بالقمع، لا كخطيئةٍ أخلاقية.
فالتحرّر الحقيقي ليس في كسر القيود فحسب، بل في بناء وعيٍ جديد يوازن بين الحرية والمسؤولية، بين اللذة والمعنى.
“Out of your vulnerabilities will come your strength.”
— سيغموند فرويد
من هشاشتنا تولد قوتنا.
ومن فهم جرحنا نبدأ الشفاء.
حين نعترف أن ما نعيشه ليس عبثًا بل وجعًا مؤجّلًا، يصبح الفرح فعل مقاومة لا نسيان، وتصبح الحرية طهارةً جديدة من الخوف لا استبدالًا له.
إن جيل الإنقاذ، رغم كل تناقضاته، هو أول جيلٍ يملك شجاعة النظر في المرآة — لا ليزيّن وجهه، بل ليرى ما تحت الجلد: وطنًا بأكمله يحاول أن يتعلّم كيف يحبّ نفسه بعد أن علّموه كيف يكرهها.

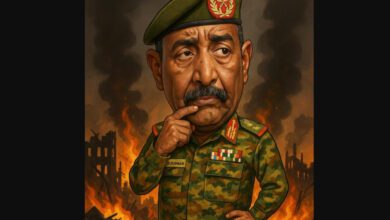
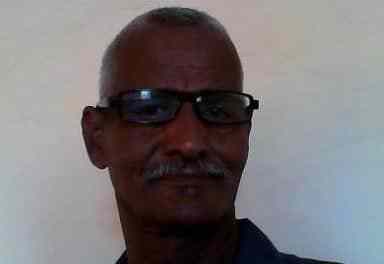

لعمري هذا في رأيي أعمق و أفيد و أجمل مقال لك أيها الأخ م. معاوية ماجد. أتمنى أن تتحفنا بمزيد من شاكلة هذا المقال. لك التحية و التقدير.
مقال كشف محور مھم في الصراع القائم.. م/معاوية.. من حيث وجوب النظر للحرب من الناحية النفسية المھمة جدا.. بعد نفاذ محاولة الاطراف المنخرطة بالحرب بالتمثل بالملائكة دون بلوغ الحد الادنى من السلام للمواطن (عم عبدالرحيم..واھلھ) فحبذا لو تناول المختصون كل في مجالھ تحليل المساءلة من منظور علمي بحت.. ديني، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي.. من باب تحقيق الحد الادنى من التوافق وتغليب حق الله وحملة عرشھ والملائكة والرسل.. ودمتم