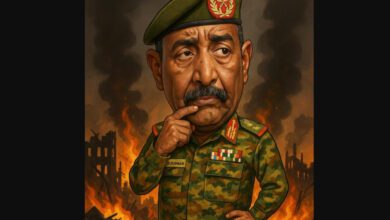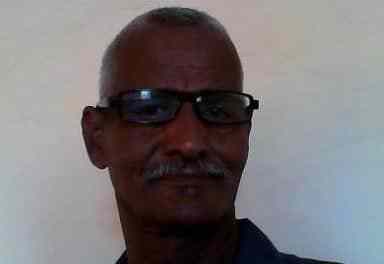رحلة قصيرة بين المهد إلى اللحد
بقلم الكاتب: عبدالحميد عطيف
⸻
تمهيد
لا يمكن فهم مأساة الفاشر في القصيدة بمعزلٍ عن سلسلة الانفصالات والجراح التاريخية التي شهدها السودان، فمنذ استقلاله ظلّ الوطن يعيش في صراعٍ بين أطرافه، يئنّ تحت وطأة الانقسامات العرقية والثقافية والسياسية.
وبعد أن ذهب الجنوب، ظنّ البعض أن الجرح سيندمل، فإذا به يتسع في الغرب — في دارفور والفاشر على وجه الخصوص — حيث تكرّرت المأساة بأشكالٍ أكثر إيلامًا.
بهذا المعنى، تأتي القصيدة وكأنها تأمّلٌ في قدر السودان الموزّع بين الفقد والانقسام، فالأم التي فقدت ابنتها في الفاشر سبق أن فقدت أبناءها في الجنوب، وربما تخشى أن تفقد بقيّتهم في الشمال والشرق. وهكذا يتبلور النص في شكل مرثيةٍ لوحدةٍ وطنيةٍ تتهاوى، وصرخةٍ من قلب التاريخ تقول: إن ما يحدث في الفاشر ليس حادثةً طارئة، بل امتدادٌ لجرحٍ قديمٍ في جسد الوطن.
⸻
نص القصيدة
وكنتُ أحلمُ دومًا أن أكون لها
أمًّا رؤومًا، وقلبًا راسخَ العمدِ
تحرّكتْ روحُها في داخلي وَهَنًا
طفقتُ أشعر بالأفراح والسعدِ
ربَّيتُها زمنًا حتى ترى أثري
علَّمتُها الحرفَ والتنزيلَ في كَبَدِ
قد كنتُ أرقبُ يومًا زانَ مطلعُه
تصير بنتي منارًا للعُلا الأبدي
وأنظر الغرسَ قد بانت ملامحه
وأرقب الأملَ المرسومَ في خلَدي
وأرتجي غدَها حتى أتيهَ بها
لكنها هجرتْ لما أتاها غدي
فجاء يومٌ سوادُ الليل كلّلَهُ
فيه الرجولةُ تذوي داخل اللحدِ
يومٌ رزيٌّ به الأخلاقُ في عَدَمٍ
هبّوا طغاةً بغاةً في أسى البلدِ
دُنيا تُنكّس عمدًا كلَّ شامخةٍ
فالبُومُ حلَّ محلَّ البازِ والأسدِ
حشدٌ من النحس ظلّامٌ لغاليتي
حشدٌ قويٌّ عَتِيٌّ كاملُ العَدَدِ
دكّوا حصونًا وعاثوا حيثما وجدوا
شالوا البراءةَ والأحلامَ للأبدِ
فطفلتي في عراء الأرض مصرعُها
يبكي لها الصخرُ، والأطيارُ لم تَعُدِ
وجلدُها جفّ مثل العودِ إذ خلدتْ
للموتِ قهرًا، وما للغوثِ من أحدِ
يا بنتَ ذي الكرمِ المشهودِ في زمنٍ
عزَّ المجيرُ، وطالتْ في الرّدى مُدَدي
فـ«الفاشر» اليومَ تأبى أن تعاتبَنا
ماذا يفيدُ عتابٌ فاقدَ الرَّشَدِ؟!
والفاشرُ اليومَ في حزنٍ وفي مِحَنٍ
ترجو المعينَ ليأسو الجرحَ في كَمَدِ
حلمٌ تَبَعثرَ في أرجائها أبدًا
لم ينفعِ السعيُ فيها، لا، ولم يزِدِ
والفاشرُ اليومَ في غبنٍ وفي جزَعٍ
قلبُ الأمومةِ يبكي فُرقةَ الولدِ
صمتُ البريّةِ صمتٌ لا خلاصَ لهُ
زادت — كثيرًا — جراحُ الروحِ والجسدِ
والفاشرُ اليومَ تأوي نحو هاويةٍ
تخشى القدومَ وتخشى طالبَ الرَّصَدِ
والفاشرُ اليومَ في خوفٍ وفي وَجَلٍ
ترجو «عليًّا» الذي في الناسِ لم يفِدِ
باتتْ على أثرِ اللاهينَ ما فتئتْ
تشكو السقامَ، وتشكو قلّةَ المَدَدِ
وأطبقتْ جفنَها المدفونَ في ألمٍ
وأسلمتْ روحَها من قلّةِ السَّنَدِ
⸻
تفاصيل القراءة
أولًا: العنوان
«رحلة قصيرة بين المهد إلى اللحد»
عنوانٌ بالغُ التوفيق والذكاء من حيث الإيجاز، والوقع الدلالي، والتمهيد العاطفي للنص.
فهو — على بساطته من حيث التركيب — يستوعب المأساة كلها في خمس كلماتٍ مألوفة، لكنها مشحونةٌ بدلالاتٍ معرفيةٍ وإنسانيةٍ كثيفة، تشكّل فيه كلمتا المهد واللحد قطبي الحياة والموت، وتختزل عبارة رحلة قصيرة قِصَر الأمل، وهشاشة الوجود، وعبثية المصير.
وتتجلّى براعة الشاعر في استخدام اللفظ «بين» على نحوٍ غير مألوف، إذ كان يمكنه أن يقول: رحلة قصيرة من المهد إلى اللحد، لأن الرحلة تُبتدأ بـ«من» وتنتهي بـ«إلى».
لكن اختياره بين لم يكن سهوًا، إذ أراد أن يخلق تأثيرًا دلاليًا يلفت الانتباه إلى ما هو متخفٍّ في ثنايا الرموز والألفاظ.
فـ«بين» توحي بالوقوف في منتصف المسافة، أي أن الرحلة ليست إلّا مسافةً قصيرةً معلّقة بين بدايتين: المهد واللحد، بما فيها من إيحاءٍ بالضيق والاختناق. كما أن الانتقال من «بين» إلى «إلى» في الجملة نفسها يخلق نوعًا من التوتر الصوتي بين الاستقرار والحركة، وكأن اللغة نفسها تتعثّر من هول المعنى.
ثانيًا: مطلع القصيدة
يبدأ الشاعر بقوله:
وكنتُ أحلمُ دومًا أن أكون لها
أمًّا رؤومًا، وقلبًا راسخَ العمدِ
بدأ بحرف العطف الواو، وهذا يثير السؤال: ما المعطوف عليه؟
في مثل هذا الموضع ليست الواو للعطف النحوي الحقيقي على جملةٍ سابقة، بل تُسمّى واو الاستئناف أو واو العطف على محذوفٍ مقدّر، يُراد بها الإشارة إلى وجود ما قبلها من أحداثٍ أو ذكريات.
يبدو الكلام كأنه امتدادٌ لحديثٍ سابقٍ لم يُذكر، لكنه يُفهم من السياق، فالواو هنا تفتح النص على ما قبله، وبهذا يحقق الشاعر انتقالًا دراميًّا فوريًّا إلى قلب الحدث، فيغدو المطلع امتدادًا لعمرٍ سابقٍ من التمنّي، لا بدايةً جديدة له.
إنها واو الوجدان التي تربط الحاضر بالماضي، وتُضفي على التجربة طابع الاستمرار والعمق الزمني في آنٍ واحد.
لكن النصّ — من خلال دلالة اللفظ بين في العنوان كما أشرت آنفًا — يلفت انتباهنا إلى بنيته الزمنية المعكوسة التي لا تسير من الحلم إلى الفاجعة، بل من الفاجعة إلى الحلم، ومن النهاية الواقعية الراهنة إلى البداية الشعورية الماضوية.
فالمطلع: «وكنتُ أحلمُ دومًا أن أكون لها أمًّا رؤومًا…» لا يعبّر عن بداية الحدث، بل عن ذاكرةٍ تستعيد ما كان قبل الفاجعة؛ أي أنه قولٌ يأتي من موقع الحداد لا من موقع التوق.
وبهذا الفهم تكون الواو من الناحية الفنيّة ليست عطفًا على شيءٍ مقدّر، ولا استئنافًا لحديثٍ سابق، بل عطفًا على ما وقع بعده من سردٍ للأحداث، وتحديدًا قوله:
وأطبقتْ جفنها المدفون في ألمٍ
وأسلمتْ روحها من قلّة السندِ
وبهذا المعنى، ينقلب تسلسل الزمن في القصيدة من خطٍّ تصاعدي إلى منحنى استرجاعي، يجعل النصّ كله حركةً إلى الوراء، ابتداءً من الفاجعة المنتهية بالموت في نهاية النص، وانتهاءً بالحلم في مطلع النص.
وهنا تتجلّى براعة الشاعر في جعل الأم (رمز السودان) تتحدّث من قلب الخراب، لتروي ماضيها الحالم بصوتٍ يختلط فيه الحنين بالرثاء.
وهكذا يخلق الشاعر توازنًا جماليًّا وإبداعيًّا راقيًا بين شكلٍ خارجي يبدأ بالحلم وينتهي بالدمار، ومضمونٍ زمني داخلي يبدأ بالدمار لينتهي بالحلم.
إنّ ترتيب الزمن في القصيدة لا يخضع للمنطق الخارجي، بل لنبض القلب؛ فكل بيتٍ فيها ارتجافٌ بين ما كان يمكن أن يكون، وما لم يعد ممكنًا.
ثالثًا: الذاكرة والوجدان
تتكئ القصيدة على ذاكرة وطنٍ مثقلةٍ بالذكريات المرّة والجراح التي تتسع ولا تندمل. يرويها الشاعر على لسان الأمّ السودانية، لا لتسرد ما حدث، بل لتعيد تركيب الزمن في داخلها كي تستوعب كيف تحوّل الحلم إلى كارثة.
فكل بيتٍ هو ارتدادٌ داخليٌّ، لا إلى الماضي كما كان، بل إلى الماضي كما تشعر به الآن — ماضٍ مشحونٌ بالحنين والعجز.
والأم هنا ليست إلّا روحَ وطنٍ كامل — السودان — يرى أبناءه يُساقون إلى الموت، ومدنه تُغتال واحدةً تلو الأخرى، بينما العالم صامت.
رابعًا: تنامي المأساة
تبدأ القصيدة بحلمٍ أموميٍّ بسيط: أمٌّ تحلم بتربية ابنتها ورؤيتها منارةً في مستقبلٍ مشرق.
لكن هذا الحلم سرعان ما يتحوّل إلى كابوسٍ دامٍ حين تخطف الحرب والظلم تلك الابنة، فتسقط ضحية الفوضى والطغيان.
ومثل تدرّج الصراع على الأرض، تتدرّج المأساة في القصيدة في اتساقٍ عاطفيٍّ من أول بيتٍ إلى آخر بيتٍ فيها، مع تصاعد نغمة الأسى حتى تبلغ ذروتها في قوله:
وأطبقتْ جفنها المدفون في ألمٍ
وأسلمتْ روحها من قلّة السندِ
تلك الطفلة التي أطبقت جفنها ليست إلا مدينة الفاشر — المدينة السودانية التي عانت طويلًا من ويلات الحرب والاقتتال — فغدا موتها رمزًا لموت الوطن كله.
وفي المجمل، تشفُّ القصيدة عن ألمٍ وطنيٍّ عميق يتجاوز حدود الفاشر إلى رمزية السودان بأسره.
غير أن الشاعر لا يكتفي بتصوير المأساة الداخلية، بل يُضمّن نسيجه الشعري تلميحاتٍ حادّةً إلى خذلان العالم والعرب على السواء.
ففي قوله: «وما للغوث من أحد» و*«أسلمتْ روحها من قلّة السند»* يتجلّى إحساس الفقد المزدوج — فقدُ الابنة وفقدُ السند الإنساني — بينما يرمز قوله:
الفاشر اليوم تأبى أن تعاتبنا
ماذا يفيد عتابٌ فاقدَ الرشد؟!
إلى عالمٍ فقد وعيه الأخلاقي، فصار الصمت فيه رديفًا للتواطؤ. وهكذا يكتب الشاعر وجعه بلغةٍ أموميةٍ حنون، لكنه يجعل من الحنان نفسه أداةَ إدانةٍ راقية، إذ يغدو بكاء الأم على طفلتها صرخةَ وطنٍ خُذل، ومرثيةً لضميرٍ إنسانيٍّ غاب عن ميادين الفعل.
خامسًا: خاتمة القراءة
إن الفاشر في قصيدة الأديب الكبير الأستاذ طارق يسن الطاهر ليست مجرد مدينةٍ منكوبة، بل مرآةٌ لوطنٍ مكسورٍ في داخله قبل أن يُكسر من خارجه.
فالفاجعة التي حلّت بها ليست حادثةً جغرافيةً معزولة، بل هي خلاصة تختصر مأساة الأمة كلها.
ولعل من المناسب أن أشير إلى أن الشاعر، وهو يرثي الفاشر، لم ينسَ موضوعيته، وإن كان ذلك بإلماحةٍ ضمنيةٍ خاطفة.
فالفاشر — في عمقها الرمزي — ليست ابنةً وُلدت من رحم الوطن، وحين يخاطب الشاعر الفاشر بوصفها الابنة الغالية فإن الأم هنا — أي السودان — تبدو ممزقةً بين الحنوّ والعجز.
وهكذا تتشكّل مأساةٌ مزدوجة: مأساة الابنة التي انتُهكت براءتها ودُمّر مستقبلها، ومأساة الوطن الذي عجز عن حماية بناته. ومن هذا المنظور يتحوّل الرثاء في القصيدة إلى صرخةِ هوية، تستدعي ذاكرة الأمة السودانية لا لتبكيها، بل لتسائل الحاضر عن معنى الانتماء والخذلان.
وهكذا، فإن الرحلة القصيرة بين المهد إلى اللحد هي رحلة الفكرة السودانية نفسها: من الحلم إلى الخذلان، ومن الولادة إلى الفقد، ومن الأمل الجمعي إلى التفرّق والتشتت.
إنها ليست قصيدة رثاءٍ فقط، بل وثيقةُ ألمٍ تحفر في وجدان أمةٍ ما زالت تبحث عن معنى للحياة بعد كل هذا الموت.
ـــــــــ