ثقوب على جدار جدلية المركز والهامش 1-2

ثقوب على جدار جدلية المركز والهامش 1-2
مقدمة:
الذى أبدأ به هذا المقال هو توضيح هام من الضرورى تباينه وهو أن عملية “نقدى” لهذا السفر الهام الذى أحدث زخما غير عاديا عند الكثيرين لكن على نحو خاص بين “أنصاف” المثقفين، لا يمثل نقدا علميا كما هو معروف، بل هو “نقد” يمكن أن يوصف بأنه شتات “إنطباعات” حسب فهم ورؤية الناقد لما أطلع عليه ومثلما خرج الكتاب إنعكاسا لرؤية “الكاتب” كما ذكر بنفسه فى إحدى الندوات وأنه يعبر عما يراه لا ما يريده الآخرون.
الأمر الثانى أن عملية “النقد” لا تعنى كما نقول فى عاميتنا السودانية “شنافة” أى إتخاذ موقف مضاد يرفض كلما جاء من الطرف الآخر، إذا كان قولا شفاهيا أو صدر فى شكل كتاب يحمل رؤى وأفكار وتعريفات.
فالنقد عندى أو كما أظن بتعريفه الأكاديمى هو سياحة وتأمل للأفكار المطروحة في ذلك الكتاب يتفق فيها القارئ العادى أو الناقد المحترف مع الكاتب أو يختلف معه فى جزئية مما كتب أو مع كل ما كتب.
الأمر الثالث يقدر للدكتور الصديق “ابكر آدم إسماعيل” هذا الجهد “الفكرى” الذى بذله حتى خرجت رؤيته للعلن، مساهما فى قضية “الإستنارة” والتثقيف وإنتشار الوعى.
لكن طلما أنه جهد “بشرى” أى لا هو قرآن أو إنجيل، فلابد أن يشتمل على سلبيات مثلما يشتمل على إيجابيات.
ومن ثم اقول .. الذى إسفت له كثيرا هو الهجوم الشرس غير المبرر الذى وجه لكل من حاول أن ينتقد هذه الرؤية ، إذا كانت كما وردت فى الكتاب المعروف بعنوان “جدلية المركز والهامش ? قراءة جديدة فى دفتر الصراع فى السودان”، أو امفهومى التعريفى لقضية “الهامش والمركز” حتى لو إختلفت التسمية، كما حدث مع الدكتور/ حيدر إبراهيم.
فمن حق أى إنسان أن يسمى “الإختلال” الذى حدث فى شكل وبنية الدولة السودانية خلال العصر الحديث المحدد بفترة الإستعمار التركى المصرى والفترات التى تلته وأن يسميه “بالتهميش” أو بأى مسمى آخر، ومن حق أى إنسان خاصة إذا كان “مفكرا” أو مثقفا حاذقا، أن تختلف رؤيته مع الآخرين حول ذلك “التهميش” وهل هو من منظور”ثقافى” أم “إقتصادى”. المهم فى الأمر قوة حجة طارح الرؤية وقدرته على إقناع الآخرين بها.
واقول كذلك قبل أن أدلف للتفاصيل، لا يمكن أن ينكر عاقل وجود قدر من “الظلم” فى حق أهل الهامش أو سكان الأطراف أو الأرياف، وأن درجة ذلك الظلم تختلف من مكان لآخر ومنذ الزمن السابق وحتى اليوم قد نجد ظلما أكبر بالقرب من “مركز” المركز اى “العاصمة” أكثر من ظلم وقع على آخرين أكثر بعدا من ذلك الموقع.
الأمر الثانى الذى يجب الإعنراف به، فى السودان وحتى وقت قريب كان يمارس قدر من “العنصرية” تجاه إثنيات بعينها لإسباب مختلفة منها لون “البشرة” لكن هذا لم يكن وحده السبب.
بكل الصدق والأمانه فإن أكثر من عانى من تلك العنصرية هم أهلنا من جبال “النوبة” اصحاب البشرة “السوداء” ثم يليهم إخواننا الجنوبيين .. ثم بدرجة أقل “ابناء الغرب” عموما دون تمييز “كردفانى” أو “دارفورى” ومن عجب فإن هؤلاء أنفسهم كانوا الى جانب باقى المكونات السودانية الشماليه والأوسطية من ضمن الذين يمارسون العنصرية تجاه النوبة والجنوبيين .. ثم بصورة أقل من اؤلئك تمارس عنصرية تجاه مجموعات أخرى هى “الراطنة” بشكل عام بمن فيهم من دناقلة وحلفاويين ومحس وكل من يتحدث لغة أخرى غير العربية.
ثم هنالك عنصرية باشكال أخرى مختلفه قد لا ترقى لتلك العنصرية، مثلا السودانى الأبيض اللون فهو “حلبى” وحتى إذا لم يقل له فى وجهه، فإنه يبقى فى نظر باقى السودانيين “تركى” أو “ولد ريف” حتى لو وجد جدوده فى السودان منذ 50 سنة لا خمس سنوات.
وهناك عنصرية وجدتها فى أكثر من مكان، فى الشماليه مثلا وجدت مجموعة من الناس تعيش بعيدا عن باقى السكان وحينما سألت عنهم قيل لى بكل “عفوية” .. “ديل عرب ساكت”!
ثم كانت المفاجأة الأشد من ذلك بأن سمعت نفس العبارة شمال أم درمان تجاه مجموعة مشابهة لأولئك العرب والذين رددوا تلك العبارة “ديل عرب ساكت” هم “العرب” الذين يصفهم بعض الكتاب وكما ورد فى كتاب الدكتور/ ابكر آدم إسماعيل “جلابة”.
ثم هنالك عنصرية وتفرقة تحدث فى مجتمعاتنا داخل القبيلة الواحدة كما هو معروف فى “غرب” السودان، ثم عنصرية أقل كثيرا وفى اضيق الحدود تصل أحيانا الى داخل الاسرة الواحدة وتلك هى التفرقة المبنية على المستوى “التعليمى” للفرد وقد تصل درجة الا يزوج إبن العم من بنت عمه التى يحبها لا لتدنى مستواه التعليمى بل لتدنى مستوى تعليم أبيه!
على كل وبما أنى محسوب على “المركز” بحسب “تصنيف” البعض منا رغم إبتعادى عن السودان كله لسنوات طوال ورغم إنتمائى “للهامش” أو “للأطراف” جذورا تاريخية ثم إحساسا وشعورا بمعاناة الأنسان فى ذلك المكان أى كانت جهته والذى سماه الدكتور/ ابكر آدم إسماعيل وغيره من كتاب ومفكرين “هامشا”.
وأول ما اشير اليه هنا قبل الدخول عميقا فى عملية نقد هذه الرؤية.
أن كتاب “جدلية المركز والهامش” كتب بلغة أكاديمية صارمة وصعبة تبعث أحيانا على الملل رغم أهميته، ولذلك أكاد أجزم بأن كثير من الذين حملوا هذه الرؤية و”نقذوا” بها، لم يفضوا غلاف ذلك الكتاب وبالكاد قرأوا عنوانه، لذلك كان من المهم إيجاد طريقة “وسطى” تجعل منه كتابا سهل الهضم والتناول، طالما كان واضحا أنه سوف يعبر عن “فئات” و”تجمعات” بسيطة هى المقصودة “بالهامش” أو “المهمشين” ومن ضمن إنعكاسات التهميش السالبة، محدودية فرص التعليم وبالتالى محدودية “الثقافة” العامة، وسوف أتطرق لاحقا، للتوضيح أكثر هل قلة “المتعلمين” بين “الهامشيين” فى الزمن السابق خاصة، يعود لتلك الثقافة “المركزية” وحدها وتعمد عدم إتاحة فرص العلم فى “الهامش” أم هناك اسباب أخرى، تعود لثقافة أهل الهامش أنفسهم؟
من زاوية ثانية أرجو الا يفهم “نقدى” بأنه دفاع عن “المركز” وهجوم على “الهامش” كنوع من ردة الفعل.
على العكس من ذلك وكما ذكرت اعلاه سوف أحاول أن اقدم رؤيتى عن هذا المفهوم بصورة عامة والذى ورد فى الكتاب المعنى بصورة خاصة.
من المهم ذكره هنا ، بحسب إنتمائى العمرى للجيل الثانى أو الثالث الذى نشأ على أرض السودان بعد استقلاله “1 يناير 1956” أستطيع الإدعاء بأنى “موثق” و”مؤرخ” من خلال مشاهدات عينية لبعض الأحداث أو من خلال القراءة والمتابعة والإطلاع.
ذلك الأمر يجعلنى أتساءل عن من هم الذين يستحقون وصف “المهمشين” بصورة محددة؟ هل هى الجهات التى عرفها الكاتب من خلال رؤيته المبنية على المحمول “الثقافى” – الأنثربولجى – وحده ? أى الإنسانى – كما قال دون إهتمام “للثقافة” بمحمولها الآخر “فنون وآداب وموسيقى وطرق حياة وطرق لبس وأكل”؟
والسؤال هنا لماذا إستبعد الكاتب هذا النوع الأخير من الثقافة التى تأثر بها فى شخصه والدليل على ذلك أنه كتب كتابه بلغة عربية صعبه ولم يكتبه بلغة إنجليزية أو محلية؟
الم تؤثر تلك اللغة أعنى “العربية” فى مخزونه “المعرفى” وفى تقديمه لمادة تساهم إثراء الثقافة العامة؟ هل نأخذ بالتبرير الذى ساقه الكاتب بنفسه عن إهماله “للثقافة” بمفهومها الآخر أم لشئ فى نفس يعقوب كما يقال؟ أم هى “رؤية” منحازة من الاساس لا تريد أن “توفر” لمن هم خارج “تعريفه” ? الجغرافى ? للتهميش، حتى لو لم يذكره، حد أدنى من “التعاطف”، ولا أدرى ماذا يضيره فى ذلك وفى أن يتعامل مع القضية من واقع سودانى؟ لا بانيا فرضيته على “نظريات” ومقولات مأخوذة من أبحاث وكتابات “علماء” لا تستهوينى كثيرا نظرياتهم وأفكارهم تلك لأنها نادرا ما تطابق مع واقعنا وسلوكياتنا.
على سبيل المثال “الكرم” – وهو “ثقافة” إنسانية – عرف به الإنسان السودانى فى كآفة جهاته وإثنياته من الصعب أن تكون مفهوما لمن هم مثل أولئك العلماء وما هى جذور ذلك الكرم الذى لم يعرفه حاتم الطائى ومن اين أتى، بل أنه فى فهم شعوب مجاورة لنا يعد نوعا من الغباء والأمية والسذاجة والتخلف، وفى أحسن الأحوال لا يرى أكثر من أنه “طيبة” تعود لنفس تلك الأوصاف أعنى “الطيبة” لدرجة السذاجة!
حدثنى صديق لا اشك فى صدقه أن عم له جاء متآخرا بالليل عبر “دكانه” ولاحظ من بعيد عدد من الرجال وقد كسروا الدكان وبدأوا يسرقونه، لكنه “لمح” واحد منهم يعرفه جيدا أو كأنه صديق له .. “فلبد” عمه حتى يسرقوا ما يريدونه ويذهبوا لكى لا يحرج صاحبه!
فمن يفهم من أهل الأرض كلها مثل هذه الثقافة .. وما أكثر مثل هذه الأمثلة فى المجتمع السودانى؟
من الملاحظات المهمة فى رؤية “الكاتب” أنه رفض الأمثله “الفردية” وكما قال فى إحدى الندوات “يريد أن يعكس رؤيته هو .. وبمنهجه هو .. وبطريقته هو”!
بمعنى لو ظهرت هناك سلوكيات تستحق التوقف عندها من “فرد” منتمى “للمركز” أو “للجلابة” فيجب ألا ناخذ بها، المهم عنده سلوك ذلك “المركز” الجلابى المحدد بالوسط والشمال النيلى “كله” قطعة واحدة فى دولة صنفت بأنها فى مرحلة “ما قبل الراسمالية” أو “قبل البرجوازية” لذلك يجب أن تؤخذ الأمور بكلياتها!.
مع أن أفرادا كثر لم يوجدوا فى السودان وحده كانوا “أمة” وأحدثوا تغيرات فى الكون هائلة لا يمكن تجاهلها لا يستطيع أن يحدثها جيش جرار.
مثلا السيد المسيح ووصاياه التى تخالف تماما التعاليم المادية اليهودية .. ومن بعده “نبى” الإسلام محمد بن عبد الله دون التوقف طويلا فيما احدثه فى الجانب الدينى، بل فقط بالنظرة العميقة للذى حدث من تغيرات تشبه الأعجاز فى المجتمع الذى كان يعيش فيه ثم الذى حدث بعد ذلك.
حيث إستنهض همم “أعراب” وصفوا بأنهم كانوا بدو أجلافا غلاظ طباع يأد الأب طفلته الصغير خشية العار، فتحولوا الى قوة دفع هائلة غزت العالم كله وفرضوا سطوتهم على العديد من البلدان “عنوة” ولم يعقدوا إتفاقية “صلح” مهما كانت مجحفة الا مع أهلنا وأجدادنا الأقدمون رماة “الحدق”.
من قبل ذلك وكما هو مذكور فى التاريخ القديم “الحديث” نوعا ما، أى قبل 3000 سنة شخصية “بيى بعانخى” واسرته الفرعونية رقم 25 و 26 التى لا يريد جيراننا المصريون “الحاليون” الإعتراف بأنها اسر “سودانية” لأنهم بسطوا سلطانهم على جميع الأراضى المصرية ووصلوا حتى فلسطين، اضافة الى التمدد الأفريقى شرقا وغربا، ولذلك واصل “الأوربيون” كما قال الكاتب توصيف “السودان” كبحر متوسطى!
أمثلة كثيرة لأفراد كانوا “أمة” فى العصور القديمة والحديثة، ليس بالضرورة أن يكون التقويم لأعمالهم كلها إيجابى أكتفى بالتوقف عند على عبد اللطيف، ومحمود محمد طه وعبد الخالق محجوب وجون قرنق وغيرهم.
هنا اكرر رؤيتى التى ذكرتها من قبل فى أكثر من ندوة وتضمنها كتابى “خطر الأسلام السياسى على المواطنة والديمقراطية ? مصر نموذجا”، والتى قلت فيها لست مع محاكمة التاريخ لكنى ضد عودة التاريخ ليحكم الحاضر”.
فالتاريخ له ظروفه التى قد لا نحيط بتفاصيلها، لكن هذا لا يعنى بالطبع الا ننقد ذلك التاريخ والا نسترجع الذى حدث فيه حتى نأخذ بالإيجابى ولا نكرر السلبى.
الشاهد فى ألأمر كان رفض الكاتب للتوقف عند السلوكيات “الفردية” موقفا ? ذكيا – منه خدم رؤيته التى تنظر “للمركز” كله “ككل”.
مما يصعب على الناقد أو المخالف لرؤيته أن يذكر أمثلة “لتهميش” حقيقى لا يبتعد كثيرا عن عاصمة “الجلابة” فى العصر الحديث “الخرطوم” لا مكانا آخر غيرها ابعد .
هذه الأمثلة كنت شاهدا عيان لها لم تحك لى.
سافرت مرتين بالسكك الحديدية عبر الطريق المتجه شمالا، المرة الأولى لزيارة ارض الجدود “دنقلا” مع الأهل خلال منتصف الستينات وقد كنت صبيا وقتها، كانت المسافة من الخرطوم وحتى كريمة بالقطار ثم منها وحتى دنقلا بالباخرة إستغرقت تلك الرحلة حوالى أربعة ايام وكانت الرحلة من عاصمة “دنقلا” ? العرضى – لأرض الجدود فى منطقة مجاورة تقطع على ظهر “الحمير”.
فى ذلك الوقت “دنقلا” كلها ما كانت فيها مدرسة ثانوية واحدة “للبنين” دعك من “البنات” وكان الطلاب الناجحون من المرحلة “الوسطى” يذهبون لمواصلة تعليمهم فى “كريمة” أو “عطبرة”.
اليس هذه درجة من “التهميش” حتى لو لم تقارن بحجم “التهميش” فى المناطق التى حددها الكاتب؟
فى المرة الثانية منتصف السبعينات سافرت بذات الطريق حتى “حلفا” القديمة ومنها الى “مصر” بالباخرة كذلك.
فى المرتين الأولى والثانيه وبعد مغادرة “محطة” الخرطوم بحرى بمحطتين أو ثلاثة محطات، شاهدت بنفسى أطفالا يركضون بمحازاة القطار، ملابسهم متسخة وممزقة ولا تختلف عن لون بشرتهم “الترابى” كثيرا، وهم يصيحون “رغيف .. رغيف” و”جريدة .. جريدة”، اليس هذا قدر من “التهميش” حتى لو لم يصل درجة المهمشين الذين كتب عنهم الكاتب؟
أواصل … فى الجزء الثانى الكتابة عن قصر تقسيم المراحل للسودان الحديث ولماذا أهمل الكاتب “المحمول” الدينى كعامل مهم ومؤثر فى قضية “التهميش” رغم تطرقه له فى أكثر من موقف ثم تجنى الكاتب على “ثقافة” أم درمان.
تاج السر حسين ? [email][email protected][/email]



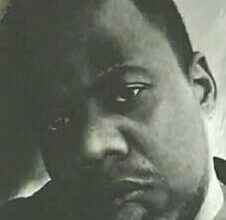
لاول مره اتفق معك……
تاج السر حسين كعادته يكتب عن المسكوت عنه في السودان ويصيب الكثير من المتحجرين والمتقوفعين في خندق الفكرة الواحدة بالهوس الفكري ويصيبهم بكثير من الصدمات من ما يجعله في مرمى النيران من الجميع.
شكرا تاج السر حسين
ممكن ان نؤمن بساحة فكرية واحدة تتنوع وتختلف بداخلها الرؤى، لتأسيس قاعدة فكرية لتطور البلاد باسرها وموحدة.
فهل نظرية الهامش والمركز تطرح في هذا الاتجاه ام ان انها تمهد وتبرر لانفصال؟
بمعنى هل تأسيسها على التحليل الثقافي، بل هل نهج التحليل الثقافي نفسه يفهم الاستعلاء الثقافي والعرقي كغريزة وداء لا شفاء منه الا الانفصال.؟
من الصعب تصور جهد فكري نظري ينتهي بالانغلاق على نفسه. لكنه سؤال.
لاول مره اتفق معك……
تاج السر حسين كعادته يكتب عن المسكوت عنه في السودان ويصيب الكثير من المتحجرين والمتقوفعين في خندق الفكرة الواحدة بالهوس الفكري ويصيبهم بكثير من الصدمات من ما يجعله في مرمى النيران من الجميع.
شكرا تاج السر حسين
ممكن ان نؤمن بساحة فكرية واحدة تتنوع وتختلف بداخلها الرؤى، لتأسيس قاعدة فكرية لتطور البلاد باسرها وموحدة.
فهل نظرية الهامش والمركز تطرح في هذا الاتجاه ام ان انها تمهد وتبرر لانفصال؟
بمعنى هل تأسيسها على التحليل الثقافي، بل هل نهج التحليل الثقافي نفسه يفهم الاستعلاء الثقافي والعرقي كغريزة وداء لا شفاء منه الا الانفصال.؟
من الصعب تصور جهد فكري نظري ينتهي بالانغلاق على نفسه. لكنه سؤال.