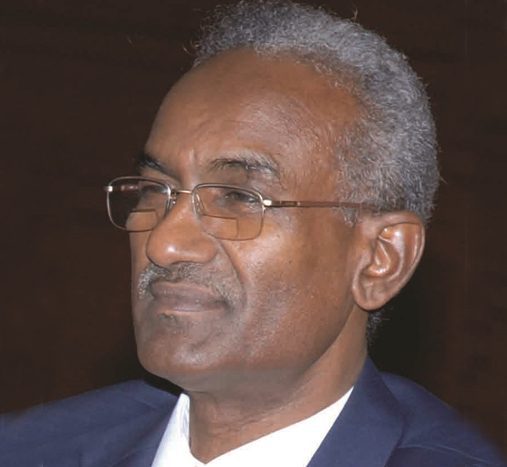
(لا مستقبل للسودان دون المحافظة على البيئة واستدامة التنمية)
(يجب التركيز على الإنسان أولاً، لا الموارد ولا المكان، فهو وسيلة التنمية وغايتها)
*(8) إدارة الصرف الصحي والصناعي*
تناول المقال السابق قضية إدارة النفايات وننتقل في هذا المقال لتوأم النفايات الصلبة وهي النفايات السائلة سواء كانت من المنازل والمباني العامة أو من الصناعة أو من الأمطار والفيضانات، وكلها تحتاج لإدارة الصرف الصحي حتى لا تلوث البيئة وتهدد الصحة العامة.
في البدء نذكّر أنفسنا بالمبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة:
الأول: أن التنمية في أي بلد مُعتمد على الموارد الطبيعية مثل السودان تبدأ من *الريف*.
والثاني: أن عماد التنمية *الإنسان الصحيح العقل والنفس والبدن* و*المُسلّح بالمعرفة والثقافة*.
والثالث: أن أساس الصحة *الوقاية* وأساس الوقاية *الصحة العامة* وأساس الصحة العامة *صحة البيئة وجودة الهواء والماء والغذاء*. وهذهتأتي في الأهمية قبل الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية.
وأهم أساسيات الصحة العامة *مكافحة التلوث*، وبما أن *النفايات الصلبة والسائلة* من أهم مصادر التلوث في القرى والمدن، فإن *إدارة النفايات والصرف الصحي* هي أولى أولويات خدمات الصحة.
وتعتبر إدارة الصرف الصحي والصناعيةمن ضرورات الصحة العامة للوقاية من الأمراض ذات الصلة بالنفايات السائلة خاصة الإسهالاتوالديدان المعوية والبلهارسيا وغيرها. بل هي ضرورية للوقاية من الأوبئة البكتيرية والفيروسية التي يمكن أن تنتشر في وقت وجيز.
وكما هو الحال بالنسبة للنفايات الصلبة، فإن النفايات السائلة تنتج عن كل نشاطات الإنسان المنزلية والصناعية وبكميات كبيرة جداً يومياً.في الخرطوم مثلاً تقدر مياه الصرف الصحي ب 200 لتر في اليوم للفرد. وبالمثل فإن أي مدينة أو قرية دون إدارة صرف صحي هي مثل الإنسان المصاب بالفشل الكلوي، تتراكم السموم في جسده فتجعله مريضاً غير قادر على أداء واجباته اليومية وإذا لم يخضع للغسيل أو يعالج نهائياً فالموت هو المصير.
تشمل مياه الصرف Waste water المياه الصادرة عن التجمعات السكنية والمؤسسات الصناعية والتجاريةوالمشاريع الزراعية وبينما مياه الصرف السطحي تنتج عن الأمطار والسيول والفيضانات. وحسب ما ورد في دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصادر عن مؤسسة زايد الدولية للبيئة (2018)، فهي عبارة عن %99 أو أكثر ماء والباقي مواد ذائبة ومواد عالقة. وهذه الشوائب التي تشكل 1% تحتوي على ملوثات بالنسب التقريبية الآتية والتي تختلف من مكان لآخر:
70% مواد عضوية: (45% بروتين)(18% نشاء) (7% دهون وشحوم).
30% مواد غير عضوية: أملاح ورماد
ويمكن تقسيم مياه الصرف الى ثلاثة أقسام:
1- المياه السوداء Blackwater.
وهي خليط من النفايات الآدمية الصلبة والسائلة مع مياه تنظيف المراحيض ومواد التنظيف الجافة. وهذه تحتوي على مسببات الأمراض المعوية.
2- المياه الرمادية Greywater
وتشمل كل مياه الصرف الأخرى التي لا تحتوي على مياه المراحيض. وتأتي من أحواض الاستحمام وغسيل الملابس وغسيل الأطباق والخضار والفواكه. كما أنها بشكل عام تحتوي على مسببات الأمراض بدرجة أقل كثيراً وتكون أكثر أمانا في التعاملو أسهل في المعالجة. لذلك يمكنإعادة استخدامها في الموقع لغسيل المراحيض وري الحدائقوالمحاصيل وغسيل السيارات وغيرها من الاستخدامات التي لا تتطلب استخدام مياه صالحة للشرب.
3- مياه الأمطار والسيول والفيضانات Rain, Torrents and Floods
وهذه أقل تلوثاً من سابقاتها وأكثر جاهزية لإعادة الإستخدام لأغراض الري والغسيل، الا إذا اختلطت بمياه ملوثة مثلما ما حدث في بعض مناطق السودان حيث اختلطت مياه الأمطار والفيضانات بمياه المراحيض التي امتلأت وفاضت.
مياه الصرف عموماً يجب معالجتهاوإعادة استخدامها أو تدويرها لمنع تلوث المياه السطحية والجوفية والتربة وقايةً من الأمراض ومن الإضرار بالبيئة. وأما مياه الأمطار والسيول فيجب ان يكون لها مصارف إلى الأنهار والبحار أو الى الزراعة أو إلى الحفائر والسدود التي تدّخرها الى فصل الجفاف، والا ستتجمّع المياه الراكدة في الشوارع والساحات مما يؤدي الى تدمير البنية التحتية وعرقلة حركة الناس والمركبات وتوالد الآفات الضارة مثل البعوض والذباب.
ومعالجة مياه الصرف الصحي هي عملية تنقية مياه الصرف من الشوائب والمواد العالقة والمواد الكيميائية لتصبح صالحة لإعادة الاستخدام أو لتكون صالحة للتخلص منها في المجاري المائية دون أن تسبب تلوثاً. وتشتمل عملية معالجة الصرف على عدة مراحل فيزيائية وكيماوية وبيولوجية. وإذا جرى التخلص من مياه المجاري بدون معالجة في البحر أو النهرتكون العواقب وخيمة كالآتي:
تنتشر الميكروبات وتنتقل للإنسان عن طريق الاستحمام أو الشرب الأكل.
تدخل الماء كميات كبيرة من المغذيات للطحالب مما يؤدي لتكاثرها بصورة غير عادية (الإنفجار الطحلبي Eutrophication) فتصبح طبقات وتموت الطبقات السفلى لغياب ضوء الشمسفتقوم البكتريا بتحليل المواد العضوية مستنفدة الأوكسجين الذائب في الماءمما يؤدي إلى موت الأحياء المائية كالسمك والقشريات.
وتنشط الميكروبات اللاهوائية نتيجة استنفاد الأكسجين الذائب وتقوم بتخمير المواد العضوية مسببة روائح كريهة وعفونة للمياه.
وللأسف الشديد لم يجد الصرف الصحي والصناعي أي إهتمام من حكوماتنا المتعاقبة منذ الإستقلال، بل إن الإستعمار قد أنشأ محطة تنقية المجاري الوحيدة في الخرطوم جنوب (القوز) ولم يتم تطويرها لأن المحطة في موقع أعلى من مناطق الخرطوم التي تم توصيلها بالشبكة مما يستدعي ضخ مياه الصرف بتكلفة عالية لتصل المحطةوقد أغلقت تماماً. هناك محطة للتنقية البيولوجية في سوبا لا تستوعب أكثر من 40 الف لتر، بينما مياه الصرف في الخرطوم تفوق المليون و700 ألف متر مكعب في اليوم. إذن 97% منها تتسرّب إلى المياه الجوفية أو تطفح في مكان ما. وهناك مشروع الآن لرفع طاقة محطة سوبا الى 60 الف وربما تصل 90 الف متر مكعب، ولكن ذلك لا يساوي شيء بالنسبة لحجم الصرف (5% فقط).
وأغلب مياه المجاري المُعالجة جزئياً في برك التثبيت الآن، ومنذ تسعينات القرن الماضي، تجد طريقها الى النيل الأبيض مخلوطة بمياه بعض الصناعات المُلوِّثة مثل المدابغ. أما في الخرطوم بحري فهناك محطة للصرف الصحي ولكنها أيضا لم تجد التطوير وتدخلها مياه الصناعة التي ربما تحتوي على معادن ثقيلة مما أضطر السلطة المحلية لحفر أحواض كبيرة في منطقة حطّاب لإستيعاب الفائض وتبخيره بواسطة الشمس. وهذا يلوث الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية. بل هناك جهات كثيرة في ولاية الخرطوم تصب مجاريها مباشرة ودون أي معالجة في النيل الأزرق أو النيل. ومن أراد أن يعرف مصير الأنهار التي تصب فيها المجاري فليقرأ عن مدينة تشيناي الهندية (مِدراس سابقاً) التي تمر بها 5 أنهار وبها أكبر أزمة مياه شرب في الهند لأن أنهارها ملوثة بمياه الصرف الصحي والصناعي ولم تكن هناك إرادة سياسية لحل المشكلة المُزمنة عبر الزمن.
بقية أنحاء السودان وأطراف العاصمة في مجملها ما زالت تعتمد على نظام المراحيض البلدية ونسبة ضئيلة بنظام السيفونات، وكلاهما يستخدم آبار يتم حفرها الى مستوى المياه السطحية. وبالرغم من أن مياه الشرب تكون من آبار ارتوازية (مياه جوفية عميقة) إلا أنها معرضة لتسرب المياه الملوثة من المستوى الأعلى عن طريق المواسير المتآكلة أو الحفر الخاطئ. وهنا الخطورة أكبر عندما أنه لا تتم تنقية لمياه الشرب وانما يتم ضخها للسكان كما هي من المصدر.
وقد يعتقد أغلب الناس أن حوض التحليل (السابتك تانك) ينقي مياه الصرف ولكنه فقط يقوم بترسيب أولي والمياه التي تخرج منه ملوثة وخطيرة. وأغلب القياسات التي تمت للمياه الجوفية في العاصمة وجدت أنها مياه مجاري وقد بلغت قياسات الطلب على الأوكسجين البيولوجي (BOD) (يعني بالبلدي درجة العُفونة) أرقاماً قياسية (400 – 500) بينما 70 – 140 فقط تعتبر مُلوّثة.
وقد اقتربت المياه الجوفية من سطح الأرض نتيجة الصرف المحلي مسببةً ظاهرة “النز” التي دمرت المنازل والمنشآت في مناطق متفرقة كما هو الحال في بيت المال والملازمين وابوروف وودنوباويومدينة المهندسينبأمدرمان. وهناك حالة موثقة في المهندسين (4/4/30) لظهور الماء عندما كانوا يحفرون لبناء قواعد المنزل. كما أن هناك حالات لإنهيار منازل واضطر أهلها للبحث عن مأوى آخر. وليس هناك حل سوى بناء شبكات صرف حديثة، والا فإن كل هذه المناطق وغيرها مُهدّدة بانهيار المنازل وتشريد السكان.
والمؤسف أكثر أن أغلب مناطق السودان ما زالت تعتمد على المراحيض البلدية للتخلص من نفايات الإنسان السائلة والصلبة، وفي هذا عبء صحي ثقيل على كاهل المجتمع وتخلف شديد عن ركب الحضارة الإنسانية، بينما هو معروفاً منذ القدم أن الوقاية خيرٌ وأرخص كثيراً من العلاج.
لقد آن الأوان لبناء محطات تنقية لمياه الصرف الصحي والصناعي بمواصفات علمية عالمية والإستفادة من المياه وكل المخلفات في أوجه التنمية المختلفة. وذلك يتطلب إنشاء شبكات للصرف تحت الأرض لنقل مياه الصرف المختلفة إلى محطات المعالجة أو نقل مياه الأمطار إلى نقاط الصرف.ومن الأفضل أن تكون شبكة صرف الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي ولا تدخل محطات التنقية رغم أن تكلفتها أعلى. والشبكة المشتركة التي تحمل مياه الصرف الصحي والأمطار عادةً تفيض في الخريف عن سعة المواعين مما يستدعي إنشاء خزانات خاصة لاستيعاب هذه المياه الفائضة وإعادة معالجتها لاحقا.
وحاليا في أغلب مناطق العالم يتم فصل واعادة استعمال المياه الرمادية (مياه الاستحماموالغسيل) حيث يتم معالجتها معالجة بسيطة ويعاد استعمالها مباشرة في شطف المراحيض وفي التبريد ونظافة الشوارع وتربية الأسماك والتشجير.
كما أن استعمال نواتج معالجة مياه الصرف (كاستعمال الحمأة في اعمال التسميد وغاز الميثان في توليد الطاقة) هي نواتج ثانوية لمعالجة مياه الصرف يمكن ان تغطي جزء كبير من قيمة المعالجة.
وفي هذا الصدد اعدّت منظمة الصحة العالمية “دليل الاستخدامالآمنوالتخلصمنمياه الصرف، المياهالرماديةوالفضلات البشرية”، والذي يمكن إنزاله من الرابط
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/171753/9789246549245-ara.pdf?ua=1
كما ان مؤسسة زايد الدولية للبيئة قد أصدرت “دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف” للمهندس محمد معن برادعي، وهو الكتاب رقم 22 ضمن سلسلة كتاب عالم البيئة التي أقوم بتحريرها. وتوزع كتب السلسلة مجاناً لمن يرغب.
ولمعرفة التكلفة التقريبية لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي فإن المتر المكعب (الف لتر)يكلف 1000 – 1500 دولار حسب سعة المحطة. فإذا كانت الخرطوم تنتج 1,700,000 متر مكعب في اليوم فإن محطة التنقية التي تناسبها تكلف 17 مليون دولار فقط. وربما تكون التكلفة الأكبر هي تكلفة الشبكة التي تنقل مياه الصرف الى المحطة.
الأمر خطير جداً إذ أن لدينا الآن كل الظروف والبيئة المناسبة لإنتشار الأوبئة الضاربة، ومن المفارقات العجيبة أننا نتحدث كثيراً عن المستشفيات وتأهيلها وتوفير الأدوية المكلفة جداً وأجهزة التشخيص الغالية، ولا نعطي الوقاية المتمثلة في الصحة العامة حقها وأساسها صحة البيئة وصحة الهواء ومياه الشرب وسلامة الأغذية. إن الإستثمار في الوقاية سيوفر ما لا يقل عن 60% من فاتورة الصحة للأسرة وللدولة.
الشكر أجزله لخبراء الصرف الصحي الدكتور الفاضل أزرق والدكتور أحمد محمد طاهر لما أمداني به من معلومات قيّمة وأحييهما على جهودهما الكبيرة في محاولة إصلاح الوضع المتدهور.
نسأل الله الصحة والعافية للجميع وان ننهض ببلدنا الى مصاف الدول المتقدمة.
د. عيسى محمد عبد اللطيف
مستشار العناية بالبيئة واستدامة التنمية

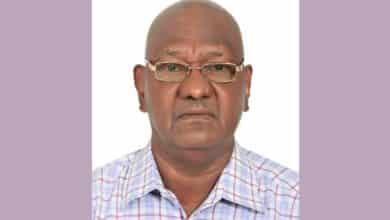



يا ريت يا دكتور نقدم حلول بدل تشخيص للمشكلة، و يا ريت تاخد المبادرة و تدعو المهندسين و الخبراء ال ساهموا في المقال ده لتصميم و دراسة جدوى و دراسة تشغيلية لمحطات صرف للمدن الكبيرة
بارك الله فيك يا شاهيناز وأشكرك على التعليق . في الواقع الأمر أكبر من أن يقوم أفراد بطرح دراسة .. ويحتاج أولاً للإرادة السياسية ومعرفة واعتراف الجهات المسؤولة بالمشكلة، ومن ثم تكليف فريق من المتخصصين لإجراء الدراسات وتقسيم العمل الى مراحل. كما أن ذلك أيضاً متوقف على تشكيل الحكومات الولائية والمحلية لأن الدراسة لا تتم في المكتب بل تحتاج لإمكانيات بشرية ومالية لعمل ميداني كبير قبل المكتبي. مع تحاتي لك ولكل المهتمين.