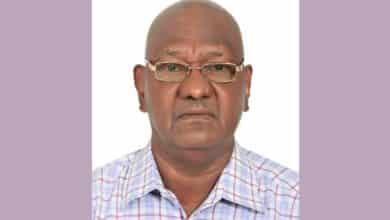رؤية تحليلية للنظام الجنسي المؤسس على الهيمنة الذكورية

مع دخول مصطلح الهيمنة الذكورية حقل التداول في مجال الدراسات السيوسيولوجية والاجتماعية والثقافية ظهرت أبحاث ودراسات عديدة حاولت إغناء وتطوير هذا المفهوم وتوسيع مجاله الدلالي. كتاب عالم الاجتماع الفرنسي الراحل بيار بورديو ?الهيمنة الذكورية?، الصادر عن منشورات المنظمة العربية للترجمة- بيروت، الذي قام بترجمته سلمان قعقراني، يعتبر مساهمة فكرية هامة في هذا المجال، يستخدم فيها هذا العالم المنهج السوسيولوجي عبر بحث منهجي متماسك يتجاوز فيه المألوف في الخطاب الثقافي السائد، لقراءة وتحليل سيرورات التغيير أو الاستمرار في النظام الجنسي المؤسس على الهيمنة الذكورية عالميا.
العرب
مفيد نجم
إن النتيجة الأولى التي يخلص إليها بيار بورديو في مناقشته هي ثبات الجنسية واستقلاليتها عن البنى الاقتصادية وأنماط بنى الإنتاج التي تقول بها النظرية المادية، وللتدليل على ذلك يتخذ من مجتمع القبائل في الجزائر أنموذجا لمجتمع المركزية الذكورية بغية الوصول إلى الكشف عن بعض السمات الأكثر تسترا داخل المجتمعات المعاصرة التي ما زالت تقوم على الهيمنة الذكورية عبر التمييز بين ما هو مذكر وما هو مؤنث، انطلاقا من الاختلاف التشريحي بين الجنسين، والذي قام عليه التقسيم الجنسي للعمل.
ومن أجل فهم هذا الوضع السائد يبحث بورديو عن الآليات التاريخية التي كرست هذا التأبيد النسبي لبنى التقسيم الجنسي والهيمنة الذكورية التي يرى أن استمرارها يعود إلى ما يسميه بالعنف الرمزي الممارس عبر الطرق الرمزية الصرفة للاتصال والمعرفة.
الطبيعي والتاريخي
بداية يكشف بورديو عن الدافع من وراء تأليف هذا الكتاب والمتمثل في رؤية الطريقة التي تتحقق فيها الهيمنة الذكورية والخضوع المفارق لها بصفتها نتيجة لما يسميه بالعنف الرمزي الذي يصفه بأنه ناعم ولامرئي ولامحسوس، وصولا إلى تفكيك السيرورات المسؤولة عن تحول التاريخ إلى طبيعة وجعل الاعتباطية الثقافية طبيعة، ما يتطلب منه تبني وجهة النظر الأنثربولوجية القادرة على إرجاع مبدأ الاختلاف بين المذكر والمؤنث إلى خاصيته الاعتباطية والطارئة التي جعلت من الاجتماعي بيولوجيا لخلق بناء اجتماعي مطبّع عبر تنشئة اجتماعية مديدة للبيولوجي.
انطلاقا من هذا الإدراك لضرورة التخلص من أنماط التفكير التي جرى استدماجها في أشكال من الإدراك والتقدير هي نتاج للهيمنة الذكورية يسعى إلى تقديم تجربة مختبر تقوم على مقاربة التحليل للبنى الموضوعة وللأشكال المعرفية لمجتمع تاريخي مخصوص كما هو الحال في مجتمع البربر الجزائري باعتبار ذلك هو أداة عمل لتحليل سوسيولوجي للاوعي التمركز الذكوري القادر على موضعة فئات هذا اللاوعي.
تقوم نظرية الباحث على أساس أن تقسيم النشاطات الجنسية والأشياء من خلال التعارض بين المذكر والمؤنث تنبع ضرورته الموضوعية والذاتية من خلال إدراجه في نسق تعارضات متجانسة ( أعلى- أدنى/ فوق- تحت/ جاف- رطب/ صلب- رخو?) والذي يتوافق مع حركات الجسد، إذ أن هذه التناقضات المتشابهة في الاختلاف هي متطابقة بشكل كاف لكي تدعم بعضها البعض في لعبة لا تفنى من التحولات العملية والاستعارية، وفي الآن ذاته هي متباعدة بما فيه الكفاية لكي تسبغ على كل واحدة من تلك الاختلافات نوعا من التماسك الدلالي النابع من التحديد المفرط بالتناغمات وبالتوافقات.
وهكذا فإن قوة النظام الذكوري تظهر وكأنها أمر لا يحتاج إلى تبرير ذلك لأن الرؤية المركزية لهذا النظام تبدو وكأنها لا تتطلب الإعلان عن نفسها لأجل شرعنتها، فالنظام الاجتماعي يعمل بوصفه آلة رمزية هائلة تعمل على المصادقة على تلك الهيمنة التي يقوم عليها هذا النظام.
ضحايا معا
يطالب الباحث بضرورة فهم وإدراك البناء الاجتماعي للبنى المعرفية التي تنظم أفعال بناء الحياة وسلطاتها مؤكدا في الآن ذاته على أن استيعاب هذا البناء العملي يتجاوز الفعل الذهني الواعي والحر للذات المعزولة لأنه هو نفسه ناتج سلطة متأصلة على الدوام في جسم المرأة المهيمن عليها على شكل ترسيمات إدراك واستعدادات للإعجاب والاحترام والتبجيل والحب تجعل عددا من التظاهرات الرمزية للسلطة ذات حساسية، ثم يضيف بأن الثقل الحاسم لاقتصاد المتاع الرمزي الذي يقوم من خلال مبدأ التقسيم الجوهري بتنظيم كل إدراك للعالم الاجتماعي هو الذي يفرض نفسه على الفضاء الاجتماعي كله، لا سيما على اقتصاد وإعادة الإنتاج البيولوجي (الولادة).
استمرار الهيمنة يعود إلى العنف الرمزي
وإذا كانت المرأة التي تخضع لتنشئة اجتماعية تنحو إلى تصغيرها وإنكارها فتتمرس على الفضائل السلبية كالتفاني والخنوع والصمت، فإن الرجال هم ضحايا أيضا لأنهم ضحايا التمثل المهيمن عبر عمل التطبيع الاجتماعي الطويل الذي يِفرِض عليهم ممارسة الهيمنة ومظاهر القوة لأن الامتياز الذكوري هو فخ يجد نقيضه في التوتر وتركيز الانتباه على تأكيد الرجولة في كل الظروف وجعلها معيارا للذات.
لكن الهيمنة الذكورية التي تشكل من المرأة موضوعا رمزيا تجعل منها ككائن مدرك في حال دائمة من عدم الأمان الجسدي لأنها موجودة بواسطة ومن أجل نظرة الآخرين ما يجعل تلك التبعية مكونا لكيانها.على خلاف الرجل الذي يعيش الوهم الأصلي المكون للذكورة والذي يجعله بالتعارض مع المرأة هو المؤسس والمعلم اجتماعيا.
يشير الباحث إلى أن البحث التاريخي لا يمكنه أن يكتفي بتوصيف التحولات التي طرأت على شرط المرأة عبر الزمن أو للعلاقة بين الرجل والمرأة بل يتوجب إدراك حال النسق السائد لكل عصر كالعائلة والدولة والمؤسسة الدينية والمدرسة التي ساهمت كلها بوسائل مختلفة في انتزاع علاقات الهيمنة الذكورية من التاريخ انتزاعا كاملا تقريبا، لأن التاريخ الذي تحدده الثوابت العابرة للتاريخ على مستوى العلاقة بين الجنسين والتي يجري إنتاجها وإعادة الإنتاج لها تخضعهما للتمايز الذي لا يتوقف عبر التمسك بالتوصيف وإعادة البناء الاجتماعي للرؤية المولدة لمختلف الممارسات الجنسية والاجتماعية.
لكن الهيمنة الذكورية واجهت بفعل النقد الهائل من قبل الحركة النسوية ضرورة تبريرها والدفاع عنها أو التبرؤ منها بسبب التحولات التي شهدها وضع المرأة لا سيما على صعيد المدرسة ووظيفتها التي كانت تقتضي إعادة إنتاج الاختلاف بين الجنسين. كذلك فإن تواجد المرأة في المواقع المهيمن عليها من قبل السلطة مثل حقول النشر والصحافة ووسائل الإعلام والتعليم قد دفع بها إلى إرضاء المتطلبات الإضافية التي تفرض عليها لدفع كل تضمين جنسي للجسد.